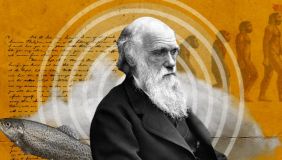هذا الموضوع ضمن هاجس شهر نوفمبر «من نراقب؟ من يراقبنا؟». اقرأ موضوعات أخرى ضمن الهاجس من هنا، وشارك في الكتابة من هنا.
«أنا لا أخاف الموت، ولكن أخاف أن أُقتل». «هاري كول/جين هاكمان» في فيلم «The Conversation».
يبدو الخوف سببًا وجيهًا لإخضاع المرء لحالة من الرقابة الدائمة. يرى الفيلسوف «ميشيل فوكو» أن الطب الغربي وضّح للإنسان ما عليه أن يتناوله من طعام ومكملات غذائية، بل وما قد يحتاج إلى اقتلاعه من جسده من أعضاء خُلق بها. أنت على رادار دائم يُحصي ضربات قلبك وأنفاسك، ويبدو طبيبك كأنه مخبر مُعيّن عليك من الحكومة الراغبة في إبقاء الجميع أصحاء مبتسمين بإيجابية.
«الرجل اللي كان واقف مستني عند الحمام ليه طالعلي في people you may know؟». شخصٌ ما عبر حسابه على فيسبوك.
تبدو الحياة الحرة مفهومًا بديهيًّا عند طرحه موضوعًا للنقاش بين مجموعة أصدقاء حول فناجين القهوة، وبل قد تكون إجابته هي «في أوروبا حتمًا»، أو ربما يضيف أحدنا حكاية ما عن تجربته في أستراليا أو الولايات المتحدة.
يبدو الطبيب كمحقق عند فوكو، وتبدو المصحات النفسية كالسجون التي يعذَّب فيها شخص لا يوجد أي إثبات قاطع بجنونه، إلا ما جُمِع من خبرات في تاريخ الحضارة الغربية للحكم على شخص ما بفقدان العقل.
أذكر برنامجًا شاهدته على قناة «دويتش فيله»، يتحدث عن ضخ الثلج عبر رشاش أو دش طبي على أجساد من يعانون من التهابات المفاصل، وكذلك من يمارسون رياضات عنيفة. الفكرة هي دخول الرياضي أو المصاب إلى غرفة يتعرض فيها لدفقات ثلجية، ثبت بالتجربة أنها تخفف آلامه. ألم يخبرونا لسنين طويلة أن من يعاني من التهاب عضلي أو مفصلي عليه بالماء الدافئ؟
لا يبدو هاري كول من فيلم «The Conversation» فخورًا بمدى احترافيته في التجسس، فهو أيضًا يبدو خاضعًا للمراقبة دائمًا، يخاف عين الإله المسلطة عليه ويخشى العقاب.
يفند «فرانسيس فورد كوبولا» في فيلم «The Conversation» فرضية حرية الحياة الخاصة في المجتمع الأمريكي، [ctt tweet="في فيلم «المحادثة»، يتجسس هاري كول على المواطنين نظير أجر، يتجسس أحيانًا لحساب شركات أو لأشخاص يشكون في سلوك زوجاتهم" username="manshoor"]فـ«هاري كول» (جين هاكمان) يعمل كمخبر خاص، يتنصت على المواطنين نظير أجر، يتجسس أحيانًا لحساب شركات أو أشخاص يشكون في سلوك زوجاتهم.[/ctt]
تستقبلك الفكرة في وهنها وادعائها منذ المشهد الأول للفيلم، الذي ترى فيه المدينة من لقطة عليا. يعرض كوبولا عددًا كبيرًا من البشر يمشون في الشارع، بعضهم يتحدث أو في طريقه إلى عمله، وبعضهم يشاهد فنانًا حركيًّا صامتًا. تقترب الكاميرا من المارين في الشارع لتكتشف أن هناك عملية تنصت تجري بإشراف كول وعدد من مساعديه، أحدهم ضابط شرطة يُفترض أن يكون حاميًا لحقوق المواطنين.
يبدو هاري كول كنجم روك عندما يحضر مؤتمرًا لشركات التنصت، يظهر فيه عارضو التكنولوجيا الحديثة في عالم التجسس على الأفراد والمنازل والشركات كعلماء يتشاركون اكتشافاتهم، ويحاول الجميع التقرب منه ومعرفة كيف يؤدي عمله بهذه الاحترافية.
لا يبدو هاري فخورًا بهذا، فهو أيضًا يبدو خاضعًا للمراقبة دائمًا، فنراه في مشهد الكنيسة يجلس في غرفة الاعتراف ويخبر القس بما اقترفه من آثام طيلة الأسبوع، وعلى وجهه تعبير من يعترف لقاضي تحقيق، ولا يبدو كمتدين حقيقي أكثر من كونه شخصًا يخاف عين الإله المسلطة عليه ويخشى العقاب.
الفيلم يخبرك منذ البداية أن المُراقَب، المنتهكة حريته وخصوصيته، من الممكن أن يكون أي شخص، وليس بالضرورة الرجل والسيدة بطلي المحادثة. هاري كول يتورط شخصيًّا في قضيتهما، يتعاطف معهما، يحاول إنقاذهما من موت محتوم، وهو هنا كالدولة التي تقرر لك ما عليك أن تفعله وما عليك أن تتفاداه، لمصلحتك.
المُراقِب على الشاشة: الشعور بالخطر

يتشابه نقد فكرة الحرية والخصوصية في السينما الأمريكية، واعتبارها فكرة واهية، في إدمانهم تدمير حضارتهم في أفلامهم التي تطرح تصورًا عن هجوم محتمَل على الكرة الأرضية من فضائيين، أو حدوث كارثة طبيعية فنرى جميع معالم دولتهم تنهار، وكذلك الأمر في أفلامهم التي تتناول فعل المراقبة أو دور الشرطة في تعقب المجرمين، فالعملية دائمًا مليئة بالانتهاكات، رغم أن حرية الفرد في الولايات المتحدة لا تقارَن بمثيلتها من ديكتاتوريات العالم الثالث.
المُراقِب في السينما الأمريكية مُدَان باسم الحرية حتى إن كان فعله قانونيًّا، فهو يبدو كهاجس تحرري في مجتمع يُعتَبر الرحم الذي خرجت منه النيوليبرالية، التي وإن تطورت أوجهها السياسية والاقتصادية، لم تفرز حقيقة أخلاقية تحترم حقوق الإنسان.
اقرأ أيضًا: كيف تروِّج المخابرات الأمريكية للحرب في أفلام هوليوود؟
التماهي مع المُراقَب

تعاطف هاري كول في فيلم «The Conversation» مع الرجل والمرأة اللذين سجل محادثتهما، شعر أن حياتهما ستصبح في خطر إذا كشف سرهما، ثم ما لبث أن تبنى قضيتهما وحاول إنقاذهما.
يُشبه ما طرحه المخرج «مايكل مان» في فيلم «Heat» (اللهيب)، بطولة «روبرت دي نيرو» و«آل باتشينو»، إذ نرى ضابطًا يتوحد مع طريده المجرم «نيل ماكولي»، ويبدو كأنه تعاطف مع عمله ويتمنى له الفرار أو الموت، لعله يستريح من الهروب الدائم.
«لقد جلسنا كصديقين، ولن يروق لي اعتقالك، لكن إن كانت حياتك هي ثمن الرصاصة التي عليّ أن أمنعك من إطلاقها لأنها قد تصيب مسكينًا ستترمل زوجته بسببك، فلتعلم يا أخي أنني لن أتردد في قتلك».
يبدو منطق الهروب الدائم كالتزام في حياة ماكولي التي ترفض الاستقرار، وتبدو نموذجًا ثوريًّا أكثر منه إجراميًّا، الهروب الذي لا يؤخره لثلاثين ثانية أي ارتباط أو تعلُّق. ماكولي ينتزع حقه ولا يتورع عن الكذب أو القتل، والآخرون هم مَن يحتقرهم من المستسلمين لبطء الحياة الآمنة، وعندما يسأله هانا عما إذا كان على استعداد حقًّا لترك حبيبته والهرب في أقل من 30 ثانية، يقول له: «نعم، وهذا هو الانضباط اللازم».
لكن فنسنت لا يزال راغبًا في الوعظ، وهو يحصي له عدد السنين التي يعلم أنه أمضاها في سجون شديدة الحراسة، ويحذره من أنه قد يعود إليها، فيسخر منه ماكولي.
يسأله فنسنت: ألم ترغب يومًا في حياة عادية هادئة؟
فيسأله ماكولي: وما هي؟ متابعة مباريات الكرة وإقامة حفلات الشواء في باحة المنزل؟
فيرد الضابط: نعم.
المراقبة كسجن كبير

في عام 1785، وضع «جيريمي بنتام» تصميمًا لسجن «بانوبتيكون»، تقوم فكرته على أن يكون جميع السجناء مراقَبين طيلة الوقت، وعلى علم بأنهم مراقبون من حارس واحد يجلس في برج مراقبة يكشف زنازينهم المصممة بشكل دائري، ولا يتمكن السجناء من معرفة إن كان أيٌّ منهم مُراقَبًا الآن أم أن الحارس مشغول بآخرين.
كانت الفكرة هي خلق حالة من الاجتماع داخل السجن، قائمة على الخوف الدائم والحرص على أن لا يراهم الحارس وهم يرتكبون خطأً ما، ومن ثَمّ استخدام هؤلاء السجناء في الإنتاج، وربما بيع ما ينتجونه وتحقيق ربح.
تأثر فوكو بشدة بهذه الفكرة، وربما لهذا أضاف عنوانًا فرعيًا لكتابه «المُراقَبة والمعاقبة»، هو «ميلاد السجن».
رأى فوكو أن لهذه الآلية في المراقبة الدائمة، أو المراقبة الذهنية كما أسماها، قدرة على خلق دولة البانوبتيكون، وليس فقط السجن أو المدرسة التي يخشى فيها الطلبة مدرسيهم فيُحَصِّلون المعلومات خوفًا من العقاب، المجتمع الذي يخشى فيه المرء الحديث لربما أدى إلى أمر أبسط من اعتقاله أو تقييد حريته، بل مثلًا أن يعود إلى منزله بعد سهرة لطيفة مع الأصدقاء تحدثوا فيها عن بعض الأمور التي أنجزوها في الأسبوع الماضي.
يدور الحوار مرحًا، ويذكر فيه بعضنا أسماء ماركات عالمية، ويثرثر آخرون عن فرق الكرة التي يتابعونها، فيعود الواحد منهم إلى منزله ليجد أن ما تحدث بشأنه صوتيًّا قد تم تحليله بطريقة ما من هاتفه الذكي، ولهذا يرى عددًا من الإعلانات عن الماركات التي تحدث عنها، أو أخبارًا عن فريق كرة ذكر اسمه.
رحب سلافوي جيجك بمراقبة المواطنين لثقته في غباء البرنامج الإلكتروني الذي يحلل البيانات، لأن مصمميه «مبرجمون يعملون لدى ضباط أغبياء».
فوكو توقع رد فعل ملايين الشباب ممن استمعوا إلى كلمات «إدوارد سنودن»، الذي فضح المخابرات الأمريكية، وهو يقول إن حكومات الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا تتجسس على الحياة الخاصة للمواطنين (مكالماتهم الهاتفية ومعلوماتهم الشخصية المسجلة على وسائل التواصل الاجتماعي، إلخ). فوكو توقع أن الملايين سيصيبهم الغضب ربما، لكن لن تصيبهم الدهشة.
الجميع يتعامل مع حالة المراقبة الافتراضية الحالية بشكلها الكوني على أنها حقيقة وجودية، ويعلم الملايين أن بياناتهم الشخصية موجودة في ملفات الأجهزة الأمن ولدى شركات الإعلانات، وجُلُّ ما يتمنوه أن لا تُستخدَم هذه المعلومات لإيذائهم شخصيًّا.
بات الجميع يتعاملون مع الأمر بدرجة كبيرة من الاستسلام، وبعضهم يتعامل مع الأمر على طريقة الفيلسوف «سلافوي جيجك»، حين طُلب منه إبداء رأيه في قضية مراقبة الشركات وأجهزة الأمن للمواطنين، فقال إنه يرحب بها لعلهم يتعلمون شيئًا، فهو واثق في غباء البرنامج الإلكتروني الذي يحلل البيانات، لأن من صمموه مبرجمون يعملون لدى ضباط أغبياء، فدعهم يراقبونني، قد يتعلمون شيئًا أو يستفيدون من معلومة أقولها أنا أو أنت.
اقرأ أيضًا: فيلم «Network» الذي تنبَّأ بتحولات الإعلام والسياسة قبل 40 عامًا
يبدو الأمر مخيفًا عندما تسأل شخصًا يحب الممثل «جوزيف غوردون-ليفيت» عن رأيه في أدائه لشخصية «سنودن»، في الفيلم الذي أخرجه «أوليفر ستون» ويحمل نفس الاسم، وتجد أن ذلك الشخص ربما لا يعلم أنه أدى هذا الدور، ولا يهتم كثيرًا بستون وتناوله لقضية التجسس الحكومي على المواطنين.
يبدو الأمر مشابهًا لرد آيزنهاور المستفز على خروشوف قبيل قمة باريس 1960، حين أسقط السوفييت طائرة تجسس أمريكية، فكان رد فعل آيزنهاور على عصبية خروشوف أن قال له إن «جمع المعلومات حقيقة من حقائق الحياة».
الاستسلام للمراقبة: سمة جديدة في العالم

يقول ميشيل فوكو إن فكرة طاعة الدولة واهية، فأنت تلتزم بقوانين عدد من رجال الأعمال الذيم يمولون الحزب الحاكم.
لا تبدو فكرة المراقبة مثيرة للخوف دائمًا بقدر ما هي مثيرة للتساؤل عند كثيرين، أو ربما للضحك، كمثال جيجك، باتت المراقبة حقيقة وجودية.
ربما توجه نفس السؤال إلى نفس الشخص، الذي لا يعرف أو لا يذكر دور جوزيف غوردون-ليفيت في فيلم «Snowden»، وتطلب منه رأيه في أداء «ويل سميث» في فيلم «Enemy of the State»، وقد يكون من المؤكد أن هذا الفيلم ومناقشته ستثير كثيرًا من الكلام والتساؤل لدى ذلك الشخص الذي لم يعد يلتفت أو يهتم لانتهاك خصوصيته، فاهتمامه بهذه الدرجة من حرية الحياة الخاصة الآن يختلف عن 20 عامًا مضت.
اقرأ أيضًا: عيون إلكترونية في كل مكان: كيف تراقبنا التكنولوجيا؟
الفيلم أثار لدى بعض الناس دهشة عند ظهوره، وتحدث آخرون عن أن فيه كثيرًا من المبالغة، إلا أنه يبدو الآن كجرس تحذير جاء منذ 20 عامًا ليخبر المواطن الأمريكي، ومِن بعده المواطن بشكل عام أيًّا كانت دولته، أنه مراقَب على مدار الساعة، وقد تكون محادثاته الحميمية أو قائمة مشترياته مستندًا يُستخدَم لإدانته، أو جذبه ناحية أمر ما يعلم من يراقبه أنه قد يهتم به، ومن ثَمّ استخدامه هو شخصيًّا لتحقيق أهداف تتوافق مع سياسة الدولة، أو بالأحرى سياسة من يحكمونها.
كان يحلو لفوكو أن يبين ذلك الحد الفاصل، إذ يتحدث عن أن فكرة إرادة الدولة أو طاعة الدولة والالتزام أمنيًّا فكرة واهية، فأنت في الحقيقة تلتزم بقوانين وضعها حزب يميني مثلًا، فاز في الانتخابات بنسبة كافية ليتزعم المجلس النيابي، ويصبح عليك كمواطن أن تكون مطيعًا لتوجيهات عدد من رجال الأعمال الذين يمولون هذا الحزب، تحت مسمى طاعة الدولة وممارسة الانضباط.
المحامي «روبرت كلايتون» (ويل سميث) تنقلب حياته عندما يضعه جهاز الأمن القومي قيد المراقبة، خشية تسرب معلومات على اسطوانة رقمية هو نفسه لا يعلم أنها بحوزته، فيقرر ضباط الجهاز نزع مصداقيته وتشويه سمعته، بنشر معلومات خاصة بحياته واتصالاته بسيدة كان على علاقة بها، وعائلة مافيا إيطالية كان يباشر قضية تخص تورطها في أزمة عمالية، فيصبح هذا الرجل شيطانًا في نظر عائلته وزملائه في العمل، وتوشك حياته على الانهيار.
يقابل كلايتون «إدوارد ليل» (جين هاكمان)، الذي يكشف له أنه جهازًا أمنيًّا يراقب مكالماته الهاتفية واتصالاته الشخصية وأنشطة البيع والشراء، فإذا قلت في الهاتف كلمات مثل «الله، قنبلة، إلخ»، فهذا كافٍ لأن يلتقط برنامج جهاز الأمن القومي المكالمة ويتنصت على حياتك خوفًا من أن تكون إرهابيًّا محتملًا.
لم ينتظروا أن يكشف عن معلوماته، بل لم يهتموا أصلًا بأن هذه الاسطوانة التي تحوي المعلومات تسربت إلى حقيبته دون علمه، ربما كان شخصًا يريد أن يُترك وشأنه، لا يريد التورط في أي مشاكل، لكن هذا ليس كافيًا، فمجرد كونك تشكل احتمالية التهديد كافٍ لشن الحرب عليك.
داخل الحبكة البوليسية للفيلم، نرى خطًّا جانبيًّا يدور حول عضو في الكونغرس يحاول تمرير قانون يسمح بالتنصت على المواطنين داخل منازلهم لحماية الأمن الأمريكي، ويثير الأمر لغطًا في المجتمع، وتعترض زوجة روبرت كلايتون مثلًا على القانون، الذي من شأنه اختراق خصوصية الأفراد وتعريض سمعتهم للخطر.
تجليات «الأخ الأكبر»

ما طرحه فيلم «Enemy of the State» كقصة بوليسية خيالية عن إدارة أمنية تراقب المواطن، مثل «الأخ الأكبر» لدى «جورج أورويل»، صار أمرًا واقعًا في عام 2017، بل ولا يثير حتى الدهشة أو الاعتراض الكافي.
يقف «إدوارد ليل» قرب نهاية الفيلم متحدثًا إلى «توماس رينولدز»، مسؤول جهاز الأمن القومي، عبر سلك شائك يفصل بينهما. وحين يسأل الأول عن جدوى كل هذا، وعن القتل وتشويه سمعة الأفراد، يجيبه الأخير بأن الفضاء الإلكتروني أصبح يحوي كثيرًا من المعلومات الخطيرة، فمن الممكن لبعض المراهقين أن يصلوا إلى ملفات تحوي كيفية صنع القنابل والأسلحة، وعلينا كجهاز أمني أن نمنع كل هذا قبل حدوثه، لا أن ننتظر.
قد يهمك أيضًا: المتعة المرعبة: كيف تُغسل الأدمغة؟
أثار هذا الفيلم جدلًا مرة أخرى بعد هجمات 11 سبتمبر، عندما بدأ المواطن الأمريكي يتساءل: أين كان هؤلاء بكل تلك المعلومات التي يملكونها حين ضُربت أمريكا في عمق هويتها الثقافية، مدينة نيويورك؟ أين كانت كل تلك المعلومات؟ ما الذي عاد على المواطن من كشف بياناته ومعرفة أرقام حساباته وعادات التسوق الخاصة به؟ ولا زال الأمر يثير التساؤل حتى الآن، بعد الضربات التي تعرضت لها عدة مدن أمريكية على يد متعاطفين مع تنظيم داعش.
الحرب: حل استباقي

تتجلي فكرة الحرب على الاحتمالية بشكل أكبر في فيلم «Minority Report» للمخرج الأمريكي «ستيفن سبيلبرغ».
يقود «شون أندرتون»، الذي يؤدي دوره «توم كروز»، فريقًا من المستبصِرين الذين يتوقعون جرائم القتل قبل وقوعها، وبالتالي يعتقل القاتل المحتمل قبل ارتكابه الجريمة. ويثير الفيلم تساؤلًا أخلاقيًّا حول هذه الفرضية الجبرية، فمسار حياتك تحدده الدولة التي تنبأت عن طريق أجهزتها بمصيرك، بغض النظر عن كون هذه «الأجهزة» ثلاثة شباب يتنبأون بالمستقبل.
بعد عرض فيلم «Minority Report» بعام، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن أن الولايات المتحدة ستشن «حروبًا استباقية» ضد الدول التي قد تشكل تهديدًا مستقبليًّا.
في هذا الفيلم، تنتقل الدولة إلى مستوى آخر من الفعل الرقابي، فالمراقبة هنا تحمل طابعًا ميتافيزيقيًّا، فلا يوجد أي تأكيد علمي قاطع يثبت أن من يعتقلهم أندرتون قتلة بالفعل.
عندما يلتقي بمصممة البرنامج، تكشف له أن كثيرًا ممن اعتُقلوا كانت لهم رؤية أخرى إلى جانب الرؤية التي تنبأ بها المستبصرون بجريمة القتل، رؤية لم يرتكب فيها المعتقَل الجريمة، وعليه فإن دليل براءته تحول إلى ما يسمى «Minority report» أو «رأي الأقلية»، فلم يحدث إجماع على براءته، تمامًا مثل من يُدانون في جرائم قتل في الولايات المتحدة، ويكون بعض أعضاء هيئة المحلفين يعتقدون في براءتهم.
الدولة هنا تستخدم معاملًا روحيًّا في الحكم، وكل الأجهزة التكنولوجية المبهرة، التي وظف سبيلبرغ رؤيته فيها للمستقبل ببراعة شديدة، فنجد أنهم يحتفظون بالمستبصرين في غرفة يسمونها «المعبد»، ويتعاملون مع ما يرونه من أحلام بتقديس ديني ورهبة روحية، فالحكم هنا لا يستخدم الدين، بل تتحول أدواته إلى دين.
اقرأ أيضًا: أفلام «آدم كيرتس» تكشف حقيقة التحكم في الشعوب
عُرض الفيلم عام 2002، وبعد عام واحد أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن أن بلاده ستشن «حروبًا استباقية» ضد الدول التي قد تشكل تهديدًا مستقبليًّا، فكانت حرب العراق، التي اختار لها بوش اسم «الدول المارقة»، وكان القساوسة البروتستانت المتشددون يقولون إنه ونائبه ديك تشيني يستطيعان التحدث إلى الله في الهاتف، بعد أن باركهما الرب بنعمة الاستماع إليه.
لهذا قامت الحرب التي أسماها بوش حربًا مقدسة أو حملة صليبية ضد الإرهاب، وأصبح قتال «الاحتمال» أمرًا طبيعيًّا، فغزت القوات الأمريكية العراق، وهي الدولة التي لم تهاجم أمريكا قط.
غياب القلق عن مشهد المراقبة هو ما يحفز أجهزة الأمن في الولايات المتحدة وإنجلترا وأستراليا، والدول القادرة على هذا النوع من التجسس، على بذل مزيد من الجهد لاختراع سبل جديدة للرقابة.
يبدو أن الرأسمالية التكنولوجية تعمل في خدمة أجهزة الأمن بدون إدراك، وفي تواطؤ قد يبدو لمدمني نظرية المؤامرة مقبولًا، إلا أنه يشكل صدفة وجودية طريفة. فمثلًا، يمنحك تطبيق مثل سنابشات أو إنستغرام إمكانية أن تقدم طواعيةً تقريرًا يوميًّا عن نفسك، أو أن تظهر في بث مباشر متطوعًا بمنح الآخرين نافذة على حياتك وما تفعله لتصبح مُراقَبًا بإرادتك.
التلصص/ المحبة/ الاهتمام
مشهد من فيلم «The Truman Show»
إدمان الاهتمام يساعد الشركات الكبيرة وأجهزة الأمن التي ترغب في جمع المعلومات عن المواطنين، فهي الآن تمتلك تقريرًا مفصلًا ويوميًّا عن حياتك، فها أنت جالس في المطعم مع أصدقائك تسجل فيديو لإنستغرام أو بثًّا مباشرًا على فيسبوك، أو إن كنت ممن يدمنون الاهتمام لدرجة اختيار أن يشاهد الجميع صورك، وليس فقط من هُم في قائمة أصدقائك، فتعلم تلك الجهات ما جرى في يومك، وما تفضله من طعام، والمكان الذي تحب التردد عليه، بل وأسماء أصدقائك، وربما مهنهم أيضًا.
يبدو فيلم «The Truman Show» سابقًا لعصره، وهو يتنبأ بتحول المواطن في مرحلة ما إلى موضوع للتسويق، وأسير للكاميرا التي ترصد حركاته.
بدا الأمر مثل الحلم أو الدعابة عندما عُرض فيلم «edtv»، الذي تقوم قصته على شخص يمنح حياته الخاصة طواعيةً إلى محطة تلفزيون تسجل يومه بالكامل وتبث تفاصيل حياته، ويتحول إلى برنامج ذي شعبية في أمريكا. بعد الفيلم، انتشرت برامج تلفزيون الواقع، التي تسجل ما يدور داخل بيت حقيقي يسكنه أناس حقيقيون وليسوا ممثلين، والمتفرج يتابع أدق التفاصيل الخاصة بحياة هؤلاء.
عندما قدم المخرج «بيتر وير» فيلمه «The Truman Show»، بنى فكرته على أساس مغاير تمامًا لتلك الفكرة، فبطله يجهل أنه موضع مراقبة. «ترومان» يمثل حالة أكثر ضعفًا من حالة السجناء التي تحدث عنها فوكو وصممها بنتام، فهو لا يعرف أنه سجين داخل هذا البرنامج، وأنه مراقَب طيلة حياته، وأن الحياة تتوقف بعد خروجه من الغرفة، ويغير الممثلون ثيابهم ويذهبون إلى مكان آخر يؤدون فيه دورًا آخر في حياته.
«The Truman Show» يقف بعيدًا تمامًا عن حالة طلب المراقبة وإدمان الاهتمام، فالمهتم الحقيقي هنا هو المُراقِب، الذي يؤدي دوره «إد هاريس» منتج البرنامج، والذي يبدو كإله يتحكم في حياة ترومان، ويستخدم قصصه اليومية لجذب الأرباح، بل ويبيع المنتجات عن طريقه.
يبدو الفيلم سابقًا لعصره بأكثر من 20 عامًا، وهو يتنبأ بتحول المواطن في مرحلة ما إلى موضوع للتسويق، وأسير للكاميرا التي ترصد حركاته، وضيف على برنامج كبير يظن فيه أنه بطل، لكنه لا يملك رفاهية الرحيل، مثلما فعل ترومان في النهاية واختار حريته بعدما اكتشف أنه عبارة عن برنامج ترفيهي.
النسخة الحالية من ترومان هي لمواطن لن يقاوم كل هذا القدر من الاهتمام، وحين يأتيه صوت المنتج من السماء يدعوه إلى الاستمرار في حياته كخدعة استهلاكية، لن يضحي بكل ضغطات الإعجاب أو «اللايكات»، ولن يغادر المدينة الافتراضية، بل قد يبقي مستمتعًا بأن هناك من يشاهد حياة يظنها فيلمه الخاص وهو بطله، وبأن من يراقبونه هم حراس البهجة والإيجابية.