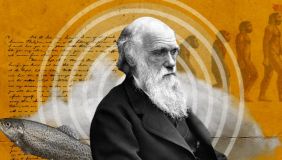هذا الموضوع ضمن هاجس شهر نوفمبر «من نراقب؟ من يراقبنا؟». اقرأ موضوعات أخرى ضمن الهاجس من هنا، وشارك في الكتابة من هنا.
لا يزال الجدل دائرًا حتى الآن بين «الفنان» صاحب المنتَج الإبداعي و«المراقب»، وأقصد بالمراقب هنا المفهوم العام للرقابة متمثلًا في شخص أو جماعة أو مفهوم، يحاول فرض سطوته على المبدع بشكل عام لقولبة فنه، بحيث يصبح ملائمًا لفكرته المحدودة عن الفن، الأمر الذي يؤطر الفن بمعايير غير جمالية أو فنية من الأساس.
في عام 1784، طرحت مجلة «برلين» الشهرية على الفيلسوف الألماني «إيمانويل كانط» سؤالًا حول مفهوم التنوير، فكانت إجابته الرئيسية «تجرأ واستعمل عقلك أنت»، أي أن التنوير من وجهة نظره هو محاولات التحرر من الأنماط والوصاية الجماعية على الفرد، وتحرير العقل، والحلم بإنسانية حرة تتمتع بالإرادة، ومحررة تحررًا جماعيًّا من القيود، وقادرة على حفظ كرامة الإنسان والارتقاء به، الأمر الذي يتنافى مع فكرة «الأخ الأكبر» التي طرحها «جورج أورويل» في روايته «1984»، والتي أصبحت المجاز الأشهر عن المراقبة والتحكم.
صار الأخ الأكبر عائلة كبيرة من الإخوة الكبار، ممثلةً في السلطة العسكرية، والسلطة السياسية، والسلطة الدينية، والسلطة المجتمعية، والسلطة الأخلاقية، والسلطة الأسرية.
أكثر حالات الرقابة شهرةً كانت حين حُكم على «سقراط» بشرب السم، بسبب إفساده للشباب ونقده لآلهة اليونان ونظام الحكم الأثيني.
تأتي فكرة الرقابة من عمق الجماعة الراغبة في التسلط، مع إمكانية تحويل تلك الرغبة إلى فعل، فهيمنة وتغول سطوة بعض أفراد تلك الجماعة، لأسباب دينية أو سياسية، جعلتهم يجلسون على قمة هرم الرقابة.
ولأن الفن كان دائمًا بدون سلطة، لا دينية ولا سياسية، أصبح الطفل الأصغر في العائلة الكبيرة، الطفل الذي يراقبه كل فرد في عائلة السلطة، ويجبره على التصرف وفق معاييره الخاصة، دينيةً كانت أو سياسية أو اجتماعية، مع تجاهل تام للمعايير الجمالية الخاصة بالفن.
من هنا ظهرت فكرة الرقابة على المصنفات الفنية بشكل عام، إذ يجب أن توافق السلطة والدين والمجتمع على المحتوى الفني، في قضاء تام على فكرة التنوير والتحرر.
لعل أكثر حالات الرقابة شهرةً في العصور القديمة ما حدث مع الفيلسوف اليوناني «سقراط»، الذي قضت المحكمة العليا «الديكاستيرا» عليه بشرب السم في عام 399 قبل الميلاد، بسبب إفساده للشباب ونقده لآلهة اليونان، والأهم نقده لنظام الحكم الأثيني في وقتها.
الرقابة خيط طويل ممتد على مستويات مختلفة، بدءًا بالرقابة على الفكرة كمفهوم أخلاقي معنوي غير ملموس، والرقابة على الكلمة المنطوقة، وصولًا إلى الرقابة على الكلمة المكتوبة أو الأغنية أو الفيلم أو اللوحة كمنتَج إبداعي.
الرقابة: الهروب من باب الأسماء

«في عالم الإنترنت، نقود خصوصيتنا إلى المذبح بإرادتنا، ونقبل فقدان الخصوصية باعتباره ثمنًا معقولًا للعجائب المعروضة في مقابلها».
بعد كل هذا الاستهلال الطويل عن معنى الرقابة، كيف يمكن للكاتب خصوصًا أن يُنتج منتَجه الإبداعي بشكل مستقل، ويتحايل على رقابة كل الإخوة الكبار. ربما كان الحل الأشهر للتحايل على الرقابة هو استخدام أسماء مستعارة للكتابة، وهناك قائمة طويلة عبر التاريخ لكُتاب استخدموا أسماء مستعارة، مثل «موليير» و«فولتير» و«مكسيم غوركي» و«جورج إليوت»، والمثال الأكثر شهرةً «فيرناندو بيسوا».
عربيًا، نجد ألقابًا مثل «بنت الشاطئ» عائشة عبد الرحمن، و«باحثة البادية» مَلَك حفني ناصف، وهي ألقاب استخدمتها كاتبات للتحرر من السلطة المجتمعية التي تراقب المرأة مراقبةً إضافية، لكونها «امرأة».
استطاع الكُتاب في أزمنة سابقة الحفاظ على هوياتهم سرية لفترات طويلة، لكن في الوقت الحالي اختلف الأمر، لأن عالم الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أدت إلى «موت الخصوصية»، الذي ذكره «زيغمونت باومان» في كتابه «المراقبة السائلة».
يشرح باومان أننا «في عالم الإنترنت، نقود حقوق خصوصيتنا إلى المذبح بإرادتنا، أو ربما نقبل فقدان الخصوصية باعتباره ثمنًا معقولًا للعجائب المعروضة في مقابلها، أو ربما يكون الضغط بتسليم استقلالنا الشخصي للمذبح كبيرًا جدًّا، وقريبًا جدًّا من حال قطيع أغنام، فلا نجد سوى قلة من إرادات شديدة التمرد والجرأة والتحدي والعزم، تُبدي استعدادًا للصمود الجاد أمام هذا الضغط».
قد يهمك أيضًا: عن قُبلة لن تشاهدها: قصة الرقابة في الكويت
مواقع التواصل الاجتماعي: ضد الخصوصية

الجميع ينتهك حريتي وخصوصيتي بموافقتي، في مقابل شعور زائف بالنجومية من جمهور مواقع التواصل، لإشباع فضولهم نحو مراقبة شخص ما.
قبل ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، كان الكاتب يستطيع أن يختفي ويطلق إنتاجه الأدبي بشكل مستقل تمامًا عنه، أما الآن، حوّلت مواقع التواصل الاجتماعي الكاتب إلى ما يشبه الممثل المسرحي، يتلقى رد الفعل مباشرةً ولحظيًّا على كتاباته، الإعجاب والمدح، أو الاستنكار والنقد، مما يمثل شهوة كبيرة للكاتب، بعد أن كان ينتظر رأي النقاد أو انطباع الجماهير في ندوات مغلقة أو مجلات متخصصة.
في عام 2010، سجّلت للمرة الأولى على موقع فيسبوك، وصرت أقدم حياتي بأغلب تفاصيلها عليه، أقدم جزءًا من نفسي ومن شخصيتي وذكرياتي وذاكرتي لأتواصل مع الآخرين. مع الوقت، أصبحت أشارك بعضًا من يومياتي أو خواطري ونصوصي، كنت أبحث عن أصدقائي ومعارفي وأقاربي، أبحث عن كُتابي المفضلين، الفنانين، المعلمين، كل من أعرفهم كنت أبحث عنهم في ذلك «الكتاب الأزرق الكبير».
أصبح الجميع ينتهك حريتي وخصوصيتي بموافقتي، في مقابل شعور زائف بالنجومية يمنحونني إياه في أوقات كنت أشعر فيها بالتهميش والتجاهل والإغفال والإقصاء، وهو في الحقيقة ليس إلا مقابلًا هشًّا هدفه التحريض على مزيد من إشباع فضولهم نحو مراقبة شخص ما.
من هنا تهاوى الفارق بين ما أنشره على صفحتي الشخصية من مشاركات خاصة، وما أنشره باعتباره كتابة أدبية تخص أبطالها، فصار الجميع يُحيل ما أكتبه بشكل أدبي على حياتي الشخصية، وربما مع تصفح الصور والمنشورات يبدؤون في ما يشبه تجميع الخطوط لتأكيد الربط بين الكتابة وبيني كشخص في ظل سياق أكثر اتساعًا، في ضربة قاضية لفكرة موت المؤلف التي طرحها الناقد الفرنسي «رولان بارت».
الإعجاب الفوري: نقطة ضعف الكاتب

لا يمكن القول إن فكرة الربط بين الكاتب وأعماله الأدبية أو نصوصه الشعرية حدثت بسبب مواقع التواصل الاجتماعي فقط، لكنها أصبحت أكثر هيمنةً على الجماهير المعاصرة، وهم صاروا أكثر تصديقًا لها بمراقبتهم المستمرة لحياة الكاتب الشخصية.
بعد فترة طويلة من التشبع بالتواصل من خلال فيسبوك، أصبحت أكثر وعيًا بمشاركاتي، وأكثر انتقائيةً في اختيار الأصدقاء، والانتقائية هنا تتناسب عكسيًّا مع شكل العلاقة خارج فيسبوك.
من لم أستطع إجلاءهم من حياتي بشكل فعلي، من أقارب ومعارف لا هَمّ لهم سوى المراقبة طوال الوقت، وضعتهم في قائمة الحظر الطويلة، حتى أمنع عنهم شهوة المراقبة المستمرة ونقل محتوى منشوراتي المسيء أو غير الأخلاقي من وجهة نظرهم إلى باقي العائلة، في تأطير واضح ومحدد لشكل المراقبة الكلاسيكي دون أي مواربة.
اقرأ أيضًا: نُبوءَة «نهاية الكتاب المطبوع» تفضح خوفنا من التغيير
ولأن ما نطلقه من منشورات ومعلومات وصور وبيانات على الإنترنت لا يمكن حذفه بشكل كلي، وسيظل موجودًا بشكل ما حتى لو حذفناه، فكرت أخيرًا في اختيار اسم مستعار أنا الأخرى، كما فعلت «إيلينا فيرانتي»، الروائية الإيطالية المعاصرة، التي استطاعت الحفاظ على هويتها الأصلية سريةً رغم كل محاولات النبش في تاريخ بطلاتها، والربط بينهن وبين شخصيات بعينها للتوصل إلى هويتها الحقيقية.
أتساءل: هل يمكنني أن أطلق ما أكتبه منفصلًا تمامًا عن شخصي؟ كيف أجعل الأبطال والبطلات يحلقون بعيدًا عني، بعيدًا تمامًا عن حياتي الواحدة، في ظل حيوات أخرى تتغير وتتبدل مع كل قصة أو حكاية؟
متعة التخفي أم متعة الشهرة؟

هل أستطيع التنازل عن شهوة تلقي الإعجاب، أو حتى النقد، والدفاع عما أكتب، في مقابل متعة الحرية والأهم متعة المراقبة التي سأنعم بها مع اسم غير معروف، حين أتحول أنا لمراقبة الأقارب والأصدقاء، وهم يقرؤون ما أكتبه دون أن ينسبوه إليّ، يحللونه ويحاولون البحث بين السطور عن إشارات تعرفهم بكاتبته أو تدلهم عليها.
أفكر أن أنتحل شخصية رجل ذي اسم كلاسيكي مُرَكّب، وأجعل المشهد الأول من الرواية لهذا الرجل وهو يقف أمام مرآة الحمام يهذب ذقنه، أو يتذكر حبيبته القديمة ويستمني، لأراقب حياته الجديدة وهي تتشكل أمامي، في سلسلة لا تنتهي من المراقبة المستمرة.
عند محاولات تتبع النماذج والتنظيرات الأدبية المختلفة، يبدو أن أي سلطة شمولية ترغب في استعمال الأدب كأداة لترسيخ سلطتها ومفاهيمها ليس أكثر، ليتحول الإبداع المتفق عليه سلطويًّا إلى ما يشبه نموذجًا يجب أن يتكرر لتبنّي وتأطير شكل جماعي للأدب، بعيدًا عن فردانية المبدع وعالمه الداخلي.
تريد السلطات أيضًا، بالإضافة إلى وجوب تطبيق هذا النموذج بشكل آلي، أن يركز أكثر على الجماعة والرسالة الأخلاقية للأدب، والبطل المثالي الذي لا يخطئ، ليتحول الفن من إبداع فردي إلى نمط جماعي شعبوي، وذراع من أذرع السلطة، أيًّا كان توجهها، في شكل أقرب إلى أدب الواقعية الاشتراكية الذي ظهر في الاتحاد السوفييتي خلال ثلاثينييات القرن العشرين، وكان له ارتباط وثيق بالأيديولوجيا السياسية والاقتصادية في ذاك الوقت.
رغم تجاوز الشكل العام للواقعية الاشتراكية في الأدب، وظهور حركات وتيارات أدبية وفنية أكثر تحررًا واهتمامًا بفردية المبدع، تبقى الواقعية الاشتراكية هي الشكل والمفهوم الأقرب إلى الفن كما تتمناه الأنظمة السلطوية.