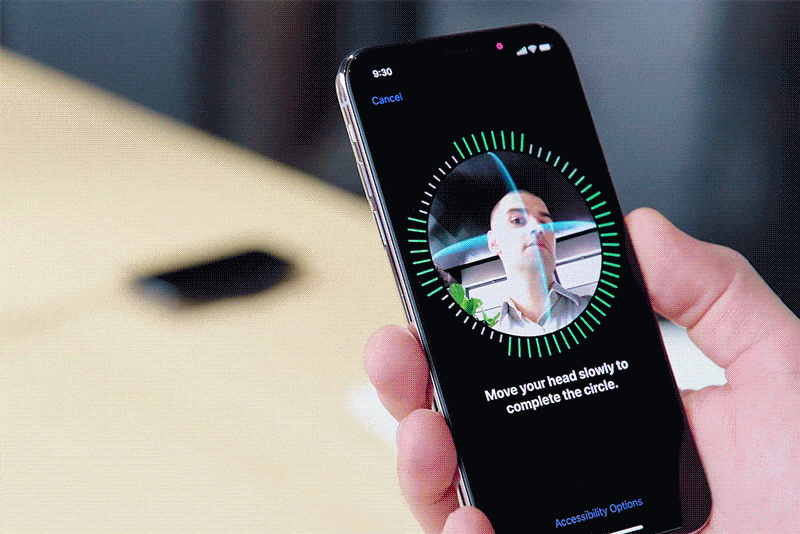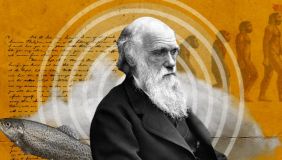في نوفمبر 2017، اقتحم مسلح كنيسة في ولاية تكساس وقتل 26 شخصًا وأصاب 20 آخرين. هرب المسلح بسيارته، وبينما تطارده الشرطة والمواطنون، فقد السيطرة على السيارة وانقلبت به. عندما وصلت الشرطة إلى السيارة كان قد فارق الحياة بالفعل.
في أثناء التحقيقات، استخدم محققو «FBI» إصبع الرجل لفتح قفل هاتفه، الذي كان يعمل بخاصية التعرف على البصمات. وبغض النظر عن أن المتضرر كان مُجرمًا في هذه الحالة، أوليس من المزعج أن تستخدم الشرطة جثة شخص ما لاقتحام حياته التي فارقها؟
تكفل معظم الدساتير الديمقراطية حق الحماية من أي تدخلات غير مرغوبة في ما يتعلق بأدمغتنا وأجسادنا، وتحفظ حق حرية الفكر والخصوصية العقلية، لذلك لا يمكن إعطاء أي شخص عقاقير كيميائية عصبية تؤثر في أدائه المعرفي، ما لم يكن هناك مبرر طبي واضح.
في العصر الحديث الذي تنتشر فيه التكنولوجيا في كل مكان، بدأ الفلاسفة يتساءلون عما إذا كان التشريح البيولوجي يوضح فعلًا حقيقة ما نحن عليه. فبالنظر إلى الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في حياتنا، يمكننا أن نتساءل: هل تستحق أجهزتنا الإلكترونية نفس الحماية التي تتمتع بها عقولنا وأجسادنا؟
قد يبدو ذلك غريبًا، لكن لا جدال أن الهواتف الذكية على سبيل المثال تجاوزت كونها مجرد هواتف، فهي الآن تعرف عن خصوصياتك ما لا يعرفه صديقك المقرب. لم تحتوِ أداة أخرى في التاريخ، ولا حتى أدمغتنا، على نوعية أو كمية المعلومات الموجودة على هواتفنا الآن، فهي «تعرف» من تتحدث إليه، ومتى تتحدث إليه، وما قلته، وأين كنت وقتها، وفي كل وقت، وقائمة مشترياتك، وصورك، وبياناتك، وحتى ملاحظاتك التي كتبتها لنفسك، والتي قد تعود إلى سنوات مضت.
في مقال نُشِرَ على موقع «Aeon»، توضح «كارينا فولد»، الباحثة في مستقبل الذكاء بجامعة كامبريدج، أنه في عام 2014 استخدمت المحكمة العليا في أمريكا هذه الفكرة لتبرير قرارها بضرورة حصول الشرطة على مذكرة قبل تفتيشها الهواتف الذكية.
يقول رئيس القضاة «جون روبرتس»: «أصبحت هذه الأجهزة الآن جزءًا من الحياة اليومية بشكل منتشر وملحوظ، فإذا افترضنا جدلًا أن أحدهم وفد إلى كوكب الأرض من المريخ مثلًا، سيظن أن تلك الأجهزة جزء من التكوين التشريحي للإنسان».
ربما لم يكن روبرتس مهتمًّا بإرساء نقطة ميتافيزيقية بخصوص اعتبار الهاتف جزءًا من الإنسان، لكن الفيلسوفين «آندي كلارك» و«ديفيد تشالمرز» كانا دون شك من اهتما بذلك في كتابهما «العقل الممتد».
هاتفك أحد أعضائك
بالنظر إلى استحواذ هواتفنا الذكية على وظائف أدمغتنا، يجب أن تُعامَل بيانات الهواتف مثل المعلومات التي نحتفظ بها في رؤوسنا.
يناقش الفيلسوفان الكيفية التي أصبحت بها التكنولوجيا في الواقع جزءًا منا.
فوفقًا للعلوم المعرفية التقليدية، «التفكير» هو العملية التي تتلاعب بالرموز أو الحسابات العصبية التي ينفذها الدماغ. يقبل كلارك وتشالمرز هذه النظرية الحسابية للعقل بدرجة كبيرة، إلا أنها يدَّعيان إمكانية دمج الأدوات المختلفة بسلاسة مع طريقة تفكيرنا، فغالبًا ما تلعب تلك الأدوات، كالهواتف الذكية، دورًا أساسيًّا في معرفتنا، تمامًا مثل الوصلات العصبية الموجودة في رؤوسنا، فهي توسع عقولنا وتعمقها من خلال زيادة قوتنا المعرفية وتحرير إمكانياتنا الداخلية.
إن صح هذ الطرح، فإنه يهدد فرضيات ثقافية واسعة النطاق حول الطبيعة المحصَّنة للتفكير، والتي ترسخت في صميم معظم المعايير القانونية والاجتماعية. فعلى سبيل المثال، أعلنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة عام 1942 أن «حرية التفكير مطلقة بطبيعتها الخاصة، ولا تستطيع أكثر الحكومات استبدادًا التحكم في أعمال العقل الداخلية».
ترجع جذور هذه الفكرة إلى فلاسفة مثل «جون لوك» و«رينيه ديكارت»، إذ جادل الأخير بأن النفس البشرية حبيسة الجسد المادي، وأن أفكارنا تسكن عالمًا غير مادي لا يمكن للآخرين الوصول إليه. ولذلك لا تحتاج الحياة الداخلية إلى الحماية إلا عندما يُفصَح عنها في الخارج، عن طريق الكلام مثلًا. ورغم أنه لا يزال هناك عدد من الباحثين في العلوم المعرفية يتشبثون بهذا المفهوم الديكارتي، فقد بدا في الأفق فهم جديد للأمور.
تعمل المؤسسات القانونية اليوم على الحد من هذا المفهوم الضيق للعقل، فهُم يحاولون فَهْمَ كيفية تغيير التكنولوجيا لماهية الإنسان، ووضع حدود معيارية جديدة للتعامل مع هذا الواقع.
قد لا يعرف القاضي جون روبرتس فكرة العقل الممتد، لكنها تدعم ملاحظته العفوية بأن الهواتف الذكية أصبحت جزءًا من أجسادنا. فإن كانت عقولنا تشمل هواتفنا الآن، فنحن في الأساس عبارة عن «سايبورغ»: جزء بيولوجي، وجزء تكنولوجي.
بالنظر إلى الكيفية التي استحوذت بها هواتفنا الذكية على وظائف أدمغتنا التي كانت يومًا ما تحفظ التواريخ وأرقام الهواتف والعناوين، فربما يجب أن تُعامَل البيانات التي تحتوي عليها هذه الهواتف على قدم المساواة مع المعلومات التي نحتفظ بها في أدمغتنا. فإذا كان القانون يهدف إلى حماية الخصوصية العقلية، فإننا سنحتاج إلى توسيع حدوده ليشمل «تشريحنا السايبورغي» على نفس النحو الذي يحمي به عقولنا.
يؤدي هذا المنطق في التفكير إلى آراء راديكالية أحيانًا، إذ يتحدث بعض الفلاسفة عن وجوب التعامل مع أجهزتنا الرقمية باعتبارها جزءًا من رُفاتنا عندما نموت. فإذا كان هاتفك الذكي جزءًا من هويتك، عندئذ ربما ينبغي أن يُعامَل هاتفك كأحد أعضائك، لا كأحد متعلقاتك.
وبالمثل، قد يجادل المرء بأن التخلص من هاتف شخص ما شكل من أشكال الاعتداء «الممتد»، أي أنه يعادل إلحاق الأذى برأسك مثلًا، وليس مجرد إتلاف للممتلكات. فإذا فقدت ذاكرتك لأن شخصًا هاجمك وضربك، فلن تواجه المحكمة مشكلة في وصف هذه الحادثة كحادثة عنف. كذلك، إذا اخترق شخص هاتفك الذكي ومسح محتوياته، فربما ينبغي معاقبة الجاني كما لو كان قد تسبب في صدمة في رأسك.
تتعارض أطروحة العقل الممتد كذلك مع دور القانون في حماية المحتوى ووسائل التفكير (أي حماية ما نفكر به من أي تأثير غير مبرر). تحظر القوانين التدخل غير التوافقي في كيميائنا العصبية (على سبيل المثال: المخدرات) لأن ذلك يتداخل مع محتويات عقلنا. لكن إذا كان الإدراك يشمل الأجهزة، فيمكن القول إنه ينبغي إخضاعها لنفس المحظورات. ربما يجب أن تُعَد بعض التقنيات التي يستخدمها المُعلنون لجذب انتباهنا عبر الإنترنت، أو التأثير في قراراتنا، أو التلاعب بنتائج البحث، تدخلات في العملية المعرفية.
بالمثل، في المناطق التي يحمي فيها القانون وسائل التفكير، قد يحتاج الأمر إلى ضمان الوصول إلى أدوات مثل الهواتف الذكية، بنفس الطريقة التي تحمي بها حرية التعبير حق الناس في الكتابة أو التحدث، لكن في هذه الحالة سيكون لدينا الحق في استخدام أجهزة الكمبيوتر ونشر الخطابات عبر الإنترنت.
يمكننا القول إن مفاهيم الحقوق الشخصية والحريات التي تستند إليها مؤسساتنا القانونية قد عفا عليها الزمن، فهي مبنية على نموذج الفرد الحر الذي يتمتع بحياة داخلية لا يمكن المساس بها. بينما الحال الآن أن أفكارنا معرضة للغزو حتى قبل تطويرها. وإن ثبت صحة نظرية العقل الممتد، فحتى أبسط التقنيات ستصبح مستحِقة للحماية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من العقل.