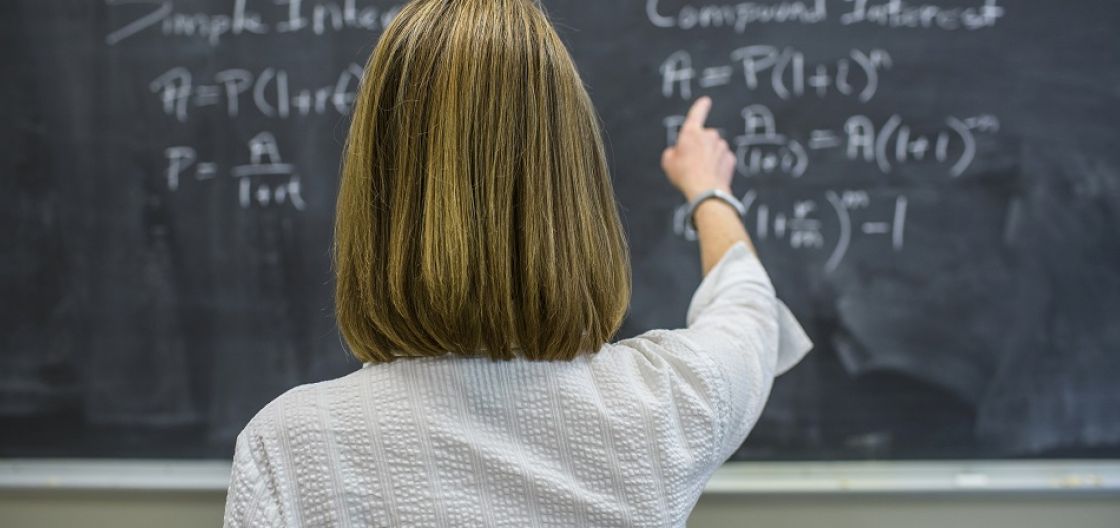فشل علم الاجتماع في التنبؤ بـ«ثورة الحقوق المدنية» التي اندلعت في خمسينيات القرن العشرين وستينياته بالولايات المتحدة الأمريكية، تمامًا مثلما فوجئ باندلاع الصراع العِرقي الذي أدى إلى تأسيس حركة «حياة السود مهمة».
وكما هو الحال دائمًا، افترضت الخطابات المهيمنة على هذا الفرع من العلوم، بشكل يحتاج إلى التدقيق، أن الأمة الأمريكية قد قطعت أشواطًا كبيرة في ما يخص «العلاقات العِرقية»، التي كان أبرزها انتخاب أوباما، «أول رئيس أسود» للولايات المتحدة في عام 2008.
في خطابه الرئاسي لاجتماع «الرابطة الأمريكية لعلم الاجتماع»، الذي صادف يوم «المسيرة التاريخية» في واشنطن عام 1963، طرح «إيفرت هيوز»، عالم الاجتماع الشهير، السؤال الصحيح: «لماذا لم يتنبَّأ باحثو العلوم الاجتماعية، لا سيما السوسيولوجيين، بالحراك الجماعي للأمريكيين السود نحو الاندماج الكامل والفوري في المجتمع الأمريكي؟». عجز هيوز، رغم ذلك، عن تقديم إجابة لسؤاله، ما دفعه إلى التفوُّه بعبارات متحذلقة هربًا من الموقف.
توقع بعض علماء الاجتماع الثورة العرقية التي دوَّى صداها في ستينيات القرن العشرين، أبرزهم «دبليو إي بي دو بوا»، الذي كتب عام 1906: «نسعى إلى تحقيق كل الحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية التي يتمتع بها كل مواطن أمريكي حر، ولن نتوقف أبدًا عن الاحتجاج حتى نحصل على هذه الحقوق».
لم يكن دو بوا وحده، بل كان هناك «كادر» أقلية من العلماء الراديكاليين الذين توقعوا ثورة الحقوق المدنية، تحديدًا بسبب تماثلها مع نموذجهم النظري والسياسي. لكن، مثل دو بوا، نُظِر إليهم باعتبارهم يستعيضون بالسياسية عن العلم، ولذلك جرى تجاهلهم أو تهميشهم.
علم الاجتماع كوسيلة لترسيخ الاستعمار

لعب كتاب «ألدون موريس» الأخير «The Scholar Denied» (الباحث المرفوض) دورًا أساسيًّا في تغيير قواعد اللعبة. إذ يُبطل أسطورة نشأة علم الاجتماع، ويُظهر بما لا يدع مجالًا للشك أن دو بوا هو المنشئ الشرعي لعلم الاجتماع في شيكاغو. كان هدف موريس الأكبر هو تحدي الخطابات المهيمنة في علم الاجتماع، إذ لم تكتفِ هذه الخطابات بإغفال الإسهامات الرائدة والحاسمة لعلماء الاجتماع السود منذ بداية ظهور علم الاجتماع بجامعة شيكاغو في عام 1892، بل قدمت تبريرًا معرفيًّا لهذا التمييز العرقي.
في هذا السياق تُذكِّرنا عالمة الاجتماع الأسترالية «آر كونيل» بأن «علم الاجتماع تشكَّل ضمن إطار الثقافة الإمبريالية، وهو تجسيد لرد الفعل الثقافي للعالم المستعمَر».
يبدو جليًّا، من خلال العدسة النظرية لكونيل، أن علم الاجتماع بعيد كل البعد عما يدَّعيه الباحثون الأوائل من كونه خاليًا من أي تحيزات وتقييمات شخصية، بل هو تجسيد لمنطق الاستعمار، ما قد يصدم «لاوعي» باحثي هذا المجال.
لعقود مضت، كان لا مفر لمن أرادوا نيل درجة الدكتوراه من علماء الاجتماع أن يحفظوا عن ظهر قلب المراحل الأربعة التي نصَّت عليها نظرية دورة العلاقات العرقية، وهي التفاعل والمنافسة والتسكين والاستيعاب، مغفلين الافتراضات الأيديولوجية الكامنة وراء تلك اللغة التي تتظاهر بالبراءة.
ما وراء دورة العلاقات العرقية

على سبيل المثال، تشير مرحلة «التفاعل» في نظرية «روبرت بارك»، أحد الآباء المؤسسين لعلم الاجتماع، إلى «التجمُّعات التي تحدث نتيجة حالات الهجرة أو الغزو»، وهو اختزال خادع للنهب المنظَّم الذي حدث لقارات بأكملها على يد القوى الغربية على مدى قرون، بدءًا بتجارة الرقيق العالمية التي نقلت أكثر من 12 مليون إفريقي إلى العالم الجديد لتوفير الرقيق لاقتصاديات المزارع.
المرحلة الثانية من الدورة، «التنافس»، هي كلمة مُلطَّفة تُخفي وراءها الهيمنة الاستعمارية وتجارة الرقيق، بما في ذلك نظام الاستعمار الداخلي الذي تطور في بلدان استوردت العبيد.
«التسكين» هو المرحلة الثالثة، وتوضح العملية التي يحدث خلالها تعجيز المجموعة المهزومة كي لا تتبنى أي شكل حقيقي من أشكال المقاومة، إذ يجري تطبيع العلاقات بين المُضطهَد والمضطهِدين عبر القانون والعُرف.
أما «الاستيعاب»، وهو المرحلة النهائية عند بارك، فتشير إلى الاندماج التام للمجموعة الخاضعة ثقافيًّا وبيولوجيًّا في المجموعة الأكثر تقدمًا. فكما كتب بارك برصانة: «تموت الأعراق والثقافات، وليس هذا بجديد، لكن الحضارة تعيش على الدوام»، فإنه لم يخبرنا أن هذه الأعراق والثقافات لأناس يملكون حضاراتهم الخاصة. يزف إلينا خبر موت الثقافات وانصهارها في هيكل ما أسماه «الحضارة»، دون انتباه إلى «حضارات» هذه الأمم التي انهارت.
وفقًا لبارك مثلًا، كان انحدار سكان أمريكا الأصليين على يد المستعمرين الأوائل نوعًا من «الاستيعاب» لا أكثر، وفي هذا تحييد لممارسات وحشية استخدمها المستعمِرون لإبادة السكان الأصليين، وإجبارهم على تبني وجهة نظر مستعمريهم.
سوء فهم الباحثين البيض ومراوغتهم بشأن المسائل المتعلقة بالِعرق من أكثر الظواهر العقلية انتشارًا في القرون الماضية.
لذلك كان التقدُّم (أي الحضاري) الهدف المنشود من هذا العلم كما يقول «ألبيون سمول»، وهو أحد مؤسسي قسم علم الاجتماع في جامعة شيكاغو. فالقاعدة الأساسية التي يستند إليها هذا النسق المعرفي أن الاستعمار الخارجي والداخلي جزء من غاية عالمية، لدمج الشعوب الأقل حضارةً في ثقافة ومؤسسات الشعوب الأخرى المتفوقة فطريًّا على «التابعين».
يمكن أن يكون لهذا الطرح فائدة في تفسير أسباب فشل علم الاجتماع في استيعاب حركات الحقوق المدنية الأصغر حجمًا، وقد استمر هذا الفشل في الاستيعاب إلى أن تغير بالقوة على يد التمرد الأسود في الجنوب.
في كتابه «العقد العنصري»، يتحدى «تشارلز ميلز» النمط الاستعماري مرة أخرى، فيتهم «معرفته» اتهامًا واسعًا بأنها عرقية وقائمة على «نسق معرفي جاهل» يدور حول التعتيم لا التنوير: «يمكن للمرء كقاعدة عامة أن يقول إن سوء فهم الباحثين البيض وتحريفهم ومراوغتهم وخداعهم لأنفسهم بشأن المسائل المتعلقة بالعرق، من أكثر الظواهر العقلية انتشارًا في القرون القليلة الماضية، في حين بات الاقتصاد المعرفي والأخلاقي من الوسائل المساعدة على الغزو والاستعمار والاسترقاق».
النتيجة الساخرة، كما يقول ميلز، هي أن «البيض لن يعودوا قادرين على فهم العالم الذي صنعوه بأنفسهم».
خطابات قديمة بلغة جديدة

حركة الاحتجاج الأسود، التي انطلقت منذ بدايات ستينيات القرن العشرين بأشكالها العنيفة والسلمية، وما صاحبها من اضطرابات ألقت المجتمع في أزمات أدت، في بعضها، إلى أعمال شغب واسعة النطاق، أسهمت في التحول من استخدام مصطلح «علاقات العِرق» إلى استخدام آخر أكثر إنصافًا: «القمع العِرقي». كذلك، أُتيحت الفرصة لأول مرة للأصوات الراديكالية والأقليات التي طالما تجاهلوها أو همَّشوها منذ فترة طويلة، لتكون في مركز الخطابَين الأكاديمي والشعبي.
لكن بحلول الثمانينيات، استعاد نموذج العلاقات العرقية هيمنته بعد نصف قرن من الثورة الاجتماعية، وعاد علماء الاجتماع إلى الخطابات التي كانت سائدة قبل 50 عامًا، فاحتفوا بـ«التقدم العرقي»، وحسَّنوا «علاقات العرق»، وعندما واجهوا أوضاعًا تتعارض مع تحليلاتهم الوردية، لجؤوا إلى الاستشهاد بنظرية «ثقافة الفقر» الجدباء (وإن جاء هذا ظاهريًّا في صيغة بلاغية مختلفة)، إضافةً إلى اللجوء لأشكال جديدة من خطابات «إلقاء اللوم على الضحية» كالتي سادت قبل ثورة الحقوق المدنية.
المال وقود عجلة الأكاديمية، وبالتالي مَن يسيطرون عليه يصممون الإنتاج المعرفي.
يبقى السؤال الأهم: كيف يمكننا أن نفسر هيمنة بعض الأفكار؟
للإجابة عن هذا السؤال يتعيَّن علينا ألا نكتفي بدراسة الطرق الدقيقة التي يعيد بها علماء الاجتماع إنتاج التمييز الاجتماعي في أروقة الجامعات، سواء كان ذلك بشكل واعٍ أو غير واع، أو حتى داخل «جمعية علم الاجتماع الأمريكية».
رغم أهمية هذه القضية، فإن القضية الأكبر تتعلق بهياكل وديناميات إنتاج المعرفة. ويجدر بنا أن ندرس آلية الهيمنة، والآليات الدقيقة التي تُحجَب عن طريقها الأفكار وتتكون الشرائع.
يتطلب ذلك أن نُخضِع المؤسسة الاجتماعية للعين الناقدة التي تحدَّث عنها «سي رايت ميلز» في كتابه «The Power Elite» (نخبة السلطة)، والتي تبدأ بكليات النخبة التي تمتلك المفاتيح السحرية لمختلف الوظائف، وتفتح الأبواب لدور النشر المرموقة والصحف الرائدة، وتساعد في الحصول على المنح من المؤسسات والوكالات الحكومية. بدورها، تسمح هذه المنح لأصحاب المشروعات بتشكيل «المدارس» و«فِرَق الأحلام» التي تنشر نظرياتهم المحببة للباحثين الجدد.
لا يخفَى على أحد أن المال وقود عجلة الأكاديمية، ما يعني أن من يسيطرون على تلك القوة يصممون الإنتاج المعرفي، تمامًا مثل لجان التحكيم في الصحف الأكاديمية، والجهات المانحة التي تعمل على فرض الامتثال الأيديولوجي، عن طريق رفض من يتحدُّون الخطابات السائدة بقوة. وفي الوقت نفسه تخلق الجمعيات المهنية، التي غالبًا ما تشبه المجتمعات الأخوية، نظامًا قائمًا على المكافآت، فتمنح ألقاب شرف وجوائز ووظائف سخيَّة، مع هالة لا غِنى عنها لإضفاء الشرعية.
لا يمكننا إنكار وجود قسط من التسامح مع وجهات النظر المغايرة في تلك المؤسسات، والسبب وراء ذلك هو الإبقاء على أسطورة الجامعات الليبرالية باعتبارها معقل التنوع والمعارضة. لكن المسألة الرئيسية هنا هي: أيُّ الآراء يسود في النهاية، وأيُّها يتلقى الدعم المادي؟ أيُّها يصبح طوباويًّا؟ وقبل كل ذلك، أيُّها يُعد الأكثر تأثيرًا في الحياة السياسية والسياسات العامة؟
يمكننا القول إن الاختبار الحقيقي للنقد الذاتي لهذه العلوم لا يعتمد على إحصاء عدد النقاشات، بل على كَمِّ التقدم الحقيقي الذي أُحرز في قضية العدالة العرقية، فضلًا عن خلق علوم اجتماعية من شأنها أن تصمد لتفي بوعدها التحرري.