يُعدّ الحديث عن «عودة الدين» واحدًا من أهم التيمات الاجتماعية والثقافية في عالم اليوم، وأُفردت له عديدٌ من الدراسات والأبحاث من قبل علماء الاجتماع والمفكرين والفلاسفة.
فمنذ منتصف السبعينيات من القرن الماضي بدا لكثيرين أن الدين قادر على لعب أدوار أكبر بكثير مما كان متوقعًا، وتعزز هذا الانطباع بعد الثورة الإيرانية، والقدرة المدهشة التي أبداها رجل دين مثل الخُميني على حشد وتحريك كتل بشرية هائلة لتحقيق رؤاه الاجتماعية والسياسية، لدرجة أن مفكرًا نقديًا شهيرًا مثل ميشيل فوكو، الذي زار إيران آنذاك، تحدث عن «السياسة الروحية» للخميني بعبارات شِبه شعرية، تنافي منهجه المتشكك بالطوباوية عمومًا، فبدا للبعض أشبه بنصير متحمس ساذج لحكم الملالي.
في عام انتصار الثورة الإيرانية نفسه جاءت زيارة البابا يوحنا بولس الثاني لبولندا، التي كانت إشارة واضحة على الدور الذي سيلعبه الدين في تحطيم المنظومة الاشتراكية. وفي الآن ذاته كانت «الصحوة الإسلامية» تجتاح العالم العربي والدول الإسلامية.
قد يهمك أيضًا: ماذا تبقى من الصحوة الإسلامية؟
أكمل صعود المسيحيين الإنجيليين في الولايات المتحدة في الثمانينيات والتسعينيات، والمجاهدين الإسلاميين في أفغانستان وباكستان ومصر والجزائر، الصورة الكبيرة لـ«عودة الدين»، إلا أن هذه «العودة» التي شهدتها العقود الأخيرة من القرن الماضي أثارت العديد من التساؤلات، وخضعت لدراسة دقيقة بعد أن هدأت اندفاعاتها الأولى: هل ما عاد حقًا هو الدين؟ هل تتوافق الأصولية مع الأنماط التاريخية والاجتماعية المعروفة للتدين؟ هل ما يحدث هو ارتفاع مفاجئ في منسوب الإيمان لدى الناس؟
تبدو الإجابة عن هذه الأسئلة صعبة بعض الشيء، فهي تستلزم أولًا إيجاد تعريفات متفق عليها لـ«الدين» و«الإيمان» و«الأصولية»، وهو أمر متعذر في العلوم الاجتماعية التي لم تضبط مصطلحاتها ومفاهيمها بشكل كافٍ كما فعلت العلوم الطبيعية. ورغم ذلك سنحاول البحث عن بعض الإجابات لدى عدد من أهم المفكرين المعاصرين الذين تناولوا قضية الدين بشكل أكثر تعمقًا.
يورغن هابرماس: ما بعد العلمانية

في الفصل الخامس من كتابه «بين النزعة الطبيعية والدين» الصادر عام 2008، يبدو الفيلسوف الألماني الأكثر شهرة، يورغن هابرماس، شديد الاهتمام بالظاهرة الدينية، فبعد عقود طويلة قضاها في الدفاع عن مشروع الحداثة ضد الهجمات ما بعد الحداثية، يستعمل هابرماس لغة أكثر تفهمًا في الحديث عن ظاهرة «عودة الدين»، وهو الميل الذي كان قد تعزز لديه بقوة، خاصة بعد حواره الشهير مع جوزيف راتسينغر، الذي صار فيما بعد البابا بندكت السادس عشر، وتصريحاته المثيرة للجدل عن المسيحية ودورها في الحضارة الغربية وتشكيل مبادئ حقوق الإنسان.
يبدأ هابرماس فصله هذا بالحديث عن عودة الدين في آسيا وأفريقيا والعالم العربي، ويحاول ربط هذه الظاهرة بالنزاعات الإثنية والعرقية وردة الفعل على «الجراح التي خلفها الاستعمار الغربي». وهو إذ يبدو واعيًا بـ«الاستثناء الأوروبي»، حيث توجد بيانات إحصائية تؤكد تراجع دور الدين وتزايد نسب الملحدين واللادينيين، فهو يؤكد على أن الولايات المتحدة، المجتمع الصناعي الأكبر، تشهد بدورها نهوضًا متزايدًا للعامل الديني.
يخلص هابرماس، من خلال نقاش أطروحة الفيلسوف الأمريكي جون رولز عن «الاستخدام العمومي للعقل وأخلاق المواطنة»، والاعتراضات التي أثيرت عليها، إلى تطوير مفهومه الخاص عن دور الدين في الفضاء العمومي، فإقصاء الدين والمتدينين برأيه لم يعد ممكنًا، وهو منافٍ لنظريته عن الفعل التواصلي، وبالتالي فنحن نعيش اليوم في عصر ما بعد علماني، يحق للجميع فيه، متدينين وغير متدينين، أن يعبّروا عن أنفسهم بحرية.
على العلمانيين من جهتهم أن يكونوا أكثر تسامحًا مع الخطاب الديني، وأن يكفوا عن انتظار زوال الدين من الحيز العمومي. ويعترفوا بـ«الحقيقة المحتملة» التي قد يحملها الخطاب الديني، ويساعدوا المؤمنين على «ترجمة» هذه الحقيقة.
إجابة هابرماس الإجابة الكلاسيكية على تحدي «عودة الدين»، رغم أنها قوبلت بمراجعات نقدية قوية، لعل أهمها ما كتبه الفيلسوف الإيطالي فلوريس داركيس، إلا أنها بقيت عنصرًا أساسيًا في أي نقاش عن المدى المسموح للحضور الديني في الحيز العام.
إلا أن هابرماس، بوصفه فيلسوفًا، لم يعن كثيرًا بتقصي طبيعة «عودة الدين»، واعتبرها معطى جاهزًا يمكن البناء على نتائجه دون تمحيص اجتماعي وثقافي. لهذا تبدو طروحاته غير كافية للإجابة عن الأسئلة الأعمق التي تطرحها المسألة الدينية المعاصرة.
قد يعجبك أيضًا: تجديد الدين في تونس: 200 عام من التفكير
مارسيل غوشيه: الخروج من الدين

لا يعتقد المفكر الفرنسي مارسيل غوشيه أن الدين قد عاد حقًا، أو أن الناس عادوا للإيمان من جديد بعد أن تخلوا عن ايمانهم بسبب الحداثة، بل هو لا يعتقد أصلًا أن الناس كانوا يؤمنون بالله في العصور الوسطى أكثر من إيمانهم به في العصر الحديث، فالدين بالنسبة لغوشيه لا يحدده سؤال الإيمان بقدر ما يحدده سؤال الموقع الاجتماعي للدين وأهميته في تنظيم حياة البشر وروابطهم الاجتماعية، فهي من يخلق الإيمان وليس العكس.
في دراسة له عن المعتقدات الدينية والمعتقدات السياسية، يعرّف غوشيه الشكل الكلاسيكي للدين كما يلي: «كان الدين، في البداية وإلى عهد قريب، طريقة وجود، شكلًا لانتظام المجتمعات البشرية (..) في هذا الإطار يشمل المعتقد الديني التنظيم الاجتماعي، إنه الاعتقاد في الآخر ما فوق الطبيعي الذي يعطي القانون المشترك لما هناك ولما هو تحت (..) لا شأن لنا بانتظام العالم الذي نعيش فيه، فهو معطى لنا ومفروض علينا من جهة متعالية (..) نحن نتقبل النظام الذي يشدنا إلى بعضنا بعضًا، وعلينا أن نتقبله كما تلقيناه، بهذا المعنى تكون مجتمعات الدين مجتمعات تقليدية».
هذا الدين ولَّى دون رجعة، ومجتمعاته باتت من الماضي، ليس فقط في «العالم المتقدم»، بل في معظم أنحاء العالم. في الغرب مكّن تحويل المسيحية إلى أيديولوجيا سياسية إلى حالة «الخروج من الدين»، والتي لا تعني نهاية الدين، وإنما أن الدين لم يعد العامل الأساسي في التنظيم الاجتماعي، فقد نشأ الحيز السياسي المستقل الذي لا يعتبر الدين فيه إلا وجهة نظر، متساوية من حيث القيمة مع بقية وجهات النظر غير الدينية.
المجتمعات لم تعد محكومة بـ«الآخر المتعالي» ولم يعد من الممكن أن تُحكم به. والمجتمعات التقليدية التي ينتجها الدين لم تعد موجودة، ما الذي عاد إذًا مع «عودة الدين»؟
في بلدان العالم الثالث مبدأ التحاور بين مختلف الهويات والرؤى السياسية لم يصبح معترف به لغياب الحيز السياسي العام، ولذلك فإن مختلف الأطراف، تحاول فرض تصوراتها على الآخرين.
في كتابه «الدين في الديمقراطية» الذي يُعنى أساسًا بدراسة الحالة الفرنسية، يرى غوشيه أن ما يعود هو الهوية وليس الدين، والمجتمعات الديمقراطية تتجه من توحيد المواطنين ضمن متحد سياسي إلى «التعددية». أي وجود مجموعات بشرية ضمن الإطار العام للدولة تتمايز هوياتيًا، سواء كان هذا التمايز قائمًا على الدين أو العرق أو الجنس أو الميل الجنسي.
هذا التمايز ليس «عودة للدين» بل هو مكمل لـ«الخروج من الدين»، فميل الناس إلى إعادة إنتاج رموز ثقافية لا يعني أنهم أعادوا بناء مجتمعات الدين القديمة، بل هم حولوا معتقداتهم إلى هويات، ويعيشون ضمن حالة اجتماعية تُقر بشكل مبدئي بالمتحد السياسي الدنيوي الذي ينظم علاقات جميع «الهويات» دون أن تطغى إحداها على الأخرى. الاعتراف بهوية الآخر هنا هو شرط مبدأي للاعتراف بالهوية الذاتية، وبالتالي فلا يوجد دين ناظم للرابطة الاجتماعية ولا يمكن أن يوجد، وإلا ستنهار بنية التعدد الهوياتي من أساسها.
تسعى الهويات المتجاورة إلى كسب «اعتراف» الدولة، وتطالب بإعطائها مساحة لتمارس فيها تصوراتها عن ذاتها، بما يكسبها وجودًا «موضوعيًا» في أعين أفرادها. إلا أن هذا «الوجود الموضوعي» لا يعني أنها باتت قادرة على تحديد مصائر أفرادها بشكل تام، فلا وجود لأي حيز قادر على ضبط الأفراد بشكل متعالٍ كما كان سائدًا في عصر الدين.
يمكننا أن نضيف هنا أنه حتى في بلدان العالم الثالث، التي يحاول فيها الأصوليون فرض تصوراتهم الدينية والهوياتية على الآخرين، لا يتعلق الأمر بعودة الدين بقدر ما يتعلق بغياب المنظومة الديمقراطية، فمبدأ التجاور بين مختلف الهويات والرؤى السياسية لم يصبح مبدأ معترفًا به لغياب الحيز السياسي العام، ولذلك فإن مختلف الأطراف، دينية كانت أم علمانية أم قومية، تحاول فرض تصوراتها على الآخرين.
نظرة حول النزاع على قانون التجديف في باكستان مثلًا، تبين أن أكثر المتضررين منه هم أبناء الأقليات العرقية والدينية والفئات الأكثر فقرًا، وهو يؤمِّن هيمنة وتسلط فئة معينة من الباكستانيين على الحيز العام، أكثر من سعيه لفرض الإيمان على الناس. فحتى في باكستان تضمحل مجتمعات الدين التقليدية مع تقدم عملية التمدين وتوسع الفئات الوسطى.
بكل الأحوال يبدو غوشيه أكثر دقة من هابرماس في تعاطيه مع مفهوم «الدين»، ولكنه ليس واضحًا تمامًا في تحديد آليات تحول المعتقد إلى هوية، وعلاقة كل هذا بالمفهوم العام للثقافة.
قد يهمك أيضًا: هكذا وجد العلماء الله في مخ الإنسان
أولفييه روا: الجَهلُ المُقدّسُ
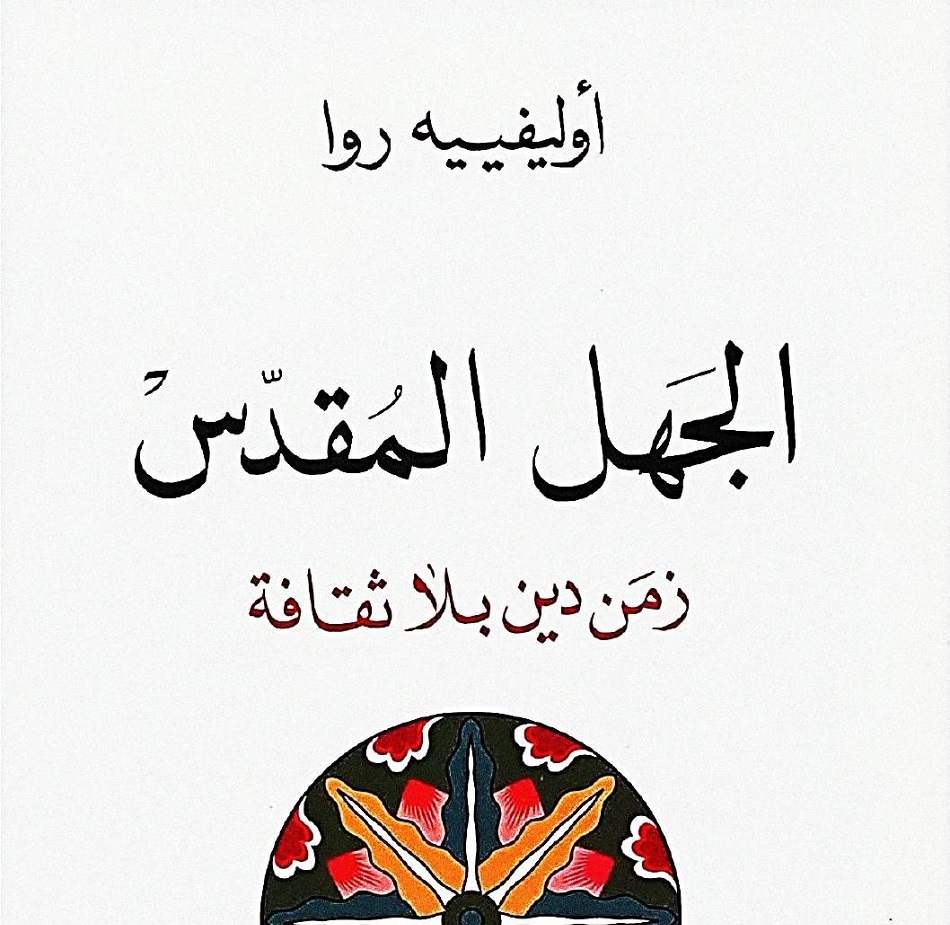
اشتهر الباحث الفرنسي، أولفييه روا، بدراساته عن الإسلام السياسي المعاصر، إلا أنه في كتابه «الجهل المقدس» يتجاوز حدود اختصاصه الدقيق، ويقدم رؤية شاملة لعلاقة الديني بالثقافي ضمن سياقات العولمة وتفكك البنى التقليدية، الاجتماعية منها والدولتية. ويدعم رؤاه ببيانات وإحصائيات وأمثلة كثيرة، مما يجعل أسلوبه أكثر تخصصية ودقة في معالجة الظاهرة. وهو الأمر الذي يميزه عن الأسلوب النظري الذي يطبع كتابات هابرماس وغوشيه، ومعظم كتّاب ما يعرف في الفكر الغربي بـ«النظرية».
لاحظ «أولفييه روا» نشأة سوق دينية عالمية، فيها مليارات المستهلكين القادرين على الوصول إلى السلعة الدينية، واستهلاكها كأي سلعة أخرى، ثم رميها أو التخلص منها إذا أرادوا.
يتحدث «روا» كما هو وارد في العنوان الفرعي لكتابه عن «زمن دين بلا ثقافة»، فقد نجحت عملية العلمنة بشكل كامل، ليس فقط في الغرب، ولكن في معظم أنحاء العالم، والمقصود بالعلمنة هنا ليس العلاقات القانونية والدستورية للدول، فنموذج الدولة الدينية ما زال سائدًا في الكثير من بقاع الأرض، بل عملية إعطاء المجال الديني استقلاليته الخاصة، فهو لم يعد الناظم الوحيد للعلاقات الاجتماعية والسياسية، ولم يعد متداخلًا بشكل لا يمكن فصله عن بقية مناحي الحياة، بل صار ميدانًا خاصًا قادرًا على التحرك بحرية دون الارتباط بشكل لازم بروابط الثقافة والإقليم والبيئة.
عملية العلمنة إذًا ألغت الروابط الضرورية بين الدين والثقافة، وصار بالإمكان تصدير الأديان لتتجاوز الحدود السياسية والعرقية واللغوية والثقافية، بالتناغم مع العولمة وتسليع المنتجات غير المادية. «عودة الدين» بهذا المعنى ليست بسبب فشل أو تراجع التحديث والعلمنة بل بسبب نجاحهما الكامل. وإذا أردنا الدقة فإن ما عاد ليس هو الدين بل «السلعة الدينية».
اقرأ أيضًا: الإسلام والعلامات التجارية: نبيع ونشتري كل شيء
من خلال بحث عمليات الاعتناق الفردية والجماعية للدين وحالات التحول الديني، يلاحظ «روا» نشأة سوق دينية عالمية، فيها مليارات المستهلكين القادرين على الوصول إلى السلعة الدينية بحرية نسبية، واستهلاكها كأي سلعة أخرى، ثم رميها أو التخلص منها إذا أرادوا.
لا يقوم الاستهلاك الديني على معرفة ضرورية بالثقافة التي أنتجت الدين، أو حتى بتفاصيل اللاهوت الديني، المهم هو التجربة الفردية والبنية الرمزية للدين. هذا «الجهل المقدس» هو شرط لازم لحرية استهلاك الدين وسهولة انتشاره.
يؤكد «روا» على أن التناقض بين الديني والثقافي قديم، فكل دين عالمي أكد مع ظهوره أنه يريد تخليص المؤمنين من المظاهر السلبية المرتبطة بثقافتهم، وتحريرهم في فضاء الإيمان من كل حتمية ثقافية. يمكن كمثال هنا أن نورد علاقة الإسلام بالثقافة القبلية العربية، أو علاقة البوذية عند نشوئها بطقوس البراهمة. ورغم كل هذا فإن الأديان العالمية القديمة سرعان ما امتزجت مع الثقافات المحلية، وساهمت في تطويرها، في حين ساهمت الثقافات بدورها في تطوير الأديان أو «تحريفها» كما يرى المؤمنون.
في عصر «الجهل المقدس» لا يبدو أن عملية التمازج بين الديني والثقافي تجري بسلاسة، فحلول الديني في الثقافي سيؤدي كما قلنا إلى فقدان الأديان المعولمة لحريتها في تصدير نفسها، ولذلك فإن الأصولية، باعتبارها شكلًا دينيًا يحتقر الثقافات الإنسانية و«البدع» التي أضافتها للأديان، هي الشكل الأكثر قدرة على الانتشار، والأكثر قابلية للتصدير.
ترتبط هذه العملية بالتفكك الشامل للبنى التقليدية، سواء البنى الاجتماعية التقليدية كالعائلة والعشيرة، والحداثية كالنقابة والحزب السياسي، أو البنى الدولتية المرتبطة بنموذج الدولة الوطنية. هنا يمكننا أن نربط «الجهل المقدس» بسياسات الهوية والتعددية الثقافية اللتين صعدتا بقوة في عصر العولمة مع تفكك تلك البنى.
ما يحصل هو استبدال الثقافة بالرمز المسلّع، فبدلًا من أن تكون الديمقراطية المعولمة و«التعددية الثقافية» مجالًا للتطور والترابط الثقافي الحر، تصبح تركيبًا لاختزالات ثقافية ضحلة، فتُستبدل الثقافة الإسلامية مثلًا برمز مختزل كالحجاب، والثقافات الآسيوية ببعض البخور والعمائم والتماثيل غير المتقنة.
إنها الفيتشية الثقافية (والكلام هنا ليس لروا) التي تجعل علامات سطحية فيتشًا للتعددية والهوية، واذا استعدنا كلام ماركس عن فيتشية السلع، فإن الرموز الثقافية والدينية بعد تسليعها باتت في عصرنا الفيتش الرأسمالي الجديد.
مارك ليلا: لعبة «الكو كلوكس كلان» المخيفة

أول حركة معروفة لـ«سياسات هوية» في أمريكا هي تنظيم «الكو كلوكس كلان» العنصري العنيف.
رأينا أن «عودة الدين» وصعود الأصولية ما هما إلا شكل من أشكال سياسات الهوية، ولذلك تكتسب في هذا السياق مقالة المفكر الأمريكي مارك ليلا «نهاية ليبرالية الهوية» أهمية كبيرة.
في هذه المقالة الشهيرة التي نشرت في جريدة «نيويورك تايمز» بعد نجاح دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية، يتحدث «ليلا» عن سياسات الهوية الليبرالية الأمريكية القائمة على «الاحتفال بالاختلاف»، والتي أدت إلى انتشار نوع من «الذعر الأخلاقي» حول العرق والجنس والدين والهوية الجنسية. وتشجيع الأطفال في النظام التعليمي على الاحتفاء بهويتهم قبل أن تتشكل لديهم هوية أصلًا.
هذه السياسات برأي «ليلا» أدت لنتائج كارثية على النظام الديمقراطي في البلاد، فالتركيز على ما يفرّق البشر بدلًا مما يوحدهم أدى إلى شيوع الانقسام الاجتماعي وتخريب الحيز العام، ما يجعل أي نقاش عقلاني أو «استعمال عمومي للعقل»، إذا استخدمنا مصطلحات كانط ورولز، شبه مستحيل.
هنا كان لخطابات هيلاري كلينتون عن «تحالف الأقليات» وتضامن «السود والنساء والمسلمين» تأثير كارثي، فهي استبعدت سلفًا قطاعًا واسعًا من المواطنين، ما يجعل ردات فعلهم ضد الخطاب الليبرالي مشروعة، دعك من أن نسب انتخاب السود واللاتينيين المرتفعة نسبيًا لترامب تثبت خطل خطاب «الأقليات» هذا. فأفراد «الهويات» لا يتصرفون بوصفهم كتلة متجانسة، ولهم خياراتهم السياسية والفردية المستقلة.
قد يهمك أيضًا: عودة الحركات العنصرية في أمريكا
ينبّه «ليلا» إلى أن أول حركة معروفة لـ«سياسات هوية» في أمريكا هي تنظيم «الكو كلوكس كلان» العنصري العنيف، ومن يريد أن يلعب في ملعب سياسات الهوية، كما يفعل الليبراليون، عليه أن لا يندهش إذا تفوق عليه اليمينيون، فهذا الملعب هو ملعبهم التاريخي.
يدعو الكاتب الأمريكي في النهاية إلى ليبرالية متجاوزة للهوية تركز على النقاط المشتركة التي توحد الناس، بدل التركيز على ما يفرقهم، والعودة إلى مبدأ أن كل المواطنين، على اختلاف هوياتهم، هم أعضاء في متحد سياسي عام ولديهم مصالح مشتركة، وهذا هو الأسلوب الوحيد لإنتاج سياسية ليبرالية جدّية.
يبدو «ليلا» هنا أكثر جذرية من هابرماس وغوشيه، اللذين نظّرا للتصالح مع صعود النزعة الهوياتية والأصولية، فالتركيز على الخطاب الجامع وإعادة الاعتبار للمتحد الوطني ولفكرة المواطن، تبدو الوصفة الأنسب لمواجهة الاضطراب والانقسام الاجتماعي الكبير الذي تثيره «عودة الدين» وسياسات الهوية.
إلا أن هذه الوصفة قد تواجه باعتراضات قوية:
أولها هو مدى واقعيتها، فهل من الممكن في عصر العولمة وتفكك البنى الاجتماعية والدولتية الحديثة، وصعود سياسات الهوية لأسباب موضوعية (كما رأينا لدى روا) الحديث من جديد عن متحدات وطنية؟
وثانيها هو مدى ديمقراطيتها، فهل قمع النزعات الهوياتية لدى الناس سيسهم في إنتاج فعل تواصلي صحيح من النوع الذي يدعو إليه هابرماس؟
لا يمكننا أن نقدم إجابات حاسمة على هذين السؤالين، ولكن الاعتراف بعوامل موضوعية لسياسات الهوية لا يجب أن يعني الاستسلام الحتمي لها، كما أن العولمة لا تحمل بذاتها مسارات حتمية للتطور الاجتماعي. والتاريخ، كما علمنا فشل كل فلسفات التاريخ، قائم على الإمكانية وليس الحتمية، وبالتالي فربما تكون إعادة إنتاج الخطاب الوطني الجامع إمكانية معقولة ضمن تنوع الإمكانيات التي يطرحها العالم المعاصر، بل ربما تكون استعادة خطاب التنوير ضرورة من الضرورات التي تطرحها العولمة نفسه، ووجهًا من وجوه تطورها.
من ناحية أخرى فإن محاربة النزعات الهوياتية لا تعني قمع البشر بالضرورة، بقدر ما قد تكون مساهمة بفتح إمكانيات جديدة لهم للخروج من شمولية وتناقضات سياسات الهوية.
بكل الأحوال، يجب التركيز على أن تقديم أطروحات مثل «ما بعد العلمانية» و«التعددية الثقافية» بوصفها حتميات تاريخية، من يرفضها سيذهب حتمًا إلى مزبلة التاريخ الشهيرة، هو شكل من أشكال التاريخانية، ويتطابق تمامًا مع تعسفية وأحادية السرديات الشمولية الكبرى، التي من المفترض أن تلك الأطروحات ظهرت لتجاوزها.
حالة التعسف الفكري التي تفرضها هيمنة الخطاب الليبرالي- اليساري الهوياتي على جانب كبير من الحيز العام، تُبيّن بوضوح أن التخلص من الأنساق الأيديولوجية متعذر حتى لدى ليبرالية تدعي أنها «ما بعد أيديولوجية»، وأننا بالتأكيد لم نصل إلى «التعددية» التي طالما بُشّرنا بها.




