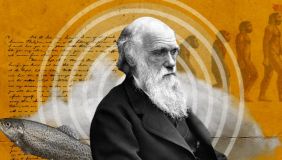في 2010، كنت أجلس في غرفتي أقرأ رواية تتألف مما يزيد عن 800 صفحة لـ«فيودور دوستويفسكي». لم يُرهبني طول الرواية، ولا حاجتي لأن أعيد قراءة مقاطعها مرات عدة كي أستوعبها تمامًا.
كنت أُنهيها هي وكتب مشابهة في أربعة أيام أو أكثر، وكنت أدون ملاحظاتي عنها وأحتفظ في مذكراتي بالاقتباسات التي نالت إعجابي.
مع كل كتاب أُنهيه كان شيء ما ينمو بداخلي، شعور بالإنجاز يقترن أحيانًا بالفخر. لم أقرأ أهم كتب دوستويفسكي فقط، بل شعرت بالانتماء إلى شخصياتها، وربما إلى الكاتب نفسه أيضًا.
كنت في الثامنة عشرة من عمري عندما تعرَّفت إلى فيسبوك لأول مرة. وفَّر لي مساحة هائلة لمشاركة كل تلك الملاحظات والاقتباسات والأغنيات التي ظلت حبيسة دماغي، وظننت أن أحدًا لا يعرفها سواي.
30 منشورًا أو أكثر يوميًّا على صفحتي، وصديقة وحيدة تُعلق على هذه المنشورات، ربما رغبةً في تجنيبي الحرج.
عالم محدود في بداياته، ولا نهاية له الآن. الحساب صار أكثر ازدحامًا بالأصدقاء والغرباء، ربما حان الوقت لأشارك معهم القصيدة التي كتبتها، وربما قصيدة ثانية وثالثة، ربما أنا كاتبة بالفعل.
كتب دوستويفسكي مركونة على الرف، ضخمة وصامتة ووحيدة. صرت لا أستطيع التخيل أن يقوى أحدهم على قراءة كتاب يزيد عن مئتي صفحة. كيف فعلتُها من قبل؟
أقضي ساعات طويلة أيضًا في القراءة على مواقع السوشيال ميديا، لكني لم أعد أشعر لا بالفخر ولا الإنجاز.
أُشاهِد فيلمًا أحبه أو أعود من تجمُّع لطيف مع أصدقائي، أشعر بالرغبة في التوثيق. لكن حدثًا مهمًّا يتشاركه أصدقائي الافتراضيون يُرغمني إما على تأجيل حماسي الشخصي إلى وقت مناسب، وإما تناسيه تمامًا والاستغراق في حدث مؤسف في ظروف أخرى لم أكن أُلقي لها بالًا.
لوكانت لديَّ خلفية مسبَقة عن الحدث، أُشارِك في الحديث عنه بكلمات مقتضبة، وإن لم تكن لدي معلومات كافية، أشعر بضرورة أن أكتسب فكرة، ولو بسيطة، من خلال قراءة مقال أو أكثر.
أعبر الترند بسلام ومعي حصيلة معلومات قد أنساها مباشرة بعد انتهائه. في أثناء ذلك، يتسرب إلى نفسي شعور يُثقِل قلبي ولا أدري له سببًا.
يسمونه «اكتئاب السوشيال ميديا»، لعنة جيلي والأجيال الأصغر مني كما تذكر معظم المقالات التي قرأتها بخصوص هذا الشأن. هل الهجوم على مواقع وسائل التواصل الاجتماعي مُبرَّر وعادل، أم إنها مجرد رد فعل بها قدر كبير من مبالغة الأجيال الأكبر سنًّا؟
إذا كانت وسائل التواصل الاجتماعي بريئة مما نعاني منه الآن، فماذا حدث لنا إذًا؟ وكيف يمكننا أن نتعامل مع واقعنا الجديد كأنه حلم يجدر بنا أن نستيقظ منه في نفس اللحظة؟
فقدان جماعي للذاكرة
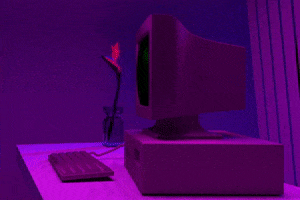
لكل مجتمع وثقافة تجربة مختلفة مع مواقع السوشيال ميديا، وأسباب مختلفة لاستخدامها. هذه الاختلافات موجودة أيضًا بين أفراد المجتمع الواحد، لكن تظل النتيجة النهائية واحدة في الغالب.
إدمان وسائل التواصل يقارب خطورة إدمان السجائر أو الكحول، وربما يصير أخطر.
في دراسة نُشرت على موقع «The Economist»، أعدَّها باحثون من «الجمعية الملكية للصحة العامة» في بريطانيا، لوحظ أنه خلال الـ25 سنة الأخيرة، زادت معدلات أمراض القلق والاكتئاب بين الشباب بنسبة 70%.
يؤكد معظم الشباب الذين شاركوا في الدراسة أن استخدامهم أربعة أو خمسة من أبرز مواقع التواصل الاجتماعي تسبب في زيادة نوبات قلقهم واكتئابهم.
تورد الدراسة أن 91% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا في بريطانيا يستخدمون الإنترنت من أجل مواقع التواصل الاجتماعي فقط، وتقل النسبة تدريجيًّا وصولًا إلى الفئة العمرية من 55 إلى 64 عامًا، الذين يستخدمون مواقع التواصل بنسبة 55%، وأخيرًا بنسبة 23% لمن تزيد أعمارهم عن 68 عامًا.
صلاح شاب عمره 30 عامًا، يحكي لـ«منشور» أنه تعرَّف إلى مواقع التواصل لأول مرة عام 2006: «لا أذكر أنها كانت سببًا مباشرًا في اكتئابي، لكن معدل استخدامي إياها كان يزداد مع سوء حالتي النفسية. مؤخرًا وجدت أن اللون الأزرق لفيسبوك يرتبط شرطيًّا عندي بالشعور بالفشل وقلة الإنتاج، لذلك توقفت عن قراءة المقالات المنشورة فيه، ووجدت وسيطًا أكثر مناسبة لي».
يتلاشى شعور الإنسان بالوقت في أثناء تصفحه هذه المواقع، ربما لأنها مصمَّمة بدقة لجذب مستخدميها لقضاء وقت أطول عليها. لفتُ انتباه المستخدم وجذبه للبقاء أطول فترة يمكن أن يتسبب، في بعض الحالات، في إدمان تصفح هذه المواقع.
بحسب الدراسة السابقة، يقارب إدمان وسائل التواصل خطورة إدمان السجائر أو الكحول، لكنه ربما يصير أخطر.
نحن نعترف رسميًّا بأنواع الإدمان السابقة، ومن السهل العثور على شبكات دعم للمدمنين عليها، ويمكن أن ينسحب المرء من المجتمعات الصغيرة التي شاركته هذه العادات الضارة، وينضم إلى مجتمعات أخرى صغيرة من المتعافين أمثاله.
أما إدمان وسائل التواصل فلا يجري التعامل معه بهذه الجدية، والانسحاب التام من تلك المواقع قد يزيد من اكتئاب أفرادها وشعورهم بالعزلة، خصوصًا في الفئات العمرية من 16 إلى منتصف الثلاثينات.
أطفال ومراهقون وشباب كثيرون لم يعرفوا شكلًا للعالم قبل هيمنة وسائل التواصل عليه. لذلك، فانسحاب أحدهم من هذه المواقع بمثابة انتحار إلكتروني. تلاشت الحدود بين العالم الحقيقي والأونلاين، وأصبح من الصعب التمييز بينهما.
التنمر الإلكتروني

على مواقع التواصل، يواجه الناس تحديات تشبه التي يواجهونها على أرض الواقع، وتختلف طرق تعاملهم مع هذه التحديات ودرجة تأثرهم بها. لكن الفارق بين تحديات كلٍّ من الواقع والواقع الافتراضي أننا يمكن أن نهرب من الأول بعض الوقت، بينما يصعب علينا الهروب من الثاني.
الأطفال الذين يعانون من التنمر المدرسي على سبيل المثال، كان بإمكانهم من قبل أن يحظوا بساعات من السلام بعد عودتهم من المدرسة، بعيدين عن الخطر الذي يعرضهم إليه بعض زملائهم، وقد يصل ببعضهم إلى أن ينتقل إلى مدرسة أخرى ويبدأ من جديد.
أما الآن، فقد ظهرت صورة أكثر خطورة من التنمر تُعرَف بـ«التنمر الإلكتروني» أو «البلطجة الإلكترونية»، تتيح للمتنمرين ملاحقة ضحاياهم على مدار 24 ساعة، ونشر صورهم أو معلوماتهم في الفضاء الإلكتروني، ما يجعل وجوههم مألوفة، ليس فقط في المدرسة أو المدينة التي يسكنون فيها، بل على نطاق أوسع، يجعلهم محاصَرين وخائفين ويشعرون بالإذلال.
كثيرًا ما يؤدي التنمر الإلكتروني إلى انتحار الضحايا، خصوصًا بين المراهقين ممن يفتقدون دعم الأبوين وتوجيههم.
لم تعد تُقارَن فقط بابن خالتك
في معظم الوقت، لا ينبع شعورك بالغيرة أو الحسد من محاولات الآخرين للتباهي، بل من شعورك بالتقصير.
إذا كان اختيارك ألا يكون حسابك الشخصي مُقتصرًا على العائلة وأصدقائك المقربين فقط، حتمًا ستتعرَّف إلى مئات، وفي أحيان آلاف من الشباب من نفس الفئة العمرية التي تنتمي إليها، أو من فئة عمرية مقاربة.
ستتعرَّف بدقة إلى تفاصيل حياتهم اليومية وإنجازاتهم وأساليبهم في التعامل مع الفشل.
فجأة، تبدو إنجازاتك ضئيلة ولس لها معنى. ستجلد ذاتك، وإن لم تفعل، قد يتطوع أحدهم ويؤدي المهمة بدلًا منك.
يدرك جيلنا أكثر من أي جيل أن البشر مختلفون، وما يناسب أحدهم لا يناسب الآخر. لكن بعضهم لا يتورع عن سحق الآخر الذي يستغرق وقتًا أطول في تحقيق إنجاز ما أو فهم درس حياتي يبدو بدهيًّا وسهلًا.
المشكلة الأساسية أنه في معظم الوقت لا ينبع شعورك بالغيرة أو الحسد من محاولات الآخرين للتباهي، بل من شعورك بالتقصير، ثم من شعورك المستمر بالإرهاق الذي يمنعك من أن تغير من وضعك الحالي.
«مواجهة الإنسان مستويات متقدمة من أي شيء، خصوصًا إذا كانت في المجال الذي يطمح أن يحقق إنجازًا فيه، لا توفر مردودًا إيجابيًّا دائمًا. بعضهم قد يشعر بالضآلة عند مواجهة من يفوقونه نجاحًا أو موهبة. وقد يدفع الأمر نفسه آخرين إلى قبول التحدي وتطوير ذواتهم والتركيز على أهدافهم»، هكذا تحكي لـ«منشور» الفتاة الشابة هديل.
توضح هديل أن ظاهرة «الترويج الذاتي» (Self Promotion) صارت أكثر ما يشغلها الآن، لكن «من جانب المتلقي الذي يُفاجأ يوميًّا بمن يروجون لمهاراتهم في التصوير أو التصميم. لذلك، كثير من أصدقائي مُشتَّتون. يشترون الأدوات للإبداع في أحد المجالات، ثم يملون منه بعد يومين، ويتنقلون بين المجالات بحثًا عن السعادة التي يشعر بها أقرانهم ممن يعملون في نفس المجالات».
صورة زائفة عن الذات

ليس شرطًا أن يكذب المرء في حديثه عن نفسه ليُصدِّر إلى الآخرين صورة غير حقيقة عن ذاته. فنصف الحقيقة أيضًا كذب، وهو أمر فرضته علينا السوشيال ميديا. في بعض الحالات، لا يكون لنا يد فيه، على الأقل ليس عن وعي منا.
صورتك عن نفسك تبقى مرتبكة ومشوشة طوال الوقت، يتحكم فيها عدد الإعجابات والتعليقات على منشورات فيسبوك أو إنستغرام أو غيره.
المعلومات التي يتلقاها منا الآخرون خلال التواصل المباشر تتجاوز مضمون الكلام، وتخبرهم بأشياء قد لا نرغب في أن يعرفها أحد عنا.
في العلاقات الافتراضية التي لا يجرؤ أصحابها على المخاطرة بتحويلها إلى علاقات حقيقية، نجد الصورة التي يرسمها الآخرون لنا دائمًا ما تميل إلى التطرف، أو يعيبها بشكل أساسي استنادها إلى توقعات غير واقعية أو عادلة. صورة ذهنية رسمها هذا الآخر لنا، يصعب عليه المخاطرة بتدميرها، أو التخلي عنها عندما تكون إيجابية.
الشهرة الافتراضية أيضًا، لا تقترن بنجاح ملموس أو ازدهار مادي، لكنها تأتي ومعها عبء الشهرة بمعناها المعروف. عندما يقول لك أكثر من ألف شخص نفس الشيء، تجد نفسك مرغمًا على تصديقه. وعندما يتوقفون عن قول هذا الشيء أو يتفوهون بنقيضه، تصدق أيضًا الرسالة الخفية وراء هذا الصمت أو تغير المواقف الحاد، وتغفل حقيقة أن أحدًا منهم لا يعرفك حقًّا.
اضطرابات النوم

كم مرة استيقظت من نومك ليلًا لتتفقد هاتفك؟ وهل كان من السهل عليك بعدها أن تعود إلى النوم؟
ترتبط جودة النوم ارتباطًا شرطيًّا بالصحة النفسية. كلما كبرنا زادت مسؤولياتنا ومخاوفنا، وزادت إمكانية أن يحل الأرق ضيفًا ثقيلًا على ليالينا.
في الأيام العادية، كان يزورنا على فترات متباعدة. أما الآن، وبعدما زادت نسبة الاكتئاب والقلق بين الناس، أصبح الأرق كما نقول «صاحب بيت»، ما ضاعف مشكلاتنا النفسية وأثَّر سلبًا في أعمالنا وقدرتنا الإنتاجية، وجعلنا عرضة لأمراض خطيرة، مثل السرطان والسكر والأزمات القلبية والبدانة.
بخلاف الدور الكبير الذي تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي في زيادة معدلات القلق بين مستخدميها، يُسهم أيضًا ما يُعرف بـ«الضوء الأزرق» المنبعث من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر في تعطيل العمليات الطبيعية التي تجري داخل المخ، ومنها عملية إفراز هرمون «الميلاتونين» المسؤول عن شعورنا بالنعاس.
التعقب الإلكتروني وذكريات فيسبوك: كيف يُحاصرك الماضي؟
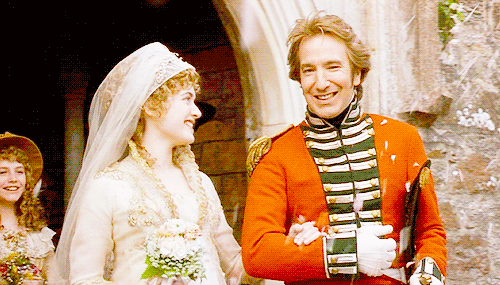
وسائل التواصل الاجتماعي جعلت عدم التعلق بالأشخاص والأحداث شديد الصعوبة.
في نهاية فيلم «Sense and Sensibility»، المقتبس من رواية بنفس العنوان للكاتبة الإنجليزية «جين أوستن»، يقف «ويلوبي» على تلة قريبة من منزل «ماريان داشوود» (التي أحبته كثيرًا وخذلها هو بنفسِ قدر حبها له) يشاهد مراسم زفافها إلى الكولونيل «براندون». تتدحرج دمعة وحيدة على خده، قبل أن يمتطي حصانه الأبيض ويُلقي نظرة أخيرة، ثم يرحل إلى الأبد.
سألت صديقتي ذات مرة: ماذا لو كانت قصة حب ماريان وويلوبي في عصر السوشيال ميديا؟. هل كان ويلوبي المتلاعب سيترك ماريان تهنأ بحياتها بعيدًا عنه، دون أن يلاحقها على فيسبوك وتويتر، ويبعث إليها برسالة من حساب مجهول على تمبلر، تتضمن كلمة واحدة تكشف هويته، لكن دون أن تكشفها في الوقت ذاته؟
هل كانت ماريان ستتوقف عن متابعة أخباره متمنية أن تسمع خبر طلاقه من تلك الثرية البغيضة «صوفيا غراي»؟ هل كان ويلوبي سيراسل ماريان على فترات متباعدة، ويخبرها بأنه ليس سعيدًا في زواجه؟
أو، لو كان أكثر دناءة: ماذا لو كان يحتفظ ببعض الصور التي أرسلتها إليه، والآن يملك في يده سلاحًا يمكنه أن يبتز به حبيبته القديمة؟
ضحكتُ وأنا أتخيل ذلك السيناريو البشع لواحد من أفلامي المفضلة. لكن الأمر ليس مضحكًا، لأن وسائل التواصل الاجتماعي جعلت عدم التعلق بالأشخاص والأحداث شديد الصعوبة. قديمًا، قتل الفضول القط فقط، أما الآن، فالفضول يقتلنا نحن، ووسائل التواصل الاجتماعي تحفز «المتعقب الصغير» داخل كلٍّ منا لتعقب حسابات من يعنون ومن لا يعنون له شيئًا، وننسى أن تلك السلوكيات محرجة ومريضة إذا ارتكبناها على أرض الواقع، لكننا لا نكترث لأن كل الناس يفعلون ذلك.
كل يوم، في تمام الساعة الثانية عشرة، يُعِد لنا فيسبوك قائمة بما كتبناه أو شاركناه في اليوم نفسه على مدار السنوات التي استخدمنا فيها الموقع. كل يوم نُفاجأ بأشياء محرجة كتبناها، أو مواقف حزينة مررنا بها، أو أغنية تشاركناها مع أصدقاء انتهت صداقتنا معهم بشكل سيء.
بالطبع نُفاجأ أيضًا بذكريات جميلة وحميمة، لكن ما يعلق بأذهاننا هو الأشياء المؤلمة. لذا، نقضي بضع دقائق يوميًّا في محو بعض الذكريات الفيسبوكية.
وسائل التواصل الاجتماعي: داوِني بالتي كانت هي الداء
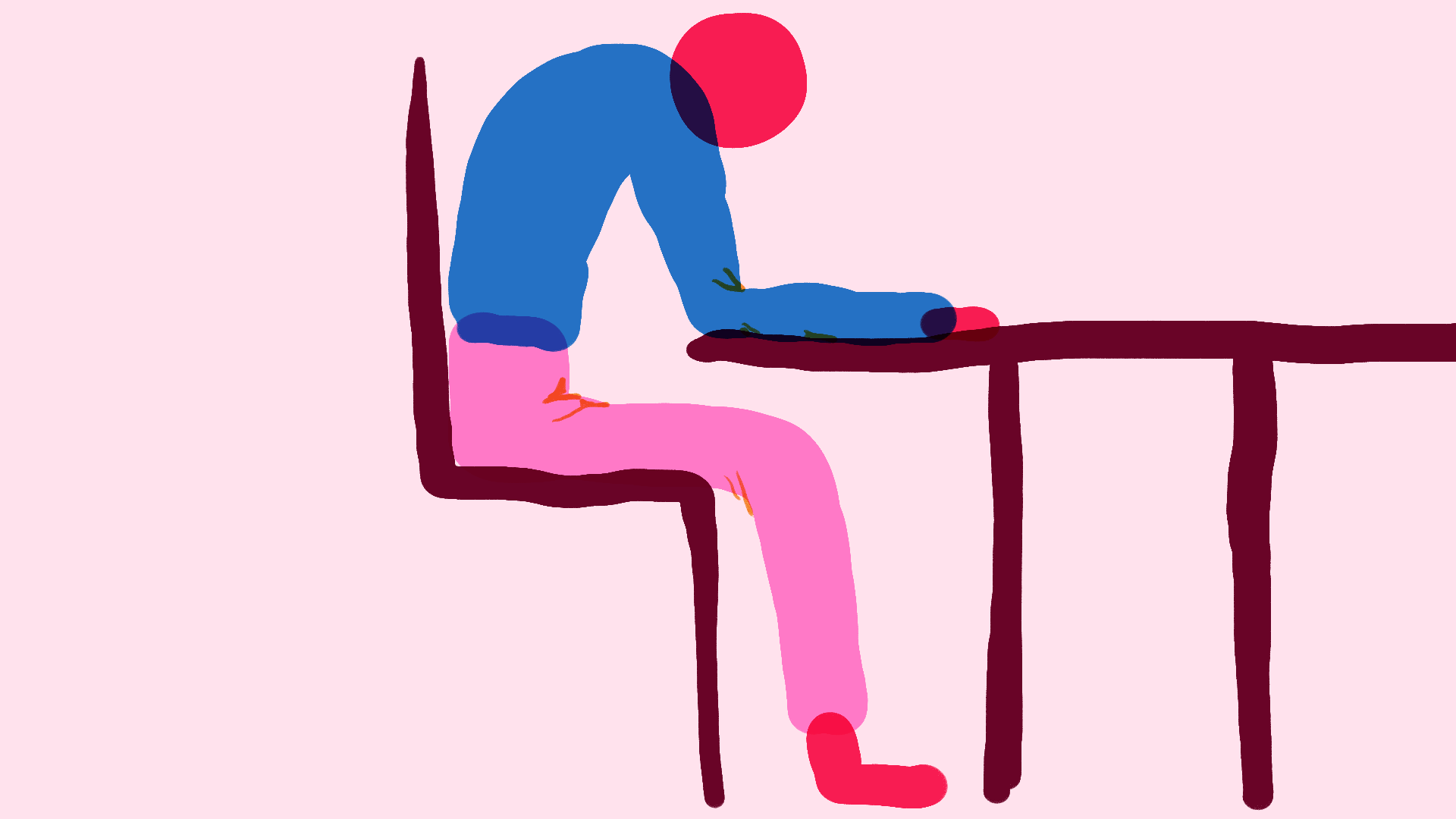
التخلي الكامل عن وسائل التواصل الاجتماعي يبدو الآن شبه مستحيل، لأنه يعني التخلي عن مصدر مهم للسعادة والإلهام والتعلم والتعرف باستمرار إلى أشخاص جدد، والبقاء على اتصال بالعالم.
تخيل كل مَن عرفتهم، وكل المساحات الجديدة التي ما كنت ستعرفها لولا وجود وسائل التواصل الاجتماعي.
هذا ما يؤكده حاتم ذو الـ24 عامًا: «وسائل التواصل تمنح مساحة للاهتمام بمجالات متفرقة، وجوانب قد لا تتوفر لها مثل هذه المساحة خارج أجهزتنا. لذلك، نفضل التواصل مع من يتشاركون هذه العوالم، وإضفاء أبعاد جديدة تمامًا على هذه الاهتمامات. لكن ربما اقتطع هذا من الوقت الأصيل لممارسة تلك الأنشطة نفسها».
مثلًا، أصبح من السهل الحديث عن الكتب مع أفراد مهتمين بالقراءة، لكن هذا يأتي على حساب القراءة نفسها، إذ تقدم وسائل التواصل طريقة مثالية لمحاكاة وجود من فقدناهم. لم أقصد هذا، لكن بعد فقدان أبي وجدتني أزور حسابه مرارًا، لأرى ماذا قال في موقف ما، وما الذي كان يعجبه وما لم يعجبه.
آية، الفتاة العشرينية، تحكي أن وسائل التواصل الاجتماعي ساعدتها بالفعل على تقبُّل الآخر، واستيعاب أفكار كثيرة كانت ترفضها بشكل غير منطقي في الماضي.
تضيف آية: «أصبحت أحسن على المستوى الإنساني، بفضلها وبفضل تجارب الآخرين في مواقف مختلفة من الحياة. جعلتني هذه التجارب أكثر جرأة على مواجهة مواقف لم أكن أجرؤ على مواجهتها. أما المكسب الحقيقي، فكان تعرُّفي من خلالها إلى آخرين يشاركونني اهتماماتي ونتشابه نسبيًّا في طريقة التفكير».
من الناحية الفنية، ترى أميمة، التي تقترب من إنهاء عقدها الرابع، أن «فيسبوك، الذي لا أستخدم سواه من مواقع التواصل، أثَّر سلبًا في جودة العمل الفني والجهد المبذول فيه». الإنتاج الفني بالنسبة إلى أميمة هو تضافر عدد كبير من التفاصيل، جزء منها يخص وعي الفنان وجهده. فيسبوك «خلق حالة من التعتيم على الوعي، وسمح لشريحة كبيرة من الجمهور، كانت بعيدة تمامًا عن عالم الأدب وجمالياته، بأن تلعب دور الناقد، فيضيع بذلك الفارق بين المختص وغيره».
يختلف معها محمد صاحب الـ23 عامًا. كان لديه اهتمام بالكتابة، لكنه لم يأخذه بجدية، ولم يجد منه مغزى. غير أنه بعد أن تعرَّف إلى فيسبوك في مطلع 2013، تمكَّن من متابعة أعمال كثير من الكتَّاب، ومعرفة أساليبهم المختلفة والتعلم منها لتطوير أسلوبه الخاص.
يرى محمد أن وسائل التواصل الاجتماعي عوَّضته عن غياب دور النشر، وأصبح بإمكانه عرض كتاباته والترويج لها بشكل ذاتي كما يفعل كثير من أقرانه.
في التعامل مع وسائل التواصل
بحسب الدراسة التي أجرتها «الجمعية البريطانية للصحة العامة»، أبرز وسائل المساعدة التي توفرها مواقع التواصل الاجتماعي هي:
- الاطلاع على تجارب الآخرين والحصول على معلومات مفصلة عن مرضهم من مصادر علمية موثوقة
- الحصول على الدعم النفسي من الأصدقاء أو من الأهل أو ممن يمرون بتجارب مشابهة، إذ توفر تلك الوسائل خيار التواصل الإلكتروني أو الافتراضي حين يتعذر عليهم التواصل مع الآخرين على أرض الواقع
- تعتمد وسائل التواصل بشكل أساسي على الكتابة. لذلك، لا عجب أنها ساعدت كثيرًا من الأفراد على التعبير عن أنفسهم بصورة واضحة، ومشاركة هواياتهم وكل ما هم شغوفون به
السوشيال ميديا مثل أي وسيلة تواصل إنساني، تأتي إلينا ومعها أنماط مختلفة من طرق التفاعل والتعبير. هذه وسيلة مثلها مثل أي شيء آخر. لا داعي للتعامل معها باعتبارها أمرًا غرائبيًّا، ولا أمرًا مسلمًا به كذلك. في كل الحالات، المعيار الأساسي هو الإنسان. وهو وحده من يقرر ويراقب تأثير هذه الأدوات عليه. يبدو الحل دائماً في مزيد من الاستبصار بالواقع والذات، وكذلك مزيد من فهم تأثير تلك المساحات علينا. لكن تجاهلها، وعيش اللحظة فيها دون انتباه، لا يبدو مفيدًا بأي حال.