«ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن»، رواه البخاري وأحمد وأبو داود وابن أبي شيبة والحاكم وابن حِبّان والدارميّ، وغيرُهم.
«زيِّنُوا القرآنَ بأصواتِكم»، رواه الطيالسيّ وأحمد والبخاري والنّسائِيّ والحاكم والبيهقيّ وابنُ ماجَه، وغيرُهم.
ربما هو تصديرٌ تقليديٌّ يتناول إشكاليةَ علاقة القرآن بالموسيقى، وهو بالتأكيد تصدير مثير للجدل، لأنه رغم تواتر رواية هذين الحديثين، بَقِيا مُختلَفًا على صحة رواياتهما، فضلاً عن المفهوم منهما. لكنّنا لا نجد مفرًّا من مقاربة مفردة «التغنّي» على المعنى الذي يجعلها محمولةً على «مُشاكَلة الغناء»، وهو وجه مشهور لمعنى الحديث.
السؤال هو: على أي وجهٍ يكون هذا «التغنّي» بالقرآن؟ المفردة نفسها لم تحدد طريقًا معينةً، فهل يكون التغنّي على قواعد الموسيقى والغناء المتعارَف عليها عند أهل الموسيقى والغناء، أم أن هناك قواعد أخرى تخص القرآن؟ وإلى أي مدى يمكن أن تتوافق قواعد تلاوة القرآن المتعارَف عليها مع قواعد الموسيقى والغناء؟
لإجابة هذه الأسئلة، علينا أن نستعرض سريعًا أركان الموسيقى وعلاقتها بالبِنية الموروثة المتعارَف عليها لتلاوة القرآن.
الإيقاع: القرآن يمر عبر بيتهوفن
الإيقاع هو العنصر الذي لا تقوم دونه موسيقى. الأشهر في الممارسة العربية أن يكون الإيقاع ظاهرًا، تضبطه آلة أو أكثر من آلات الإيقاع: طبلة الباص، أو الدُّف، أو المِزهر أو غيرها، لكنه يمكن أن يتخفى وراء النغَم (الركن الثاني من الموسيقى) دون أن يتلاشى.
في الفالس الأشهر «على ضفاف الدانوب الأزرق الجميل» (An der schönen blauen Donau)، من المصنّف 314 للموسيقار النمساوي «يوهان شتراوس»، لا يمكن للأذن أن تخطئ الإيقاع الثلاثي للفالس مع اختفاء آلات الإيقاع، ويَصدُق هذا على أي مقطوعة موسيقية في العالم.
فالس «على ضفاف الدانوب الأزرق الجميل»
من المعروف أن بعض آيات القرآن تنتظم في أوزان تقربها من بعض بحور الشعر العربي.
قبل أن ننتقل إلى علاقة القرآن بالإيقاع، علينا أن نوضح اصطلاحًا إيقاعيًّا مهمًّا، هو «تأخير النّبر» أو «الترخيم» (Syncopation).
يعني الترخيم ببساطة «انقطاعًا أو اضطرابًا في المجرى الطبيعي للإيقاع، أو وضع النبر في مواضع ليس من طبيعة الإيقاع الأصلية أن يوجد بها». هذا الترخيم يُضفي تنويعًا غير متوقع على الإيقاع، وربما يغير المزاج العام للمقطوعة.
من أشهر وأبسط الأمثلة على هذه الحيلة الإيقاعية ما يفعله بيتهوفن في نهاية المازورة الثانية عشرة من اللحن الأساسي للحركة الرابعة من سيمفونيته التاسعة «الكورالية»، إذ يضع «نبرًا» قويًّا على العلامة الإيقاعية ويربطها ببداية المازورة التالية (Legato) لتصبح أقوى، ويظهر هذا في غناء المطرب الباص ثم الكورال لبداية جملة «Alle Menschen werden Brüder» (البشر كلهم يصبحون إخوة).
سيمفونية «قصيدة الفرح» لبيتهوفن
بالطبع للقرآن إيقاع خاص به. لا نعني سرعة الأداء (Tempo) التي يوجزها اصطلاح «مراتب التلاوة»، التي تتدرج من الأسرع (الحَدر) إلى الأوسط (الترتيل) إلى الأبطأ (التحقيق). بالأحرى، نعني ذلك العنصر الذي لا تقوم دونه موسيقى، كما لا يقوم دونه أي منتَج صوتي على الإطلاق. لكنه ليس إيقاعًا منتظِمًا انتظام الإيقاعات المعروفة المستخدمة في الموسيقى، ولا انتظام إيقاعات الشعر.
من المعروف أن بعض آيات القرآن تنتظم في أوزان تقربها من بعض بحور الشعر العربي، فـ«قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدْ» تُوزَن «فاعِلاتُن فَعِلُنْ»، وتندرج هكذا في بحر «الرّمَل» مثلًا. لكن يحول بينها وبين تصنيفها كجُملة موزونة عَرُوضِيًّا أن القرآن أساسًا مبني على الوَصل، ولذلك تُرسم نهاية هذه الآية «أحَدٌ» بالتنوين، أما إن وقف القارئ عليها وسكّنها، فإن عاملًا آخر ينهض ليَحول بينها وبين سهولة تصنيفها كجملة في بحر الرّمَل. هذا العامل هو المعروف في علم التجويد بـ«القلقلة»، ومكانه حرف الدال من كلمة «أحَدْ».
الأمر نفسه يحدث مع «قُلْ أعوذُ بِرَبِّ الفَلَقِ»، التي تُوزَن إن سُكِّن آخرُها «فاعِلُنْ فَعِلُنْ فاعِلُنْ» على البحر المتدارَك، لكن كسر قاف «الفلق» حالَ الوصل، وقلقلتها حالَ التسكين، يحولان بينها وبين تصنيفها كجملة في «المتدارَك».
يبقى أن نذكر خلافًا في الفقه الإسلامي حول موقف أحكام التجويد (ومنها القلقلة المذكورة مثلًا) من الوجوب.
معظم رواد التجويد، مثل ابن الجَزري (صاحب المقدمة الشهيرة في أحكام التجويد) يذهب إلى وجوبه. بينما نفاجأ بأن ابن تيمية، المشهور في عصرنا بالتشدد، يرفع الحرج عن المسلمين في طلَب قواعد التجويد، بل ويزهِّدهم في الحرص عليها، كما في قوله في «مجموع الفتاوى»: «ولا يجعل هِمّتَه في ما حُجِب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن، إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيمها وتفخيمها وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك، فإن هذا حائل للقلوب قاطع لها عن فهم مراد الرب من كلامه».
نقطة أخرى في مسألة إيقاع القرآن هي حركات «المَدّ» وعلاقتها بإجراء الترخيم الذي قدّمنا له. المَدّ في القرآن، وما يتصل به من الغُنّة المتطلبة له، يزرع الجملة القرآنية بترخيمات غير منتطمة إيقاعيًّا، ويكاد يكون من المستحيل أن تخضع لتنظيم إيقاعي موسيقي مع المحافطة عليها.
الشاهد من هاتين النقطتين أن البِنية الإيقاعية للقرآن، حالَ تلاوته، بِنية أُرِيدَ لها أن تكون مغلقة على ذاتها، غير قابلة للاتصال بالتقاليد العَروضية الشعرية ولا بالتقاليد الموسيقية الغنائية في ما يبدو.
اقرأ أيضًا: تلحين القرآن: التاريخ الموسيقي الخفي للنص المقدس
النغم: أحوال القرآن وأمزجته
قد يقرأ القارئ الواحد الآية الواحدة بأكثر من مقام في أحوال مختلفة، وكل قراءة من هذه تؤثر في الوجدان بشكل مختلف.
تحضر هنا المقولة، المتنازَع على صحّتها هي الأخرى، للإمام علي بن أبي طالب، حين وجّه عبد الله بن عباس إلى الخوارج: «لا تُخاصِمْهم بالقرآن، فإن القرآن حمَالُ أوجُه، ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن حاجِجْهم بالسُّنة، فإنهم لن يجدوا عنها مَحيصًا».
الشاهد منها في تقديري، صحّت أو لم تصح عن قائلها، أن صفة «حمّال أوجُه» تنطبق على القرآن في منطقة إثارة الوجدان، ربما أكثر مما تنطبق عليه في منطقة تقرير الحقائق والأحكام والأفكار.
ما يحدث بشكل تلقائي في جلوس كل مسلم للتعبد بقراءة القرآن هو أنه إما أن يقرأه غير منغوم، كإلقاء الشعر، أو يضع له نغمًا وليد اللحظة. هذا النغم يختلف في درجة اتِّساقه وتوافقه الموسيقي من شخص إلى آخر، بحسب المهارة والإتقان وجودة الصوت.
غنيٌّ عن البيان أن هذا النغم يتسق وفق المقامات الموسيقية المعروفة مع القُراء المهَرة بالقرآن، وَعَوا ذلك أم لم يَعُوه، تعمّدوه أم جاء معهم عفوًا.
فوق ذلك، قد يقرأ القارئ الواحد الآية الواحدة بأكثر من مقام في أحوال مختلفة، وكل قراءة من هذه تؤثر في الوجدان بشكل مختلف عن الأخريات. مقاطع الفيديو التي توضح المقامات الموسيقية في تلاوة القرآن أكثر من أن تُحصى. في المقطع التالي، يقرأ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من مواضع مختلفة بالمقامات الأساسية كلها.
الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يقرأ بالمقامات الأساسية
أما في المقطع التالي، فيقرأ منير محفوظ الفاتحة فقط بالمقامات الأساسية.
منير محفوظ يقرأ سورة الفاتحة بالمقامات الأساسية
في التلاوة السابقة، يكتسب نَصّ الفاتحة طابعًا وجدانيًّا مختلفًا مع كل قراءة، وهو طابع من الصعوبة بمكان أن نحصره في تعبير لغوي واضح، لكن ليس مستحيلًا أن نقارِبَه، فهو يبدأ بمقام الصَّبا، بما يثيره من حُزن هائج يجاوز حد الاحتمال، وربما يعود هذا إلى طبيعة المقام، الذي يعتبَر مقامًا ناقصًا لأنه لا ينتهي عند درجة ركوزِه (يبدأ بدرجة «ري» وينتهي بدرجة «ري بيمول»)، فكأن الفاتحة ترثي العالَم المشهود بكامله، أو ترثي عالَم ما تحت فَلَك القمر، باصطلاح أرسطو الكلاسيكي.
ثم يقرأ منير محفوظ بمقام نهاوند (السلّم الصغير)، بحُزنه الأرستقراطي المتأمِّل من بُعد، وينتقل بعدها إلى مقام العجَم (سلّم كبير)، وهو مقام يرتبط بالفرَح، كأن الفاتحة فيه تلخِّص موكبًا ملائكيًّا للتسبيح وتأمل تناغُم الكون، ويتعالى على اهتداء المُنعَم عليهم وضلال الضالّين، وهو ما يذكِّرنا بشكل ما بالحركة الرابعة من السيمفونية التاسعة لبيتهوفن، التي تتناول نفس الموضوع وتعطي انطباعًا قريبًا من هذا.
بعد «العجَم»، ينتقل القارئ إلى مقام البياتي بإحساسه الدافئ، كأن الفاتحة فيه تعبير عن الانتماء إلى أسرة واحدة متلاحمة من المؤمنين بمصدرها المقدس.
بعد البياتي تُقرأ الفاتحة في مقام السيكا بما يبعثه من إحساسٍ باللوعة، كأنها لوعةُ محاولة القارئ للتعلق بـ«صراط الذين أنعمتَ عليهم»، والهروب من «المغضوب عليهم» و«الضالّين».
ثم ينتقل منير محفوظ إلى مقام الحجاز، القائم أساسًا على مسافة النغمة ونصف النغمة التي تثير إحساسًا بالحُزن هي الأخرى، لكنه حزن محسوب مؤقت لا ينتهي إلى اللوعة. بعد الحجاز يأتي الرست، المقام الأساسي في الموسيقى العربية، بإحساسه الفَرِح بكل تفاصيل الآيات.
تنتهي التلاوة بمقام الكُرد، الذي يمثل معادلًا مشرقيًّا للمزاج الفريجي (Phrygian Mode) في الموسيقى الأوروبية، بما يثيره من تأمُّل حزين قريب من النهاوند، وإن كان أكثر اشتباكًا مع التفاصيل، وبالتالي أوفر حظًّا من الحُزن.
قد يهمك أيضًا: لأن اللحن أكثر بلاغة: يا صاحبي، دعك من كلام الأغاني
أساليب التلحين: أغانٍ حلوة وأخرى مُرة
اقتراح التلحين في هذا السياق إما أن يعني تقييد القارئ بالقراءة في تتابع نغمي بعينه وكفى، أو أن يكون ذلك بمصاحبة الموسيقى الآلية.
المعنى الأول يتوافق مع جاء في موضوع الأستاذ شريف حسين: «يقول ضياء الدين بيبرس في مقاله إن عبد الوهاب كانت له محاولات لم تُنشر. ويشرح أن عبد الوهاب رأى أن القرآن نص عظيم ومقدس، وفيه تباين عظيم بين آيات العذاب والرحمة والجنة والنار، وأن قراءة هذه الآيات كلها، على حد سواء، تُضعف التأثر به».
لكن ما يبدو أنه فات موسيقار الأجيال في هذا التصريح المنقول عنه هو أن افتراض أن قراءة نَصّ، أي نَصّ، بلحن معين فقط، يتماشى مع المفهوم من هذا النص، فيه شكل من أشكال الَحجر على الإمكانيات التعبيرية الاستثنائية التي تمنحها الموسيقى للنص.
هذا التصريح من موسيقار الأجيال يحيلُنا إلى كتاب «الأغاني الحلوة والأغاني المُرّة: أساليب التلحين العربي»، للملحن الراحل محمد قابيل. في فصل «الأسلوب الزخرفي» من الكتاب، ينتقد المؤلف لحن الراحل فريد الأطرش لأغنية «يا حبايبي يا غايبين» في مقام البياتي، استنادًا إلى أنه وضع لحنًا «فَرِحًا» لكلمات حزينة.
المتأمل للأغنية بعيدًا عن نقد الكِتاب يجد أن المقام بدفئه أنطقَ الكلمات بما لم تقله صراحةً، وهو أن المطرب من أول لحظة في اللحن يشعر بدفء أحبابه الغائبين كأنهم لم يغيبوا، وهي إمكانية تعبيرية كامنة في النص، ما كان لها أن تتفجر على هذا النحو إلا بلحن فريد الأطرش.
أغنية «يا حبايبي يا غايبين» لفريد الأطرش
كذلك، هذا التصريح يقف في مواجهة مغامرات عبد الوهاب التلحينية نفسها، فمن كان يُصَدِّق أن نشيد «دقت ساعة العمل» يُلَحّن في مقام الهُزام من فصيلة السيكا؟
المقدمة الموسيقية المتراوحة بين الهزام والنهاوند تَخلُص في النهاية إلى الهزام، لتسلِّم الكورال الذي يغني هو الآخر في الهزام مقام اللوعة. في الحقيقة، أَنطَقَ لحن عبد الوهاب الكلمات: «دقت ساعة العمل الثوري لكفاح الأحرار، تعلن زحف الوطن العربي في طريقه الجبار»، بكل طاقة اللوعة واللهفة لتحقيق التحرر القومي وما يليه من إنجازات.
مَن كان يُصدق أن نشيد «طول ما أملي معايا معايا وِف إيديا سلاح» يمكن أن يُلحَّن في مقام الصّبا الحزين، حتى يمكن أن يوحي لمستمعه بأنه رثاء لكل شهداء السلاح حتى لحظة الأغنية؟
كان المتوقّع في إقدام أي ملحِّن على التصدي لأغنية وطنية ثورية حماسية أن يبتعد بها عن مقامات ثلاثة أرباع التون المرتبطة في الوعي الجمعي بالتطريب، لكن عبد الوهاب كان له أن يقلب هذا التوقع بسلوكه دروبًا غير مطروقة.
الشاهد أنه حتى الوتيرة الواحدة في قراءة القرآن كفيلة بإنطاق النص بحمولات وجدانية كامنة فيه وليست غريبة عنه، طالما أن البِنى النغمية المختلفة تفعل ذلك بالفعل مع النص القرآني كما تفعله مع غيره.
أغنية «حي على الفلاح»
أما مصاحَبة الموسيقى الآلية فإنها إما أن تكون وفق لحن محدد سلفًا بالفعل، أو تكون ارتجالًا. حالة اللحن المحدد سلفًا هي الأخرى لها أكثر من احتمال، فإما أن يكون اللحن ينتظم النص مع أداء الآلات، كما في أغنية الإيراني «محسن نامجو» التي أوردها الأستاذ شريف حسين في موضوعه كذلك، أو أن يكون اللحن للآلات فقط في ما يشبه الخلفية للتلاوة، كما في المقطع الصوتي من فيلم «بابا عزيز» الوارد في نفس الموضوع.
لم يحدث تلحين للقرآن في تجربة «بابا عزيز»، وإنما وُظِّفت التلاوة مع الخلفية الموسيقية في سياق درامي محدد. ساعد على وضوح هذا الانفصال بين المكوِّنين الموجودين في المقطع الصوتي أن الموسيقى الآلية كانت تعزف تآلفات في سلم صغير (مقابل النهاوند)، بينما التلاوة بدأت في مقام «قارجهار-شُورِي» من فصيلة البياتي، وعند قوله تعالى «فتقبل منِّي إنك أنت السميعُ العليم»، تحولت التلاوة إلى مقام الراست، وهما مقامان من مقامات ثلاثة أرباع التون غير القابلة للهرمنة أو العزف المتآلف في العُرف الموسيقي المستقر.
أما تجربة «نامجو» فهي تجربة تلحينية بالطبع، فمُرَجِّع الآهات في مقام نهاوند يسلم الغناء في سورتي «التكوير» و«المزمّل» مثلًا في مقام الصّبا، مع إسقاط، يبدو عن غفلة، لبداية آية «أو زِد عليه ورتِّل القرآنَ ترتيلا» في بناء لحني واضح، وهو بناء يبدو أميَل إلى التناص الساخر (parody) مع القرآن، ويصعب أن يخطئ المتلقي هذا، لا سيّما مع اقتباس المطرب من قصيدة «كلمات» التي شدت بها «ماجدة الرومي».
الخلاصة أن محاولة إخراج تلاوة القرآن من طريقة الارتجال/الأدليب («Ad lib» اصطلاح موسيقي مختصر من اللاتينية «Ad Libitum»، بمعنى: حسب رغبة المؤدِّي) المتوارَثة عن النبي محمد إلى اللحن المحدد سلفًا، تنطوي غالبًا على مخاطر متعلقة بأن يَضرب الموسيقيّ صفحًا عن القواعد المَرعِيّة في التلاوة، فضلًا عن سَجن النص في قالب نغمي بعينه، مما يُضعف الأثر الوجداني لتلقي القرآن.
اللحن في القرآن: نحو الشعور بالآيات
المعتصم بالله العسلي يقرأ سورة الفاتحة بعدة مقامات
تُعضِّد هذه النقطةَ الأخيرةَ دراسة لمجموعة من الباحثين في جامعة أرهوس الدنماركية، تتعلق بنتائج الفحص بالرنين المغناطيسي الوظيفي لمراكز المخ المسؤولة عن المشاعر خلال الاستماع إلى مقطوعات في السلم الصغير وتآلفات وتنافرات نغمية مختلفة، لدى عينة بحث مكونة من موسيقيين وغير موسيقيين.
من نتائج الدراسة أن التأثر الوجداني بالمقطوعات المستمَعَة كان أقوى في حالة انعدام نية تعلُّم التتابعات النغمية وتذكُّرها، وهو ما ينعكس بوضوح على موضوع مقالنا، إذ قد يؤدي اللحن المحدد للقرآن إلى ضعف التأثر الوجداني به، لأن اللحن يقدَّم بصفته منجَزًا فنيًّا قابلًا لتكرار الأداء عددًا لا نهائي من المرات، وبالتالي يوجِد اللحن عَقدًا ضمنيًّا مع المتلقين، بمقتضاه يعملون واعين وغير واعين على حفظ اللحن.
في تقديري، يتنافى هذا على مستوى أعمق مع الحديث الوارد في صحيح مسلم: «تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفسُ محمدٍ بيَدِهِ لَهُوَ أشدُّ تفلُّتًا من الإبل في عقلِها». بالطبع، يتعلق المعنى الشائع للحديث بحفظ النص القرآني، لكنه يحتمل كذلك أن الأثر الوجداني للقرآن بدوره أشد تفلتًا من البعير في عقاله، وقد أُرِيدَ له ذلك من البداية، ليكون هذا دافعًا إلى تعاهُده من قِبَل المؤمنين به، وتجديد علاقتهم الوجدانية بالنص المقدس على نحو مختلف في كل تلاوة.
الهارموني: علاقة المستمع بالنص

ربما يحدث الهارموني بشكل معقد إذا اعتمدنا تزاوج الموسيقى الآلية مع التلاوة، أو أبسط من هذا، إذا تعلق الأمر بمجموعات من القراء تقرأ في تآلفات نغمية في المقامات القابلة للهرمنة (العجم والنهاوند والكرد والحجاز، وفروعها ومشتقاتها الخالية من ثلاثة أرباع التون)، أو في أكثر من خط نغمي مختلف ومتزامن.
من الصعب الحَجر على مثل هذه التجربة قبل أن تحدث. في تقديري، يمكن أن تخرج بصورة طبيعية من المَقارئ التي تُعقَد في المساجد الكبرى إذا أَولَت دراسة المقامات الموسيقية قدرًا من الاهتمام، لكن سيظل أثر مثل هذه الخطوة على الخشوع وعلاقة المستمع بالنص القرآني ومُرادِه محل خلاف بالطبع.
الدين في مواجهة الحضارة
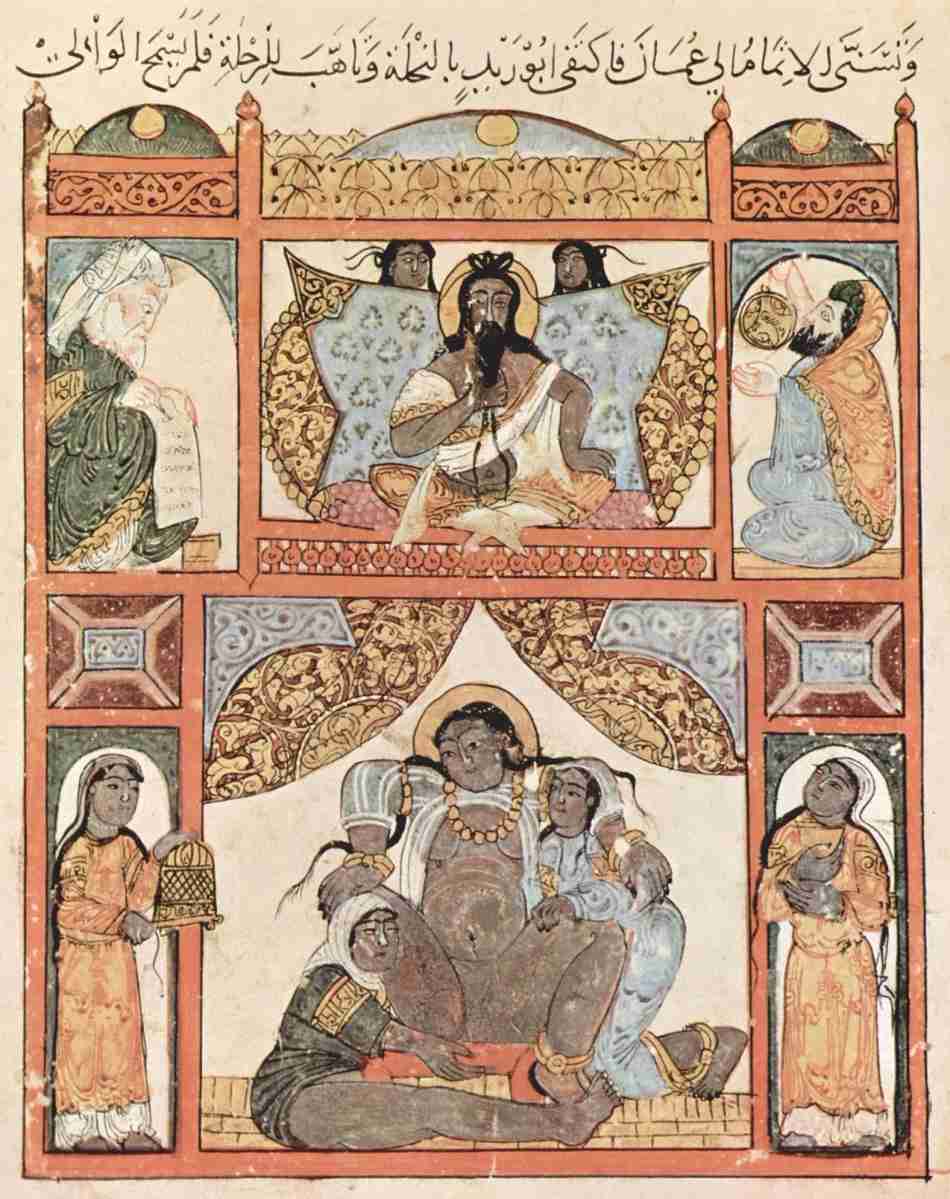
في تقديري، يُمثِّل سعي بعض الموسيقيين من آنٍ لآخر إلى تلحين القرآن وجهًا من أوجُه الصراع اللطيف تارةً الخشن تارةً بين الدين والفن، بنفس القدر الذي يمثل به محاولةً من الفن لـ«خدمة» الدين، وربما أكثر. ففي مقابل وجهة النظر الفقهية الإسلامية التي تحرِّم الممارسة الموسيقية على إطلاقها، يحاول الفنان بَسطَ سلطانه على أخص خصائص الدين، ليؤكد وجوده واستعلاءه.
على صعيد آخر، يمثل هذا السعي القديم/الجديد مسيرةً طبيعيةً للفن الذي لا يعرف الحدود ولا يعترف بالعوائق، ويحاول أن يستقدم كل مفردات العالَم إلى مملكة الوجدان، التي يعلن نفسه حاكمًا لها ولا يرضى مشاركة الدين فيها.
من منطلق ماركسي تمامًا في التحليل، وإذا ذهبنا مع ماركس إلى أن الدين والفن مكوِّنان في البِنية الفوقية لكل مجتمع، فإن الفن باحتفائه بالجمال وانطلاقه دون حدود يُعَد قاطرة كل حضارة بشرية إلى المستقبل، بينما الدين بقيوده وتركيزه على الأخلاق (بصفتها قِيَمًا سلبية تنبع من تجنُّب الشر أساسًا)، والخيط المحوري فيه الذي يحتفي بلحظة ماضية بصفتها مرجعيةً لفهم كل شيء ومقياسًا لكل تصرف إنساني، فضلًا عن درجة ما من القصور الذاتي تبدو مهمة لتُوصَفَ أيُّ مجموعةٍ من المعتقدات ووصايا السلوك بأنها دين.
الشاهد أن توقعي هو أن تستمر محاولات تلحين القرآن رغم تحفظي عليها مع فريق المتحفظين، وذلك أن مسيرة الفن، التي هي مسيرة الحضارة، تفترض ذلك، ربما في محاولةٍ من الفن لتجاوز النص القرآني. فبإخضاعه لقواعد الفن، يفقدُ القرآن خصوصيته التي يتغنى بها المتدينون من أمثال كاتب هذا المقال، وفي هذا بحد ذاته انتصارٌ للفن.
يتعلق هذا التجاوز بما أجترئُ على أن أُسمِّيه «أثر البرواز» (Frame Effect)، وأعني به قدرة بعض الإجراءات المحددة المرتبطة بالممارسة الفنية على أن تصبغ كل ما يقترب منها بصبغة الفن، وتجعله قابلًا للنقد بصفته فَنًّا. اشتققتُ هذا الاسم من ظاهرة اللوحة التشكيلية البيضاء، أو المحتوية خطًّا لونيًّا واحدًا لا يفصح عن أي معالم. هذه «اللوحة» بتأطيرها في برواز تتحقق لها «الفنّية» بشكل ما، وتصبح موضوعًا للنقد التشكيلي. وقُل الأمر نفسه في الورق الأبيض المُدرَج في كتاب يحمل اسم «ديوان شِعر». في موضوعنا، يقوم أداء الآلات الموسيقية في مصاحَبة التلاوة بالمعادل الموسيقي لهذين المثالَين، ويمهَد لـ«أنسَنَة» النص القرآني، ومِن ثَمّ محاولة تجاوُزِه.




