على مدار القرنين الماضيين كان الفن الحديث موضع جدال شديد، وحتى الآن لم يتوقف هذا الجدل بين الكلاسيكيين معارضي تيار الحداثة وما بعدها، والطليعيين، أو التجريبين، أو يمكننا أن نقول «الثوريين»، وهنا يظهر تساؤل مهم: لماذا يعارض الكلاسيكيون المحافظون الفن الحديث؟ إنهم لا يعارضونه فقط، بل يحاولون إخراجه من دائرة الفن من الأساس، وأنا هنا لا أتحدث عن الكلاسيكيين من الفنانين فقط، أو النقاد، بل من الجماهير أصحاب الذائقة الكلاسيكية المحافظة.
الأعمال الفنية الحديثة في شكلها الظاهري تتضاد مع العين المعتادة على الفن الكلاسيكي. فالشخص الكلاسيكي لا يجد في الفن الحديث ما يطابق الواقع، ولا يجد فيه ما يذكِّره بعالمه المحيط، أو حياته اليومية، أو ذاكرته التاريخية المستقاة من الحكايات القديمة.
ليس في اللوحات بشر كما نعرفهم، أو كما لا نعرفهم. ليس في اللوحات أي شيء من الحياة التي يعيش فيها المتلقي، تلك التي تكونت من خلالها الصور البصرية في عقله، وربما تتنافى مع المفهوم الجمالي الذي يعرفه، أو تتضاد معه وتصطدم به. لا يوجد تجانس، ولا تكوين فني بالمفهوم الكلاسيكي للتكوين. لا توجد محاكاة للطبيعة، وكأنها أعمال مشفرة، والمتلقي في حاجة إلى فك ذلك التشفير حتى يمكنه التعاطي مع العمل الفني.
ولأن الناس في الغالب يفضِّلون التعبير الذي يسهل عليهم فهمه، ويحبون الجمال الذي يعرفونه من قبل، وربما يبحثون عن البراعة الفنية وقدرة الفنان على التصوير الدقيق للواقع وللتعبيرات، لذلك كرّس الفنانون منذ القدم كثيرًا من الجهد لتسجيل التفاصيل الدقيقة ببراعة.
طيب، لماذا تكونت تلك الفكرة الجمعية في عقول ومخيلات البشر بمرور القرون؟ لماذا تنتظر الجماهير من الفن أن يكون مطابقًا لرغباتهم ومخيلاتهم وأفكارهم عن الجمال؟ ولماذا ينتظر بعضهم رسالةً ما يدافع عنها الفن أو يحاول توصيلها؟
ربما يعيدنا هذا السؤال إلى بدايات الفن ونشأته، وأسباب وجوده أصلًا، لأن الأمر في البداية كان نفعيًّا، إذ «كان الفن أو المنتَج الإبداعي قد أُنتِج لهدف أو غرض ما، سواء كان غرضًا دينيًّا، أو اجتماعيًّا، أو سحريًّا، ومن أنتجوا الأعمال التي نطلق عليها في عصرنا الحالي كلمة فن، لم يقصدوا في وقتها سوى المنفعة بشكل ما».
بنظرة سريعة على تاريخ الفن منذ حقبة ما قبل التاريخ حتى عصر النهضة، يمكننا فهم الأهداف المختلفة من الأعمال الفنية حسب السياق الاجتماعي والثقافي والسياسي والديني لكل عصر.
ارتباط الفن بالسحر

إذا عدنا بالتاريخ إلى عام 10000 قبل الميلاد (العصر الجليدي)، حيث كهوف ألتميرا في إسبانيا وكهوف لاسكو في فرنسا، نجد رسومًا توضيحية بأصباغ بدائية لحيوانات الماموث والرنّة والخيول والثيران.
اعتقد الصيادون البدائيون أنهم لو صنعوا صورًا للفريسة وهم يضربونها بالرماح، فإن الحيوانات الحقيقية ستستسلم لهم في طقس سحري. وربما كانت هذه الرسوم جزءًا من الطقس. وينسحب هذا الرأي بالضرورة على القلائد والأساور والقناني والأقنعة التي تمثل هدفًا نفعيًّا وأجزاءً من طقوس سحرية.
يمكن ملاحظة أن هذا الاعتقاد البدائي مستمر في الممارسات السحرية حتى وقتنا الحالي، إذ يُحضِر الساحر صورة الشخص المراد إيذاؤه، ويمارس كل أنواع التعذيب على الصورة معتقدًا أن صاحبها سيلحق به نفس الأذى.
الفن المصري القديم كان دينيًّا بامتياز، وكل اللوحات والتماثيل والنقوش لم تُنجَز إلا لتمجيد الآلهة أو التجهيز لعودة الروح.
لسنا هنا في سياق يسمح لنا بالتأكد من تأثير الأذى الممارَس على الصورة، على الشخص نفسه، لكن العقل الجمعي منذ العصور البدائية وحتى الآن يعتقد في صحة هذا الأمر. هنا نستعيد خيط الفكرة الأولى عن الهدف من الفن أو المنتَج الإبداعي، أي أن رسوم الكهوف وميراث البشرية من المنتجات الفنية البدائية لم تكن للتسلية أو التجميل أو التزيين، أي أنها لم تكن فنًّا في وقت إنتاجها.
ارتباط الفن بالدين

إذا عدنا بالتاريخ إلى مصر القديمة، ونظرنا إلى التراث الفرعوني العظيم نظرة متأملة في أسباب بناء الأهرامات والمعابد والتماثيل، سنجد أن الأمر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بجوهر الديانة المصرية القديمة، فالأهرامات ليست سوى مقابر تحافظ على جسد الملك المقدس بعد موته، وتساعده على الارتقاء إلى السماء، وكل التماثيل الموجودة في المقابر ليست سوى نسخًا متكررة من الملك صاحب المقبرة حتى تتعرف عليه «الكا» أو الروح عند عودتها من جديد، فيستطيع الملك أن يعود إلى الحياة.
اللوحات الجدارية والتماثيل الموجودة في المقابر المصرية كانت مرتبطة بفكرة تجهيز حياة مستقبلية ورفقاء للروح في العالم الآخر، حتى أن الفنان المصري القديم كان يجب عليه الالتزام الصارم بالقواعد الموضوعة، ولا يُسمح له بتجاوزها، لذلك يُعَد الفن المصري القديم دينيًّا بامتياز، وكل اللوحات والتماثيل والنقوش لم تُنجَز إلا لتمجيد الآلهة، أو التجهيز لعودة الروح، أو كتابات على جدران المعابد.
اهتمت حضارة الرومان أكثر بالهندسة المدنية: بالطرق، والقنوات، وأقواس النصر، والمسارح، وتماثيل الآلهة والملوك والأباطرة.
ما زلنا هنا نستعيد سلسلة الفنون التي صُنِعَت لغرض أو منفعة ما، وما زلنا نحاول اكتشاف سبب إصرار العقل الجمعي على البحث عن هدف للمنتَج الفني أو الإبداعي.
بالرغم من اختلاف جوهر الديانة المصرية القديمة عن اليونانية القديمة، التي لم يكن بها فكرة الحاكم المقدس كما عند المصريين، فإن أهم الأبنية الباقية من الحضارة الإغريقية هي المعابد المشيدة على الجبال، وتماثيل الآلهة بأساطيرهم القديمة، أو أبطال الأوليمب.
يجب أن نذكِّر هنا بأن الألعاب الأوليمبية كانت مختلفة عن السباقات الحديثة الحالية، بل كانت أكثر ارتباطًا بالمعتقدات الدينية، والمنتصر كان يُنظَر إليه باعتباره رجلًا ذا منحة إلهية، وكان الفائزون يطلبون من أشهر الفنانين أن يصنعوا تماثيل لهم من أجل إحياء ذكرى هذه الإشارات الإلهية.

لم يختلف الهدف من الفن الروماني عن أهداف الفن الإغريقي القديم، لكن حضارة الرومان اهتمت أكثر بالهندسة المدنية: بالطرق، والقنوات، وأقواس النصر، والمسارح، وتماثيل الآلهة والملوك والأباطرة، لتخليد الانتصارات الكبرى لروما القديمة.
خلال فترات الاضطهاد الروماني للمسيحية، كانت أماكن الاجتماع والصلاة صغيرةً ومهمَلة، لكن عندما أصبحت الكنيسة هي السلطة الأقوى، صارت الكنائس واسعة كي تحتوي المصلين المحتشدين، وأعيد النظر في علاقة الكنيسة (الدين) بالفن.

بدايةً من الفن البيزنطي، مرورًا بالفن الرومانسكي والقوطي، لم يكن للفن هدف سوى خدمة الكنيسة، وتمثيل حكايات المسيح والأساطير الكنَسِيّة. وكانت الكنائس تمثل بيوتًا للرب، والتنافس في زخرفة الكنائس يعد تقرُّبًا إلى الرب، بالرغم من اختلاف الطرز المعمارية من حقبة زمنية إلى أخرى، ومن مكان إلى آخر.
لم يختلف الأمر في بلاد الصين القديمة، إذ كان تأثير الدين في الفن قويًّا. وفي القرون السابقة والتالية للمسيح، تبنى الصينيون تقاليد دفن تُذكِّر بتقاليد المصريين القدماء، واعتقدوا أن الفن وسيلة تُذكِّر الناس بالسلف الصالح في العصور القديمة.
الفن كسلعة مقابل المال

بدايةً من عصر النهضة أصبح الفن سلعة يمكن شراؤها، والرسم مهنةً يحترفها الفنان للكسب المادي، فانتشر رسم النبلاء والأغنياء، وذاعت فكرة رسامي البلاط، أي الفنان المصاحب لكل حاكم، الذي يرسم له لوحات تمجده وتمجد عائلته، وتمثل مشاهد من حياته اليومية أو انتصاراته الحربية.
استعاد فنانو عصر النهضة معايير الفن الروماني الجمالية، وأصبحت المنافسة الأكبر على الحِرَفية والمهارة، والوصول إلى أعلى تمثيل للقواعد الجمالية الرومانية.
كان التجديد في هذا العصر يقوم على محاولات نقل الواقع بصورة مثالية، إضافة إلى اكتشاف المنظور الذي يقوي الإيهام بالواقع، حتى أن «دوناتيلو» في فلورنسا سئم دقة الأسلوب القوطي وتاقَ إلى صنع تماثيل أكثر بساطة، وكافح النحاتين لصنع تماثيل تماثل الحياة أكثر من أعمال الأسلاف، لكن في النهاية ظل الفن مرتبطًا بالواقع، ومستمَدًّا من الحياة الواقعية، أو الأساطير الدينية، أو حكايات الملوك والحروب التاريخية، رغم الاختلافات التي تتمثل في الأساليب الفنية بسبب اختلاف الجغرافيا والسياسة والرؤية.
الثورة الفرنسية وتأثيرها في الفكر والفن

شعر الفنانون فجأة أنهم أحرار في اختيار موضوعاتهم وأساليبهم الفنية، بعيدًا عن سلطة الدين أو المال، وخصوصًا بعد التحولات الاقتصادية، وإلغاء المَلَكية وامتيازات النبلاء ورجال الدين، وبدأ ما يمكن أن نطلق عليه التمهيد للحداثة، في مدارس فنية مثل الرومانسية والكلاسيكية الجديدة والواقعية، التي أصبحت تُعنَى بموضوعات جديدة تمامًا في الرسم، مثل المناظر الطبيعية، والحياة اليومية للأشخاص العاديين، والتأريخ للحروب وللثورات.
هذا الانفصال عن التقاليد القديمة الراسخة للفن أسهم فيه فنانون جاؤوا إلى أوروبا من أمريكا، وكانوا أقل التزامًا، ومنفتحين على تجارب جديدة ربما تعتمد أكثر على التخيل والفردية.
لماذا يفضل أغلب الناس الفن الذي ينقل الطبيعة، أو يحمل رسالة ما، أو يعبر عن حدث تاريخي سمعوا به من قبل، ولا يفضلون الفن الحديث؟
من هنا يمكن اعتبار الثورة الفرنسية بداية تأريخ جديد لمفهوم الفن. وبدايةً من القرن التاسع عشر، لم يعد أنجح الرسامين هو الأكثر محاكاةً للواقع أو الأكثر مثاليةً أو الأكثر كسبًا للمال، إنما أصبح الفن مفهومًا يرتبط بمجموعة من الفنانين المنعزلين أصحاب الشجاعة والقدرة على التفكير النقدي الجريء في التقاليد الفنية الراسخة.
في بداية الأمر اعتُبِرَت هذه الأفكار التجديدية تطرفًا وبُعدًا عن المعايير السليمة، لأن أغلب الناس يميلون إلى ترجيح ما يعرفون عند الحكم على الأعمال الفنية، خصوصًا الجماهير والنقاد. غير أن التجديد كان يأتي دائمًا من جانب الفنان الطليعي المتمرد على التقاليد. وبالطبع لم تحدث كل التغيرات والأفكار التجديدية دفعة واحدة، بل اكتشفها الفنانون على مدار سنوات، ووضعوا القواعد، ثم أجروا محاولات جديدة لكسر هذه القواعد.
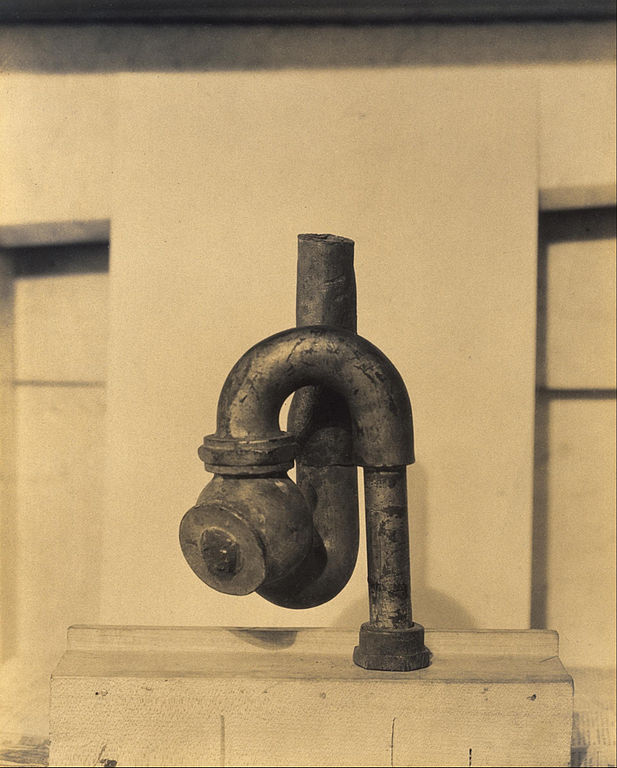
في نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر، أخذ الفن مفهومًا حداثيًّا يبحث عن كل ما هو جديد، وأصبحت القيمة الفنية ترتبط بالرؤية الجديدة، سواء في الشكل أو المضمون الخاص بالعمل الفني.
وبظهور المدرسة الانطباعية، التي تُعَد ثورة حقيقية على مفاهيم الفن الراسخة منذ قرون طويلة، ظهرت المدارس الفنية الحديثة، أو ما يُطلَق عليه مرحلة الحداثة في الفن، بدءًا من عام 1860 حتى 1970، ضمت مدارس فنية متعددة اختلفت تمامًا مع المفاهيم الفنية والبرجوازية والسلعية للفن القديم.

يمكننا أن نستعيد الآن السؤال من جديد: لماذا يفضل أغلب الناس الفن الذي ينقل الطبيعة، أو يحمل رسالة ما، أو يعبر عن حدث تاريخي سمعوا به من قبل، ولا يفضلون الفن الحديث، ومن بعده الفن المعاصر الذي يعبر عن الرؤية الفردية للفنان، أو الذي يهتم بالعملية الفنية في حد ذاتها، وليس بالمنتَج الفني فقط؟
تبدو قيمة الابتكارات والتجديدات الحداثية في الفن غير معترف بها بشكل كبير، بالرغم من تغلغلها في حياة الناس، وأهميتها في صياغة أذواقهم وخياراتهم بشكل عام، إذ أصبح الفن الحديث حقلًا كبيرًا للتجريب يجمع بين الفن والتصميم، لكن يبدو أن الأمر مرتبط بميراث كبير راسخ في العقل الإنساني بوجوب وجود هدف أو رسالة من الفن، إضافة إلى وجوب تطابق الفن مع الواقع.
نحن في حاجة إلى وقت طويل قبل أن تتغير تلك الفكرة الراسخة، برؤية جديدة تدرك جوهر الفردية والتجريب في الفن الحديث، تلك الرؤية التي تبدو ببساطة ووضوح في جملة بيكاسو «كلما أرى رسامًا يحاكي الطبيعة، ثم أتطلع إلى نتائج ما رسم، أرى لوحة رديئة».




