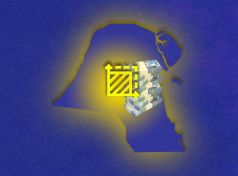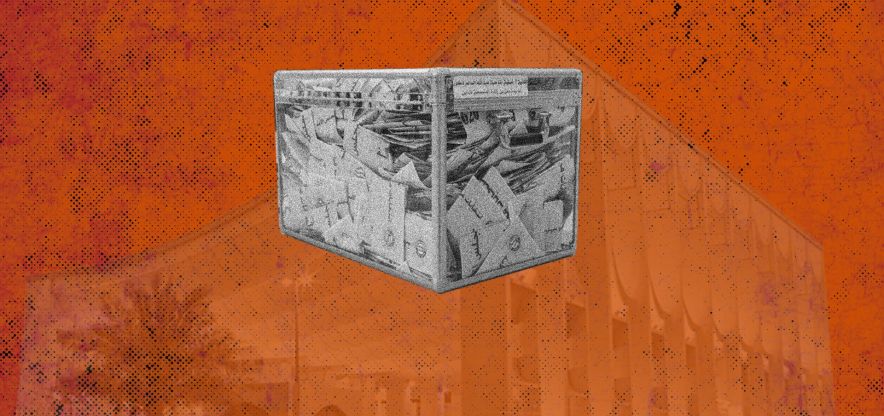صحة

لماذا نتقدم بالعمر.. وهل يمكن للعلم إيقاف ذلك؟
تُصنف الشيخوخة كأحد الألغاز الأساسية في علم الأحياء البشري، ودائما ما يتم طرح تساؤل حول ما الذي يجعل الجسم يتباطأ، وتتوقف خلاياه عن الانقسام، وتقع أعضاؤه فريسة للأمراض والعجز المتزايد؟