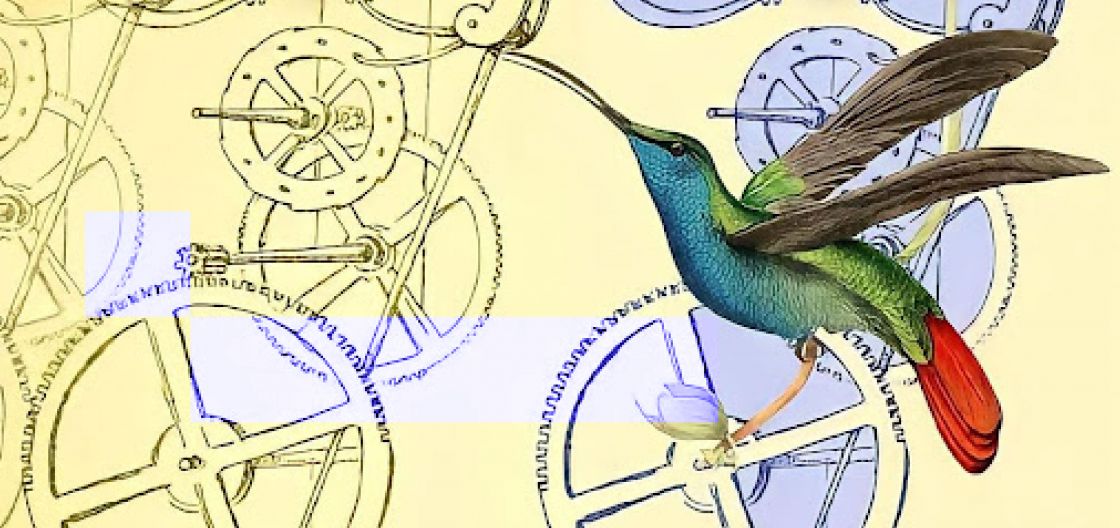يقول الرائع جيمس بيرك الإعلامي والكاتب الشهير في تاريخ العلوم: «دائمًا ما يأتي التغيير كمفاجأة، لأن الأشياء لا تحدث في خطوط مستقيمة، ويحدث الاتصال بين الأشياء عن طريق الصدفة. من الصعب تخمين نتيجة حدث ما، لأنه عندما يجتمع الأشخاص أو الأشياء أو الأفكار معًا بطرق جديدة، تتغير قواعد الحساب بحيث يصبح واحد زائد واحد فجأة يساوي ثلاثة. هذه هي الآلية الأساسية للابتكار، وعندما يحدث تكون النتيجة دائمًا أكثر من مجموع الأجزاء».
لظاهرة الابتكار قدرة على جعل البشرية تأخذ منعطفات مفصلية في تاريخها، وتتسم هذه التغييرات بالتتابع والتكامل، أو كما يطلق عليها في أدبيات الابتكار «تأثير الطائر الطنان». أي أن «حدثًا ما في حقل ما يمكن أن يؤدي إلى نتائج غير متوقعة تمامًا في مجالات مختلفة تمامًا، لا يمكن توقع هذا الاتصال أو التخطيط له، ولا يمكن معرفته إلا في وقت لاحق». وهذا المفهوم جاء للنور من خلال أعمال ستيفن جونسون في 2014، وتحديدًا في كتابه الذي ضرب به أمثلة على ابتكارات شكلت عالمنا المعاصر، مثل الزجاج، والتبريد، والساعة، والضوء الصناعي، وتنقية المياه، وتسجيل الصوت.
تأثير الطائر الطنان يختلف عن المفهوم الشهير لـ«تأثير الفراشة»، فالأخير يُستخدم في شرح نظرية الفوضى ويشير إلى حساسية أحد المتغيرات في التأثير على متغير آخر، ويقال عنه مجازًا أن «الخفقان اللطيف لأجنحة الفراشة من الممكن أن يثير بركانًا على الجانب الآخر من العالم»، وارتبط هذا المصطلح بعمل لورينز، وهو عالم الرياضيات والأرصاد الجوية الذي أراد من استخدام مفهوم تأثير الفراشة أن يوضح صعوبة التنبؤ بالأرصاد الجوية، حتى مع وجود أجهزة متطورة في هذا الزمن.
أما تأثير الطائر الطنان فهو مفهوم يشرح التتابع والتكامل الذي يحدثه الابتكار في أحد المجالات. فمثلًا في القرن الخامس عشر، اكتشف باروفيه صناعة الزجاج الشفاف، ومن ثم اعتمد رجال الدين في قراءة مخطوطاتهم على قطع الزجاج المحدبة لتكبير النص. وفي ذات الوقت ساعد اختراع غوتنبرغ للمطبعة على توسع وانتشار عادة القراءة بين الناس، وأسهم هذا في زيادة معرفتهم بمشاكل طول البصر، مما أدى إلى اختراعهم النظارات، ومع اختراع النظارات وازدهار سوقها شيئًا فشيئًا قادنا هذا إلى اختراع التلسكوبات والميكروسكوبات.
وكما رأينا فالأمثلة تتعدد حول التغيير المتتابع والمتكامل الذي تحدثه الابتكارات، لذلك أريد في هذا المقال توضيح تأثير الطائر الطنان على حياتنا عبر طرح أمثلة لابتكارات لها أثر واضح في صناعة التغيير الاجتماعي. وفي النهاية السؤال متروك لمن يريد أن يجيب حول أهمية الجاهزية لمواكبة التغيير.
حبوب منع الحمل
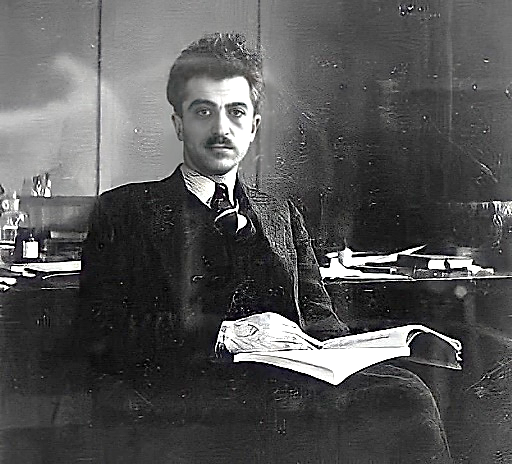
الدكتور غريغوري بنكوس، عالم الأحياء الذي هاجر من روسيا واستقر أخيرًا في أمريكا وعمل في هارفارد، لم يخطر في باله أنه سيتوصل إلى ابتكار من شأنه أن يعيد تشكيل حياتنا ويغير مفاهيم راسخة حول دور المرأة في سوق العمل وحتى باقي مناحي الحياة الأخرى، فقد كان لاكتشافه حبوب منع الحمل بالمشاركة مع زملائه أهمية كبرى في تغيير حياتنا، وصناعة واقع اقتصادي جديد أهم ملامحه مشاركة المرأة.
هذا الابتكار كان بمثابة ثورة اجتماعية وصناعية، فلأول مرة يكون للمرأة قرار في مسألة الإنجاب، وهذا أتاح لها أن تكون أكثر حرية وقدرة على المنافسة في سوق العمل، كما أصبح للمجتمع قدرة على تحديد النسل وتفادي مسألة الإنجاب غير المرغوب فيه، أو في حال عدم رغبة الطرفين او أحدهما بذلك. كما أنه مما لا شك فيه أن تأثير المرأة في سوق العمل وخاصة في المجتمعات الغربية تغير بشكل كبير نتيجة تغير طبيعة العلاقة بين المرأة والرجل، وذلك لأنه أتيح للمرأة ولأول مرة الفصل بين الجنس وعملية الإنجاب، وهو أمر لم يكن متاحًا قبل ذلك، وبعدها مباشرة بدأت المرأة في أمريكا باقتحام مجالات كانت حكرًا على الرجل، كدراسة القانون والطب وإدارة الأعمال وغيرها.
يعزي الباحثين ظهور حركات الانفتاح الجنسي في العالم الغربي، أو كما يسميها بعض الباحثين الذين يروجون للحتمية الاجتماعية بـ الثورة الجنسية، وتحديدًا في حقبة أواخر الستينيات وحتى ثمانينيات القرن الماضي، إلى أنها نتيجة أو مقدمة طبيعية لاكتشاف حبوب منع الحمل. كما أن تزايد «الوعي الجندري»، أي الوعي حول الأدوار الاجتماعية لأفراد المجتمع في عصرنا هذا، هو امتداد لهذا الابتكار.
فتح ابتكار حبوب منع الحمل المجال أمام ابتكارات أخرى في ذات المجال، منها تقنية «الرحم الصناعي» التي يتوقع الباحثون أن يكون لها مستقبل وتأثير أوسع في تعزيز دور المرأة بسوق العمل ودعم المساواة في الأجور بشكل أكبر، كون هذا الابتكار سيلغي حاجة المرأة للحمل، وبالتالي حاجتها لإجازات الحمل والوضع والأمومة. وتنبأ بذلك عالم الأحياء التطوري جي بي إس هالدين في 1924، حين قال إن «التكوّن الخارجي»، أي الحمل البشري في رحم صناعي، سيصبح شائعًا جدًا في عام 2074، و30% فقط من المواليد حينها سيولدون من رحم امرأة.
زر الإعجاب

منذ 2005 وحتى اليوم، خلق زر الإعجاب مفهومًا جديدًا للتفاعل بين البشر، وأعطى المستخدمين فرصة لأن يعبروا عن إعجابهم ودعمهم واستمتاعهم بأي منشور على منصات التواصل الاجتماعي، والأهم أن هذا الزر أصبح يلعب دورًا مهمًا في موضوع القبول الاجتماعي للأفراد، وهي مسألة تعبر عن حاجة الفرد للقبول والحب والانتماء إلى المجموعة. واليوم أصبح إشباع هذه الحاجة النفسية للفرد متاحًا بسهولة من خلال ضغطة زر تعطي الآخرين هذا القبول أو تحجبه عنهم أو حتى تقايضهم به، وأصبحت هذه المعادلة تحدد أهمية الأفراد في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا بالتأكيد يفسر سبب هوس بعضهم وإدمانهم لتلك المنصات.
فتح زر الإعجاب شهية منصات التواصل الاجتماعي لجمع معلومات عن المستخدمين وإدارة انطباعاتهم، وبناء قاعدة بيانات حول رغباتهم وتوجهاتهم الدينية والسياسية والفكرية أو حتى أي ميول لديهم، وهذا ببساطة من خلال معرفة سلوك المستخدمين باستخدام هذا الزر. وتتعدد اليوم طرق جمع معلومات المستخدمين بوسائل جديدة، مثل توظيف الذكاء الاصطناعي في مراقبة سلوكهم أثناء تمريرهم للشاشة إلى الأعلى أو الأسفل، أو حين توقفهم عند محتوى معين، وبناء على مراقبة هذا السلوك تستهدف تلك الشركات المستخدمين بإعلانات تثير اهتمامهم أو بملف أخبار يحبون أن يتابعوه.
ولجعل المستخدم يقضي وقتًا أطول مع تلك البرامج، تعمل الشركات على جعل تصفح محتوياتها غير نهائي، فكلما ذهبت للأسفل أو الأعلى تجد محتويات جديدة، سواء كنت تتابعها أو تقترحها المنصة عليك، وقضاء وقت أكبر على الشاشات يعني أرباحًا أكثر لهذه الشركات. المشكلة هنا ليست في جمع بياناتنا وبناء عليها عرض محتويات تهم المستخدمين فقط، بل المشكلة تكمن في تأثير هذه المنصات على تشكيل آرائنا، ولعل فضيحة شركة الاستشارات البريطانية كامبريدج أناليتيكا وفيسبوك في 2018 في التأثير على 200 انتخابات حدثت حول العالم خير مثال على استخدام بيانات المستخدمين وتوجيه آرائهم.
هذا ليس المثال الوحيد، فقد انتهجت فيسبوك وإنستغرام وتويتر خلال قصف غزة في 2021 سياسات «التعتيم الإلكتروني» حول ما يحدث هناك. وحتى ما يحدث الآن خلال الحرب الروسية على أوكرانيا، وما تفعله هذه المنصات من توجيه لمحتويات المستخدمين ضد روسيا وتوظيف الخوارزميات والذكاء الاصطناعي لعزلها عن المجتمع الدولي.
الطباعة ثلاثية الأبعاد

تقنية ثورية في مجال الصناعة، فباستخدام الكمبيوتر والطابعة يستطيع أي فرد أن يصمم وينفذ الكثير من الأشياء دون جهد كبير وبفعالية عالية جدًا وتكلفة أقل، وبالتأكيد خلال وقت أقصر. وهذه التقنية بدأت تتطور وتنتشر، فأصبحنا نراها اليوم تدخل في صناعة البيوت والإنشاءات والمعدات الطبية والأسنان والصيدلة والسيارات والطائرات والكثير من الصناعات المختلفة. كما يتوقع في المستقبل القريب أن تساعدنا على طباعة أعضاء بشرية تكون بديلة للأعضاء التالفة لدى المرضى دون حاجة لمتبرعين.
إلى هنا والأمر يبشر بالخير، حتى أعلنت شركة تكساس عن صناعة أول مسدس معدني من طابعة ثلاثية الأبعاد في 2013، ليصبح النقاش حول قدرة الأفراد على صناعة الأسلحة في منازلهم محل تساؤل. هل ستتيح هذه التقنية القدرة لأي فرد على صنع ما يريد في أي مكان ودون علم الآخرين؟ وهل هذا ينذر باحتمالات خروج هذه التقنية عن السيطرة؟ فالخطورة هنا تتجلى في السؤال حول إذا ما أراد أفراد أو جماعات أن يوظفوا الطابعات ثلاثية الأبعاد في تنفيذ أعمال إجرامية أو إرهابية، فهل يحتاجون بعد اليوم إلى تهريب أسلحة من الخارج أو البحث عنها في السوق السوداء؟
وماذا عن تحديات الملكية الفكرية، فكم فرد يمكنه صناعة حذاء رياضي مزيف في منزله؟ وماذا عن التلوث البيئي المتوقع جراء دخول هذه الطابعة في خط الصناعة، واعتمادها بشكل كبير على استخدام مادة البلاستيك واستهلاكها كمًا كبيرًا من الطاقة الكهربائية؟ فضلًا عن التحدي الذي سيواجه الموظفين الحكوميين في جمع الضرائب المتحصلة من الدخل أو النشاط الاقتصادي للأفراد.
أما على صعيد التنظيم، فهل سيزداد عجز القانون في إحكام السيطرة على أنشطة الأفراد حول استخدامهم للطابعات ثلاثية الأبعاد؟ خصوصًا مع انتشار هذه الطابعات وتوفرها للاستخدامات الشخصية، مما ينذر بعدم صلة القوانين المطبقة اليوم في التعامل معها. وهل استحداث قوانين جديدة للتعامل مع سلامة الأجهزة واستخدامها أمر مهم أو مجدٍ، حتى وإن كان تطبيقه صعب؟ أم أن الخيار الأسهل هو حظر هذه الطابعات والتعامل معها من منطلق الخوف، بشكل يشبه توجس الناس حين كانوا يخافون من جهاز الراديو في أول أيامه خشية استخدامه لتفجير القنابل عن بعد؟
وأخيرًا: منذ اختراع العجلة وحتى اليوم، ماذا يخبرنا الطائر الطنان عن مواكبة التغيير؟

رغم أن الابتكار ظاهرة لم تُدرس بشكل كافٍ بحيث نستطيع التنبؤ بالتغيير الذي تحدثه في مسار البشرية، وبالتالي تعزيز قدرتنا على التنبؤ بالمسارات التي سنسير بها، ورغم أن كل شيء متصل على مستوى ما، فإننا لم نكتشف بعد جميع أنواع العلاقات بين الأسباب والنتائج. العالم معقد، ونحن لا نعرف بعد ما لا نعرفه. إلا أنه يتضح لنا أن التغيير لا يحدث دائما نتيجة صنع القرار السياسي، بل هناك أحداث تفرض علينا واقعًا جديدًا لم نختره، وأقصد هنا الابتكار، فالمبتكرون يُحدثون التغيير دون حاجة لحملات انتخابية تبشر بواقع سياسي جديد.
ورغم عدم مثالية الحياة، فإن للابتكارات قوة في معالجة ضعف تصميمها، وهذا من شأنه أن يزيد ثقتنا في الحياة وقدرة الإنسان على خلق قيم عامة جديدة، فالحياة التي نعيشها اليوم أفضل مما كانت عليه في السابق، والفضل يعود لظاهرة الابتكار التي لها قدرة على التجديد وتشكيل الحياة بشكل أكثر عدالة، وسد الثغرات والعيوب التي كان أغلبها من الأمور المسلم بها، والتي لم يلتفت أحد إليها أو يرى إمكانية تغييرها.
أعتقد أن للتغيير عدة دوافع تتعدد بين التهديد أو الفرص، ومن لا يتغير للبحث عن الفرص سيجد نفسه مجبرًا على أن يتغير لتفادي التهديد. أحد أشكال تكيف الإنسان للبقاء هو تفكيره في المستقبل، فالعقل البشري مصمم بهذا الشكل، بحيث لا يستطيع أي منا أن يمنع نفسه من التفكير في المستقبل. نعم ندرك أن التخطيط للمستقبل لا يعني أننا نُحكم السيطرة على ماذا سيحدث لنا، ولكن المحاولة في هذا الاتجاه أفضل من عدمها، تجنبًا للتهديد الذي سيجبرنا على التغيير. أجمل ما قيل للحث على التغيير هو ما قالته غريتا تونبرغ المرشحة لجائزة نوبل للسلام: «أريدكم أن تنزعجوا، أريدكم أن تتصرفوا كما لو كنتم ستواجهون أزمة، أريدكم أن تتصرفوا كما لو كانت النار مشتعلة في منزلكم».