لم يظهر التشيع على مسرح الأحداث السياسية والفكرية في الإسلام فجأة، فمثله مثل أي ظاهرة مذهبية مشابهة، كان قد سُبِق بمجموعة من الإشارات والارهاصات التي توضح وقوع حالة من حالات الفرقة والتحزبات في المجتمع. تلك الحالة التي تمخض عنها في ما بعد، نشوء المذاهب والطوائف الإسلامية التي كان التشيع أحد أهم تجلياتها وأقواها.
ما طبيعة الخلافات التي سبقت ظهور التشيع؟ وهل كانت هذه الخلافات عقدية بحتة، أم سياسية واجتماعية؟
كيف أثرت التغيرات الديموغرافية في الأحداث؟
منذ البداية، حرص الدين الإسلامي على إرساء قيم العدالة والمساواة بين جميع المسلمين، فكانت العدالة الاجتماعية واحدة من أهم النزعات التي ميزت الدين الجديد، إذ فرقت بينه وبين الأنماط الاجتماعية السائدة في جزيرة العرب خلال بدايات القرن الأول الهجري/ السابع الميلادي، والتي كانت في مجملها معتمدة على التمييز الطبقي والعصبية القبلية والعشائرية.
ظهرت تجليات تلك النزعة بشكل واضح، في المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، والحقوق التي كفلها الإسلام والرسول لفئات مظلومة، مثل النساء والعبيد وبعض القبائل والبطون والعشائر الضعيفة مهضومة الحقوق.
رغم كل تلك التأكيدات التي حرصت على توحيد الصف الإسلامي من جهة، وخلق أسس وركائز مجتمعية جديدة ذات توجه ديني روحاني من جهة أخرى، فإننا سنلاحظ أن هنالك عددًا من الأحداث التي وقعت في السنين الأخيرة من حياة الرسول، والتي قد أظهرت أن نوعًا من الفرقة والشقاق والتناحر بدأ يدب بين صفوف المسلمين.
في غزوة «المريسيع»، العام الخامس من الهجرة، والتي اشتهرت باسم «غزوة بني المصطلق»، حدث الخلاف القوي الأول بين المهاجرين والأنصار، وتعصب كل حزب ضد الآخر، وكاد الأمر يتفاقم لولا أن الرسول محمد تدارك الموقف بسرعة، فأصلح بين المتخاصمين، وحضهم على ترك العصبية القبلية بقوله: «دعوها، فإنها منتنة».
في أثناء فتح مكة، العام الثامن من الهجرة، ظهرت بعض الدعوات الانتقامية من جانب عدد من كبار قيادات الأنصار، ومنهم سعد بن عبادة، زعيم الخزرج الذي قال صراحةً: «اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، اليوم أذل الله قريش»، الأمر الذي أنذر بهجمة قبلية عنيفة، ليعزل النبي سعد بن عبادة عن مركز القيادة، ويعين ابنه قيس بديلًا عنه، حسبما يذكر ابن جرير الطبري في كتابه «تاريخ الرسل والملوك».
وبعد فتح مكة بشهور قلائل، تجددت المحاسدات القبلية بقوة في أثناء توزيع الغنائم فور انتصار المسلمين في غزوة «حنين»، فقد ورد في عدد من المصادر، ومنها صحيحا البخاري ومسلم ومسند أحمد بن حنبل، أن الأنصار غضبوا من طريقة توزيع الغنائم، وقال بعضهم: «يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشًا ويتركنا، وسيوفنا تقطر من دمائهم»، فأوضح لهم الرسول أنه أعطى هؤلاء ليتألفهم لأنهم حديثو عهدٍ بالإسلام، وقال لهم: «أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال، وترجعوا إلى رحالكم برسول الله؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به».
كانت التحولات في ديموغرافيا العالم الإسلامي مقدمة لانشقاقات كثيرة، ومن ثمَّ لظهور التيار الذي سيُعرف في ما بعد باسم «الشيعة».
كل هذه التوترات والمشاحنات كانت تقع بسبب حدوث تغيرات جسيمة في بنية المجتمع الإسلامي وشكله في تلك الفترة. فمعتنقو الإسلام الذين ابتدأ أمرهم بفئة قليلة مستضعَفة، اضطر أفرادها إلى الهجرة من مكة إلى المدينة، ولم يتجاوز عددهم بضعة عشرات فحسب، نجدهم في حجة الوداع، العام العاشر من الهجرة، زادوا عن مئة ألف، بحسب ما ذكر الخطيب البغدادي في كتابه «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»، ما يعني أن عدد المسلمين تضاعف لأكثر من ألف مرة في أقل من عشرة أعوام.
تزامن مع تلك التغيرات الكبرى في بنية القوة الإسلامية، أن كثيرًا من حديثي العهد بالإسلام، لم يكونوا من المؤمنين الصادقين، بل كان منهم «المنافقون» والطلقاء الذين أسلموا في الرمق الأخير، بعد أن أدركوا عبثية مقاومة تلك القوة الفتية الناشئة التي استطاعت أن تفرض سيطرتها ونفوذها على معظم مناطق شبه الجزيرة العربية.
لما كان من الطبيعي أن يعمل هؤلاء «المنافقين»، ممن أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، على ضرب الدين الجديد من داخله ومحاولة استئصاله، فإننا نجد أن بعض المصادر التاريخية السنية والشيعية تحدثت عن أن بعض المنافقين المشاركين في الغزو، حاولوا اغتيال الرسول في العقبة، في أثناء الرجوع من غزوة «تبوك» العام التاسع من الهجرة.
كانت هذه التحولات في ديموغرافيا العالم الإسلامي مقدمة لانشقاقات كثيرة، ومن ثمَّ مقدمة لظهور التيار الذي سيُعرف في ما بعد باسم «الشيعة»، خصوصًا بعد تفاقم الصراع بين أطراف إسلامية عدة في الحوادث التي شكلت «الفتنة الكبرى».
اقرأ أيضًا: بين روايات السنة والشيعة والمستشرقين: متى ظهر التشيُّع؟
حادثتا «الغدير» و«الرزية»
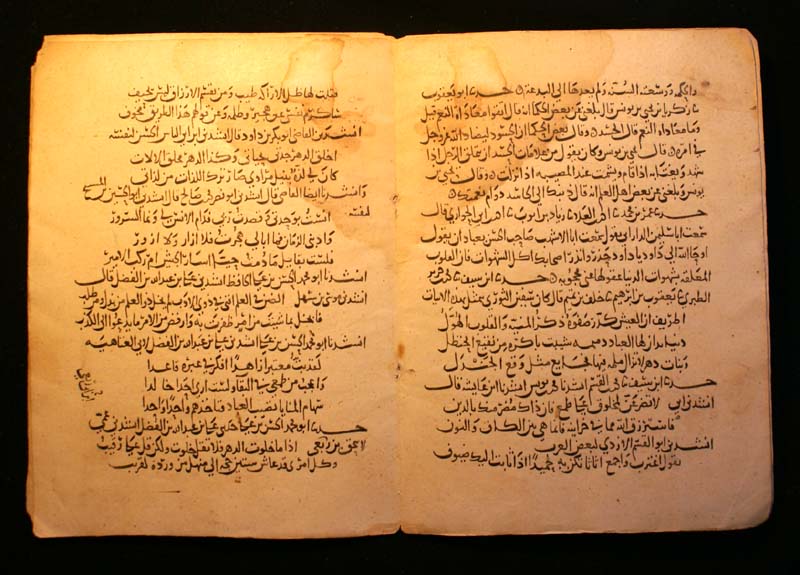
تجدر الإشارة إلى حادثتين مهمتين وقعتا في الأيام الأخيرة من حياة الرسول، وعلى الرغم من أهميتهما في مستقبل المسار السياسي في الدولة الإسلامية، فإن تفسيرهما وتأويلهما جاء بشكل متعارض في العقلين الجمعيين السني والشيعي.
الحادثة الأولى، وقعت في 18 من ذي الحجة العام العاشر من الهجرة، وذلك في أثناء الرجوع من حجة الوداع، في مكان قريب من المدينة يُعرف بـ«غدير خم»، حيث أمر الرسول بالتوقف، ثم ألقى بعض الوصايا على المسلمين، ومنها قوله: «تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدًا: كتاب الله وعترتي»، ثم أعقب ذلك بتبيان فضل علي بن أبي طالب، على وجه الخصوص، إذ قال: «من كنت مولاه، فهذا علي مولاه».
ورد هذا الحديث بصيغ كثيرة واختلافات متعددة في كثير من مصادر الحديث والتاريخ السني والشيعي، من أهم المصادر السنية التي ذكرته «مسند أحمد بن حنبل»، و«سنن ابن ماجة»، و«سنن الترمذي».
أما الحادثة الثانية، وكانت وقعت في يوم الخميس الذي سبق وفاة الرسول، وتُعرف بـ«رزية الخميس». وردت تفاصيل تلك الحادثة في «صحيح البخاري»، وجاء فيه أن عبد الله بن عباس قال: «يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى بَلَّ دمعه الحصى»، ثم قال: «اشتد برسول الله وجعه، فقال: ائتوني بكتف أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده أبدًا، فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبيٍّ تنازع، فقالوا: ما له أهجر، استفهموه؟ فقال: ذروني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه».
في الجانب الشيعي، حادثتا «رزية الخميس» و«الغدير»، مركزيتان في بناء المذهب الإمامي برمته.
المهم هنا، اختلاف تفسير الحادثتين السابقتين في الفكر السني عن الشيعي. فاذا تناولنا تفسيرهما في الفكر السني، وجدنا أن علماء أهل السنة والجماعة نظروا إلى ما وقع في غدير خم على أنه أمر نبوي لضرورة إظهار الحب والمودة والولاء لعلي بن أبي طالب، وأنه يشترك في هذه المكانة مع كثير من الصحابة الذين ذكر الرسول مناقبهم وفضائلهم في عدد من المواقف المختلفة، ولا يوجد في الحديث ما يدل صراحةً على النص باستخلاف علي أو ولايته لأمر المسلمين بعد وفاة الرسول.
في السياق نفسه، وفي محاولة منهم لتقليل أثر تلك الحادثة، فقد حاول عدد من أعلام علماء أهل السنة والجماعة تضعيف هذا الحديث، وعلى رأسهم: أبو محمد علي بن حزم الأندلسي الظاهري، وشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية الحراني. إذ يقول ابن حزم، في كتابه «الفصل في الأهواء والملل والنحل»، في معرض نقده للمذهب الشيعي الإمامي: «وأما من كنت مولاه فعلي مولاه، فلا يصح من طريق الثقات أصلًا، وأما سائر الأحاديث التي تتعلق بها الرافضة، فموضوعة، يعرف ذلك من له أدنى علم بالأخبار ونقلتها».
أما ابن تيمية، فيقول في كتابه الشهير «منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية»: «هذا الحديث (يقصد حديث الغدير) من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالموضوعات، وهذا يعرفه أهل العلم بالحديث، والمرجع إليهم في ذلك، ولذلك لا يوجد في شيء من كتب الحديث التي يرجع إليها أهل العلم بالحديث».
رد عدد من الباحثين السنة المعاصرين على الشبهات التي لحقت بأصل هذا الحديث، ومن أهم هؤلاء: الشيخ ناصر الدين الألباني، صاحب الخبرات الواسعة في مجال الحديث النبوي، فقد أفرد مساحة واسعة لتناول ذلك الحديث في كتابه «سلسلة الأحاديث الصحيحة»، وأثبت صحة الحديث. فكان مما قاله فيه: «فقد كان الدافع لتحرير الكلام على الحديث وبيان صحته، أنني رأيت شيخ الإسلام ابن تيمية، قد ضعَّف الشطر الأول من الحديث، وأما الشطر الآخر، فزعم أنه كذب، وهذا من مبالغاته الناتجة في تقديري من تسرعه في تضعيف الأحاديث، قبل أن يجمع طرقها ويدقق النظر فيها».
أما بالنسبة إلى حديث ابن عباس عن واقعة رزية الخميس، فلم يتوقف علماء السنة أمامه كثيرًا، فرأوا أن الرسول قد أراد أن يوصي ببعض الوصايا مع اقتراب وفاته، ولما وجد اختلافًا وتنازعًا بين الموجودين، صرفهم من عنده، ولم ير حاجة ملحة تستلزم كتابة الوصية.
قد يعجبك أيضًا: الشيعة والتشيع: تطور المصطلح ودلالاته
اعتقد علماء الإمامية أن الرسول أوصى صراحة باستخلاف علي بن أبي طالب من بعده، وأن تلك الوصاية تمت عبر الإشارة في عدد من اللحظات التاريخية من عُمر علي بن أبي طالب، وأن حديث الولاية في غدير خم يعد النص الأكثر تصريحًا بولاية علي وإمامته. من هنا، فقد تواتر ذلك الحديث في غالبية كتبهم الحديثية والتاريخية، وصارت ذكرى وقوع حادثة الغدير بمثابة عيد يُحتفل فيه بتنصيب علي للإمامة، ولا يزال الشيعة الإمامية حول العالم يحتفلون في الثامن عشر من ذي الحجة كل عام، بعيد الغدير الأغر الذي يُعرف أيضًا بـ«عيد الولاية».
أما حادثة رزية الخميس، فيرى الإمامية أن الهدف من الوصية التي أراد الرسول أن يكتبها، هي النص صراحة على استخلاف علي وإمامته، وذلك بعدما لمس الرسول رفضًا لذلك الأمر من جانب عدد من كبار الصحابة.
هكذا احتشدت كل تلك الأحداث لتشكل ما يمكن أن نسميه بالإرهاص المبكر بقرب وقوع التنازع المذهبي الذي سينخرط فيه المسلمون عقب رحيل نبيهم ومؤسس دولتهم.




