«بينما عبد القدماء آلهةً للخير طمعًا في خيرها، عبدوا آلهةً للشر اتقاءً لشرها». هكذا علمونا قديمًا، وحتى الآن يؤمن كثيرون بتلك الفكرة النمطية عن نظرة أهل الحضارات الإنسانية القديمة إلى قوى الشر على أنها آلهة أو أرباب تؤذي، وأنهم عبدوها وقدموا إليها القرابين درءًا لأذاها.
حسنٌ، هذه فكرة خاطئة تمامًا.
فأولًا لم تكن علاقة الإنسان القديم بـ«رمز الشر» علاقة عبادة بالضرورة. وثانيًا، هذه الرموز لم تكن دائمًا «مصدر الشر». وثالثًا، «الشر» نفسه لم يكن في كل الأحوال شرًّا ينبغي رده، بل كثيرًا ما كان «شرًّا لا بد منه». لذا، دعونا لنأخذ جولة بين بعض نماذج الشر في الحضارات القديمة.
مصر القديمة: «سِت»، الشر ليس مرفوضًا دائمًا

لا بد أن أول من قفز ذكره إلى ذهن القارئ هو «سِت»، المشهور بـ«إله الشر».
في كتاب «الجبتانا: أسفار التكوين المصرية»، الذي صاغه علي الألفي في أربعينيات القرن العشرين نقلًا عن المؤرخ المصري القديم مانيتون السمنودي، نقرأ أن سِت كان أخًا للأرباب أوزيريس وإيزيس ونفتيس، وكان مشاغبًا أرهق الناس شرًّا وفجورًا، ثم تآمر على أخيه الملك أوزيريس حسدًا له على مكانته، واغتاله ومزق جسده. وتسير الأسطورة في طريقها المعروف الذي ينتهي بتتويج أوزيريس إلهًا للعالم الآخر، وتنصيب سِت إلهًا للشر.
لو انتقلنا من إطار الأسطورة إلى الإطار الأكاديمي، عبر كتاب «الديانة المصرية القديمة» لعالم الآثار الدكتور عبد الحليم نور الدين، سنقرأ أن سِت كان ربًّا للصحراء وتجسيدًا لقوى الشر والفوضى والارتباك (على نقيض «ماعت»، إلهة العدل والحق والنظام والانضباط)، وأنه من البداية خرج إلى العالم مُعبرًا عن عنفه، بأن مزق رحم أمه «نوت» قبل أن تكتمل فترة حملها به.
ولأنه رب الصحراء، فقد ارتبط بالجدب والقفر وموت النباتات، وكان كابوسًا للمصري الذي يعيش على الزراعة.
لكن سِت لم يمثل «منبع الشر» أو أصله الأوليّ، وإنما كان «إلهًا شريرًا»، فالشر سابق لوجوده، هو فقط اتبع طريقه، وكذلك فهو ربٌّ للقوى الضارة كالعنف، والحيوانات الضارية والعواصف العاتية.
ربما لهذا فإنه لم يكن من الغريب أن يُقَدّس وينضم إلى مجمع الآلهة، إلى حد اعتباره المعبود الرسمي للبلاد في عهد الهكسوس، بل وأن نرى بعض الرسوم تمثل جسدًا له رأسان أحدهما لحورس والآخر لسِت، أو أن يظهر الملك واقفًا بين الإلهان وهما يتوجانه. كان ذلك بمثابة اعتراف من المصريين بأنه لا يوجد شر مطلَق كما أن لا خير مطلق، وأن الإنسان قد يحتاج أحيانًا إلى القوى المكروهة لتستمر الحياة.
في كتابه الممتع «الرحمن والشيطان»، يضيف الباحث السوري فراس السواح تفاصيل عن سِت، فيقول إنه كان أقدم إله مصري من عصر ما قبل الأسرات، وأن الوافدين من الشرق في بدايات تشكيل المجتمع المصري القديم حملوا معهم فكرة الإله «حورس»، مما خلق بدوره فكرة ذلك الثنائي المتصارع، وأن الحرب بينهما ما هي إلا نقل أسطوري لفكرة الصراع بين التجمعات السياسية في مصر ما قبل الوحدة، إذ عبد بعضها حورس وآخرون عبدوا سِت. بل وقد تكون قصة تآمر الأخير على أوزيريس بمثابة إسقاط أسطوري لقصة مؤامرة حقيقة دُبِّرت بحق بعض ملوك العصور المبكرة.
تدرك الآلهة أن الحياة لا تستمر بغير «الشر المرغوب فيه أحيانًا»، فتحرص أن لا ينتصر حورس أو ست انتصارًا نهائيًّا حاسمًا، كي يستمر التوازن في العالم.
هكذا صنِّف سِت كإله لكل شيء سيئ أو مكروه، فهو الذي يسرق من نور الشمس فيحدث النقصان في ساعات النهار في فصل الشتاء، وهو الذي يسرق نور القمر فينقص ثم يعود للاكتمال، وهو الذي تقع مملكته في الشمال حيث الظلام والبرد والضباب والرياح الباردة.
لكنه في الوقت ذاته رمز للقوة والعنفوان، فهو «القدير مزدوج القوة المحارب الجليل»، والحجارة والحديد يوصفان أنهما «عظام ست» لصلابتهما.
كذلك فإن قوته المدمرة تحل في بعض الكائنات، كالقطط البرية والكلاب والخنازير وأفراس النهر والثعابين.
ولأن الآلهة تدرك أن الحياة لا تستمر بغير «الشر المرغوب فيه أحيانًا»، فإنها تحرص أن لا ينتصر أيٌّ من حورس أو ست انتصارًا نهائيًّا حاسمًا في الصراع الدائم بينهما، كي يستمر التوازن في العالم.
صفات سِت تلك هي ما دفعت بعض الملوك إلى إظهار تأييدهم له، كالملك سيتي الأول (لاحظ ارتباط اسمه بالإله سِت) يظهر في نحت بارز في مدينة طيبة وهو يتلقى قربان الحياة من سِت وحورس، وكذلك نرى الإلهان يتوجان رمسيس الثاني ويمنحانه الدعم معًا. الرسالة واضحة إذًا: سِت وحورس عدوان لدودان، لكنهما يد واحدة لأجل حماية الملك وإمداده بالقوة.
«سِخمت»: عين «رع»، ربة النقمة المدمرة والشفاء والحماية

لم تكن سِخمت شريرة دائمًا، بل كانت تمثل ربة الحماية والشفاء للملك، خصوصًا في الحروب، حتى أنها كانت تُعَد بمثابة أمٍّ له.
عندئذ ارتاع الإله مما رأى، فقرر رفع نقمته عن البشر وأمر سخمت بالكف عن القتل، لكن الربة ذات الطبيعة المفترسة المتعطشة للقتل كانت قد انتشت من الدماء، فلم تنصع لأمره واستمرت في ما تفعله، حتى اضطر الإله إلى كفِّها عنه بالحيلة، فأرسل في طريقها آلاف الجِرار من النبيذ المصبوغ بالحُمرة كالدماء، فانقضت تشرب وتنهل منه حتى سكرت ونامت، فارتفع أذاها عن البشر.
هي إذًا ليست «إلهة قاتلة سفاكة للدم» بحكم الأمر الإلهي، وإنما هي طبيعتها التي وجدت في أمر رع فرصة لإرضائها. وهي لا تمثل فقط القتل الدموي، بل هي كذلك ربة للأوبئة والرياح الصحراوية الساخنة القاتلة بطبيعتها، التي سماها المصريون «أنفاس سخمت».
لكن سِخمت ليست دائمًا شريرة، بل كانت تمثل للملك ربة الحماية والشفاء (خصوصًا في الحروب)، حتى أنها كانت تُعَد بمثابة أمٍّ له. اختيار اللبؤة رمزًا وتجسدًا لها إنما يرجع إلى طبيعة أنثى الأسد، التي تجمع الشراسة والوحشية من جانب والرفق والحماية لبنيها وأسرتها من جانب آخر.
تلك الإلهة التي حمل لها الموروث المصري القديم ذكريات دامية كريهة حملت مع ذلك من الصفات ما يجعلها جديرة بأن تمثل (كالإله سِت) الشر الذي «لا بد منه»، والشراسة التي تكون «مطلوبة في بعض الأحيان».
«موت» الفينيقي وصراعه الأبدي مع «بعل»

بعد أن يَقتل «موت» «بعل»، يلقي بجثته على الأرض، فتنوح عليه زوجته «عناة» وتطلب من«Jموت» رده إلى الحياة، لكنه يرفض.
تقول الأسطورة الفينيقية إن الإله «بعل»، رب العواصف والخصوبة، بعد انتصاره على الإله «يم»، رب المياه البدائية، وجلوسه على العرش الإلهي، تلقى تحديًا من الإله «موت» حاكم مملكة الموت والجفاف والقحط، يطلب منه أن يستسلم له ليقتله أو يستعبده، أو كما جاء في النصوص على لسان موت: «أنا وحدي من سيحكم فوق جميع الآلهة، من سيأمر الناس والآلهة، ويسيطر على جميع من في الأرض».
يرسل موت تنينه الهائل «لوتان» ذا السبع رؤوس، فيواجهه بعل ويسحق رأسه، فيتضاعف غضب موت ويُنذِر بعل بدمار السماوات والأرض.
ولسبب ما لا تُفصح عنه النصوص، يقرر الإله بعل الاستسلام لعدوه (غالبًا تضحيةً بنفسه حتى لا يتعرض العالم للدمار)، فيفتح موت فمه العظيم، أو كما يقول النص: «شَفَةٌ في الأرض وشَفَةٌ في السماء، واللسان بين النجوم ليدل بعل في أعماق جوفه، فتجف أشجار الزيتون وثمار جميع الأشجار». ولا يكتفي موت بابتلاع خصمه، بل يبتلع معه جميع غيومه ورياحه وعواصفه وأمطاره وابنتاه «بدرية» ربة القمر و«طلة» ربة الندى والمطر (القارئ يلاحظ بالتأكيد تشابه الأسماء مع العربية).
وبعد أن يَقتل موت بعل، يلقي بجثته على الأرض، فتنوح عليه زوجته «عناة» وتطلب من موت رده إلى الحياة، لكنه يرفض، فتقرر الزوجة معاقبة القاتل، فتلقاه وتصارعه، ثم تنتصر عليه، وتقطعه بالسيف وتمزق جسده وتطحن أجزاءه، ثم تدفنها في الحقول.
بعدها يرى الإله الأكبر «إيل»، جد بعل، في نومه حلمًا بالبشارة، يرى الوديان تجري بالعسل والسماوات تقطر بالزيت، فيقوم هاتفًا: «عَليان بعل حي» (عليان تعني «العالي»، وهي مستخدمة حتى الآن في بعض اللهجات الشامية)، وتهرع عناة إلى الحقول فتجد زوجها بعل قد بُعِثَ، وهو قائم ينتقم من أعداءه.
هكذا تعود الخصوبة والثمار إلى الأرض، لكن بعد سبع سنوات من الرخاء يظهر موت مبعوثًا من هلاكه يُنذر بعل بمعركة جديدة. وهكذا تتكرر المعركة بينهما كل سبع سنوات على نفس المنوال إلى ما لا نهاية.
المتأمل في رمزية هذه الأسطورة يدرك معانيها، فبينما يمثل بعل القوى «الخيرة» للطبيعة من مطر وخصب، يمثل عدوه موت القوى «الشريرة» من جفاف وقحط. وارتباط المعركة بينهما بالمواسم إنما هو تعبير عن القحط الموسمي ومواسم الجفاف القاتلة، وهو ما يمثل أشد الشر وأخطره بالنسبة إلى شعب تمثل الزراعة جزءًا كبيرًا من اقتصادياته ورخائه.
موت يعتبر بمثابة «إله شر طبيعي موسمي»، وهو ليس منبع الشرور كلها وإنما «الشر الأخطر». ولو لاحظ القارئ، فإن ما فعلته الإلهة عناة في قتلها له كانت نفس حركات الزراعة، من تقطيع وتمزيق وطحن ثم دفن في التربة، أي أن المُزارع القديم حين كان يؤدي تلك الحركات، كان يعين الإلهين بعل وعناة في حربهما ضد موت.
يمثل موت إذًا «شر الطبيعة»، النابعة أسطورته من مواسم معاناة الشعب المؤمن بالأسطورة من قسوة تلك الطبيعة.
شيطان اليهودية: الملاك الساقط
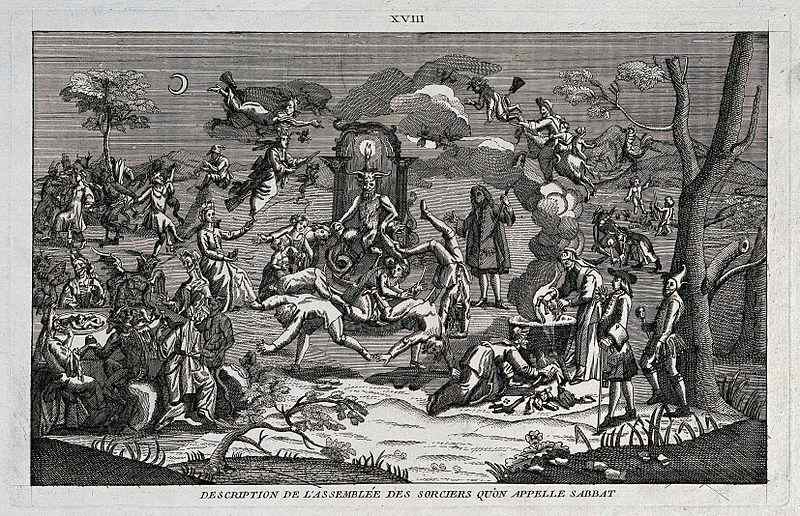
في بعض فصول كتاب «الرحمن والشيطان»، يتحدث الباحث السوري فراس السواح عن فكرة الشيطان في النصوص اليهودية: التوراة الرسمية، والنصوص المعروفة بـ«نصوص قمران» أو «مخطوطات البحر الميت»، المعثور عليها عام 1947، وكذلك «الهاجادا» أو شروح التلمود.
التوراة لا تنسب إلى عزازيل «نشأة الشر»، فهي التي تقول عن الرب إنه «صانع السلام وخالق الشر».
يواجه القارئ للتوراة مشكلة غياب الحديث عن بداية الشيطان أو خلقه، وإنما نقرأ فيها عن «ملائكة أشرار» أو «شياطين» من جند الإله «يهوه»، يرسلهم لتنفيذ مهام الإهلاك بحق المغضوب عليهم، أبرزهم «رشف» الموكل بالأوبئة، و«دبير» الموكل بالحُمّى، و«المُهلِك» الموكل بالتخريب.
منهم كذلك أرواح شريرة تُسَلّط على من يخطئ في حق الإله فتتلبسه وتصيبه بالجنون، من أبرزهم «عزازيل»، وهو شيطان عظيم الشأن يعيش في البوادي والأماكن المهجورة، وهو عالي المكانة إلى حد أنه يقتسم مع «يهوه» قربان الخطيئة الذي يغسل بدمه خطايا الشعب اليهودي.
عزازيل ليس بالضرورة خاضعًا لقوة يهوه، بل هو أحيانًا يستفزه لإيقاع الأذى ببعض عباده الصالحين، فهو الذي يشكك أمامه في إيمان العبد الصالح أيوب، فيتحداه بأن يسلط عليه الأمراض والفقر والابتلاء، فينساق يهوه للتحدي وتجري لأيوب القصة المعروفة.
رغم ذلك، لا تنسب التوراة إلى عزازيل «نشأة الشر»، بل هي التي تقول عن الرب إنه «صانع السلام وخالق الشر».
أما بداية صياغة الشيطان في الموروث اليهودي فكانت من خلال «الأسفار غير القانونية»، أي غير المعترَف بها.
ففي سِفر «أخنوخ»، نقرأ أن بعض الملائكة رأوا نساء البشر وأعجبوا بهن، فقرروا الهبوط إلى الأرض والزواج منهن ليكون لهم نسل، فقال لهم رئيسهم «سيمياز» إنه يخشى أن يتراجعوا عن خطتهم فتحل عليه وحده اللعنة، فتعاهدوا أن اللعنة على من نكث منهم. حينها هبطوا على قمة أحد الجبال (وكانوا 200 مَلَك) وتزوجوا من بنات البشر، فأنجبن لهم أولادًا من العمالقة البالغ طول أحدهم 300 ذراع.
مارَس هؤلاء العمالقة الشر وأتوا على الأخضر واليابس، ثم راحوا يلتهمون البشر، فضجّ منهم بنو الإنسان واستغاثوا بالسماء، فسمع ملائكتها استغاثاتهم وأخبروا يهوه بما جرى، فأرسل الرب إلى أخنوخ أن يبلغ الملائكة الساقطين قضاءه بحقهم وحق نسلهم: سيشهدوا ذبح أبنائهم، وستخرج من جثثهم الأرواح الشريرة وتسبب الأذى والشرور حتى نهاية العالم، وسيقيّد هؤلاء الملائكة حتى يوم القيامة فيُلقون حينئذ في هاوية العذاب.
وفي السِّفر المعروف بـ«اليوبيليات» أو «الخمسينيات» (لأنه قَسّم كل عهد إلى 50 عامَا، وهو من النصوص المعثور عليها في قمران بالبحر الميت)، نقرأ قصة الملائكة الساقطين ونسلهم من العمالقة الأشرار ذاتها، ثم يضيف النص قصة أن هؤلاء العمالقة آذوا البشر بعد الطوفان، فدعا النبي نوح الرب أن يقضي عليهم، فيرسل الرب ملائكته، لكن «مستيما» رئيس الملائكة الساقطين يلتمس من الإله أن يبقي له عُشر أتباعه إلى نهاية الزمان، بينما ينزل الآخرون إلى مكان الحساب، فيوافق الرب، لكنه يرسل بعض الملائكة إلى البشر يعلمونهم العلاج والوقاية من شر الشياطين.
يخبر الرب نبيه موسى أن مستيما كاد أن يسلمه إلى فرعون، وأنه هو الذي أعان السحرة في سحرهم عند التحدي، وأنه هو الذي أمر فرعون والمصريين أن يطاردوا بني إسرائيل في خروجهم من مصر.
مما يبدو من كلام الرب لموسى أنه كان يقيد «مستيما» أحيانًا ويُطلقه أحيانًا أخرى لحكمة إلهية ما.
أما سِفر «أسرار أخنوخ» فيُرجع بداية الشيطان (أو «ساتانا إيل») إلى أنه كان رئيسًا لطبقة من الملائكة، ثم فكر في التمرد ليصبح نِدًّا للإله، فيلقيه الإله من الأعالي مع من تابعوه من الملائكة، فيتحولون إلى أرواح شريرة.
في نصوص رؤيا إبراهيم، التي صيغت في القرن الثاني الميلادي، يصعد إبراهيم إلى السماء ويرى تاريخ العالم، يرى الشيطان عزازيل يُطعِم آدم وحواء من الثمرة المحرمة.
يذكر كتاب «حياة آدم»، العائدة صياغته إلى ما بين القرن الأول قبل الميلاد والثاني الميلادي، أن الشيطان بدأ ممارسة نشاطه الشرير برفض السجود لآدم حين نُفخت فيه الروح، فقد أمر الرب الملائكة بالسجود، وكان أول المطيعين منهم الملاك «ميخائيل» ليضرب مثلًا في الطاعة والخضوع، لكن «ساتان» رفض السجود، فأنذره ميخائيل أنه إن استمر في كِبَره عاقبه الرب، فرد ساتان بأن الرب إن غضب عليه فسيَرفع لنفسه كرسيًّا إلهيًّا فوق النجوم ويصبح نِدًّا له، فألقاه الرب خارج دائرة السماء.
القصة السابقة هي نفسها التي ترويها الهاجادا.
وفي نصوص رؤيا إبراهيم، التي صيغت في القرن الثاني الميلادي، يصعد إبراهيم إلى السماء ويرى تاريخ العالم، يرى الشيطان عزازيل يُطعِم آدم وحواء من الثمرة المحرمة، وعن يمين هذا المشهد وشماله مجموعتان كبيرتان من الناس، فيسأل الرب عن هاتين المجموعتين، فيجيبه أن أهل اليمين هم المؤمنون شعب الرب، وأهل اليسار هم الخطاة أتباع عزازيل.
خلاصة هذا الجزء إذًا أن اليهودية في بدايتها لم تقدم تصورًا واضحًا للشيطان كمصدر للشرور والأذى، مما جعل من صاغوا النصوص غير الرسمية أو غير القانونية ونصوص شروح التلمود يستشعرون مسؤوليتهم عن خلق صياغة واضحة لهذا الكائن كمصدر للأذى والشر ومحرض عليهما، ربما لارتباط ذلك بإشكالية «الأخلاق والصواب والخطأ والمصير» عند عوام اليهود وأصحاب التساؤلات التي لا تنتهي حول الغوامض.
دين «زرادشت»: الحرب الأبدية بين روح الخير وروح الشر
خلق الإله «سبينتا ماينو» و«أنجرا ماينو» ومنحهما حرية الاختيار، فاختار الأول الخير، بينما انحاز الأخير إلى الشر، وقرر أن يتصدى لكل شيء حسن طيب يخلقه الإله.
في الديانة الزرادشتية (نسبةً إلى النبي الفارسي زرادشت)، يقول الراغب في اعتناق الدين: «أشهد أني عابدٌ للإله أهورا مزدا، مؤمنٌ بزرادشت، كافرٌ بالشيطان، معتنقٌ للعقيدة الزرادشتية، أُمَجِّد الإميشا سبينتا الستة، وأعزو لأهورا مزدا كل ما هو خير»، وهكذا يصبح واحدًا من المؤمنين.
تقول النصوص الزرادشتية إنه في البدء لم يكن سوى «أهورا مزدا» إلهًا مكتفيًا بذاته، ثم رأى أن يُظهِر نفسه ويخلق الكون، فخلق أولًا روحين توأمين هما «سبينتا ماينو» و«أنجرا ماينو»، ومنحهما حرية الاختيار ليكون لهما وجود. اختار سبينتا ماينو الخير وحمل اسم «الروح القدس»، بينما اختار أنجرا ماينو الشر ولُقِّب بـ«الروح الخبيثة»، وقرر أن يتصدى لكل شيء حسن طيب يخلقه الإله مستقبلًا.
هكذا أدت الحرية إلى الاختيار، وأدى الاختيار إلى وجود الخير والشر، وهذا الاختيار بدوره أوجد «المسؤولية عن القرارات». وتَعِدُ نصوص زرادشت من يختار الخير بحُسن العاقبة والمقام العالي، ومن يختار الشر بسوء النهاية.
ورغم قدرة أهورا مزدا على تدمير الروح الخبيثة الشريرة، فإنه رأى في ذلك تناقضًا مع فكرة الحرية والاختيار، فقرر إمهاله والاكتفاء بدعم الخير في مواجهته، وهكذا تعاون مع الروح القدس على خلق ستة كائنات نورانية مقدسة (الملائكة)، هم «الأميشا سبينتا»، أي الخالدون المقدسون، وهم المذكورون في شهادة الإيمان الزرادشتي سالفة الذكر.
هذه الكائنات الستة تمثل خصائص مجسدة للإله: الفكر الحسن، الحقيقة الناصعة، الملكوت القادم، الإخلاص، الكمال، الخلود، وصاروا خدمًا للإله في عملية الخلق، ووسطاء بينه وبين البشر وحافظين لهم. ثم خلق الأميشا سبينتا عددًا من الكائنات النورنية بدورهم يُدعون «الأهوار»، وكلف الإله هؤلاء الأهورا بمكافحة الشر.
على الجانب الآخر، كان الروح الخبيثة يضم إلى جانبه مخلوقات خارقة هي «الديفا»، استعدادًا للانقضاض على الخلق الطيب. هؤلاء صاروا الشياطين.
بعد ذلك خلق الإله العالم المادي ليكون مسرحًا للمعركة بين الخير والشر، لأنه أدرك بحكمته أن الشر لن يُقضَى عليه إلا في ساحة هذا الوجود المادي، وقرر في القدر أن تنتهي تلك المعركة بانتصار الخير.
بعد الانتهاء من خلق العالم المادي، نفّذ الروح الخبيثة خطته وانقض على العالم، فنشر فيه الشر والتشوه والكائنات الضارة والفساد، وحاول الروح القدس التصدي له، لكن العالم لن يعود إلى حالة النقاء الأولى لأن الأرض عرفت الشر كما عرفت الخير.
خَلقت الكائنات النورانية الخالدة رجلًا وامرأة، وأوصوهما باتباع طريق الخير: «الفكر الحسن، والكلمة الحسنة، والعمل الحسن»، وعلموهما ما يحتاجان إلى معرفته من فنون الحياة وتقنياتها.
لكن أنجرا ماينو تسلل إلى عقلي الرجل والمرأة وزرع فيهما النقائص الأخلاقية، فتحول البشر بدورهم كما العالم من حالة النقاء الخالص إلى حالة الصراع بين الخير والشر.
وهكذا كُتِبَ على البشر أن يعيشوا هذا الصراع، وأن ينحاز بعضهم إلى الخير وبعضهم للشر، حتى يحدث في آخر الزمان أن تنزل عذراء للاستحمام في بحيرة مقدسة استودعتها الملائكة بذور النبي زرادشت، فتحمل تلك العذراء بابن اسمه «شاوشنياط»، هو المُخَلِّص أو المهدي، الذي يقود الخيِّرين في معركتهم الأخيرة ضد الأشرار، وعندئذ تحل القيامة.
قبل أن نشهد تلك المعركة الأخيرة، دعونا نرى ما يجري لمن يختارون أن يتّبعوا الروح الخبيثة أنجرا ماينو، مقارنةً بمصير أتباع روح الخير.
عندما يموت المرء، تقف روحه عند قبره ثلاث ليالٍ تتأمل أعماله، فإن كان من أهل الخير أتته ملائكة الرحمة تعزيه وتواسيه وتبشره بالخير، وإن كان من أتباع أنجرا ماينو أتته شياطين العذاب تنذره وتعذبه. وفي اليوم الرابع، تؤخذ الروح إلى جلسة الحساب.
في جلسة الحساب، تَمْثُل الروح أمام «مترا» قاضي العالم الآخر، وهو أحد ملائكة الأهورا، فيزن الحسنات في كفة ميزان والسيئات في الكفة الأخرى، ولا تشفع للمرء عباداته بل تشفع له أفكاره وأقواله وأفعاله، فمن رَجُحَت حسناته فقد نجا، ومن غلبت سيئاته فقد هلك، ومن تساوت حسناته بسيئاته فهو في مكان وسط بين الجحيم والجنة، كشبح دون إحساس.
بعد ذلك، تمر الروح بمحنة عبور جسر فوق هاوية، الجسر على هيئة سيف حاد، فإن كانت لرجل من أتباع روح القدس انقلب السيف إلى جانبه العريض، فيعبره وهو يشم رائحة طيبة، ثم يرى فتاة جميلة يسألها: «من أنتِ؟»، فتقول: «عملك الحسن»، وتصحبه إلى النعيم.
أما أتباع الروح الخبيثة فإن المرء منهم يجد الجسر قد انقلب له على نصله الحاد، فيسير ثلاث خطوات هي «الفكر السئ، والقول السيئ، والفعل السيئ»، ثم تستقبله عجوز شمطاء قبيحة تخبره أنها عمله السيئ، وتعانقه وتهوي به إلى الجحيم.
وهكذا تنتظر الأرواح في عالمها، بينما ينتظر العالم المادي بدء المعركة.
عندما يظهر المُخَلِّص، يبدأ العد التنازلي للقيامة، فتلفظ الأرض عظام الموتى ويُبعثون أحياء، وتسلط الملائكة على الأرض نارًا تذيب الجبال وتأتي على كل شيء. فأما أتباع الخير فهم يمرون بالنار كما يمر المرء بالحليب الدافئ، بينما يذوب فيه الأشرار ويهلكون بعد عذاب رهيب.
وفي ذلك الوقت، يكون الروح الخبيثة أنجرا ماينو قد اختبأ مع شياطينه في باطن الأرض، فيتسلل إليهم النهر الناري ويباغتهم ويهلكهم تمامًا. تُطهر النار العالم، بل إنها حتى تُطهر الجحيم ذاته، ويسقي الإله الأخيار شراب الخلود ليعيشوا في الجنة إلى ما لا نهاية. وهكذا روى زرادشت قصة بدء وحياة ونهاية «روح الشر».
تنوعت نظرة القدماء إلى الشر بين كونه واضحًا محدد المصدر معروف البداية والنهاية، أو هلاميًّا نسبيًّا لا يمثل أمرًا استثنائيًّا، بل موجود بوجود العالم.
لعل الزرادشتية أول ديانة حددت مصدرًا معينًا للشر وسمته ووصفت أفعاله وربطتها بمسألة الأخلاق، بل وروت تاريخه من البداية إلى النهاية مرورًا بالحياة بدقة وتفصيل، وهو ما أعطى هذه الديانة عمقًا أخلاقيًّا، فوضعُ ملامح وتفاصيل للشر وأعماله يجعله أوضح، ويقلل مساحة «النسبية» في تقييم الأفعال بين طيب وشرير.
تغير وضع «أنجرا ماينو/الروح الخبيثة» بعد ذلك، فكهنة الديانة الفارسية السابقة للزرادشتية أدخلوا «تعديلات» على قصة العالَم، فصار أنجرا ماينو يحمل اسم «أهريمان»، ولم يعد روحًا أوّلية اختارت الشر، بل توأمًا للإله أهورا مزدا من أبيهما إله الزمن، خرج وتحدى أخاه، فكلف الإله الأكبر ابنه الخيِّر أهورا مزدا بخلق العالم ليكون ساحة للحرب ضد أخيه الشرير، وقدّر أن ينتصر الخير في النهاية.
كل إنسان ينحاز إلى الخير يقوِّي جبهة إله الخير في الحرب النهائية، وكل من يختار الشر صار جنديًّا في جيش أهريمان الشرير، وهو تطور ربما يعكس تغيُّر نظرة الإنسان القديم إلى الشر، من فعل أضعف من الخير إلى فعل مساوٍ له في القوة، ومن فكرة الخلاص كـ«خلاص فردي» إلى «خلاص عام»، فأنت حين تسير سيرةً طيبةً في العالم، فإنك لا تخلِّص روحك فحسب، بل تُسهِم في تخليص العالم كله من الشر.
كذلك تنوعت النظرة إلى الشر بين كونه واضحًا محدد المصدر معروف البداية والنهاية، أو هلاميًّا نسبيًّا لا يمثل أمرًا استثنائيًّا، بل موجود بوجود العالم بشكل فطري.
في كل الأحوال، تؤكد تلك التأملات والصياغات لفكرة الشر ورموزه قِدَم إشكالية الشر وماهيته في الفكر الإنساني، تلك الإشكالية التي لا تزال قائمة إلى يومنا هذا.




