إذا كنا نتساءل: كيف كانت الحياة اليومية في مصر منذ قرون قليلة؟ فربما يمكننا أن نتخذ دليلًا ليجيبنا عن هذا السؤال.
دليلنا كتاب يبدو اسمه غريبًا بعض الشيء: «هز القحوف بشرح قصيدة أبي شادوف»، كتاب مصري هزلي من القرن السابع عشر في عصر الدولة العثمانية، من تأليف الشيخ يوسف بن محمد بن عبد الجواد الشربيني. يتناول فيه المؤلف حياة الفلاحين في أيامه وواقعهم الاجتماعي والديني والسياسي.
يتكون الكتاب من جزأين، يحتوي الأول على مواقف يتعجب فيها الكاتب من فقر الفلاحين وتعاستهم، ثم يفرد ثلاثة أبواب ليُظهر فيها مدى جهل شعراء الكفور والقرى ومتصوفيها وفقهائها. فيما خص المؤلف الجزء الثاني بشرح قصيدة طويلة نسبها إلى شاعر من الأرياف كنيته أبو شادوف، وهو المذكور في عنوان الكتاب.
عن معنى العنوان يقول المؤلف إن القحف شيء من الصوف طويل يُلبَس على الشعر، مثل البرانيط والطراطير واللبد الذي يستعمله بعض الفقراء وغالب الخلابيص. أما الشادوف، فآلة يستخدمها الفلاح لسقي الزرع، لذا يكون معنى العنوان هو إعمال الرأس في فهم قصيدة الفلاح الذي كنيته أبو شادوف. وللقحف معنى آخر ذكره المؤلف، وهو من اليبس والخشونة، قال الشاعر: هل رأيتم في الورى، قَحفًا رقيق الحشية.
السياسة: ومن نزلة الكُشاف شابت عوارضي

يقول المؤرخ المصري جاك تاجر في كتاب «أقباط ومسلمون»: «استطاع الأقباط منذ الفتح الإسلامي احتكار إدارة البلاد المالية والاحتفاظ بها بفضل طريقة شخصية للمحاسبة كانوا يحتفظون بسريتها. ولكن عندما شرع البريطانيون في تجديد طرق العمل الحكومي، ومنعوا الآباء من اصطحاب أولادهم إلى مكاتبهم، وتشددوا في تعيين ذوي الشهادات، وعمموا التعليم، شعر الأقباط بأنهم سيفقدون الامتياز الذي مكنهم حتى ذلك الوقت من العيش عيشة رغدة، ألا وهو إدارة مالية البلاد».
يؤكد هذا «مايكل ونتر» في كتابه «المجتمع المصري تحت الحكم العثماني»، إذ يقول إن الأقباط، وأكثر منهم اليهود، عمل عدد منهم صرافين وجباة ضرائب ومسؤولي جمارك، وكلاهما كان يستخدم لغته القبطية والعبرية للحساب وحفظ الدفاتر. ويُرجِع مايكل كراهية بعض المسلمين المصريين تجاههم إلى شغلهم تلك المراكز الحساسة.
ربما ما سبق يفسر إحدى الحكايات التي وردت في كتاب «هز القحوف»، حينما بدا أن «أحد سكان القرية سيسعده الحظ ويمسك بالنقود، فقال له جيرانه غدًا يسمع بك نصراني البلد، ويقربك، وتبقى تجلس حداه ركبة بركبة، ويقول لك يا عرص، وتقول له يا سيدي، وإن شا الله يعطيك كيلة شعير وقدح قمح، فرد عليه الأول: إن أعطاني شي أنعمت عليكم».
في الكتاب نبرة طائفية كريهة صريحة كانت شائعة قبل ميلاد مبدأ المواطنة بين أتباع الديانات المختلفة، ولذا تجد الشيخ الشربيني حينما تعرَّض لمسألة التعامل مع جابي الضرائب القبطي يقول: «خدمة المسلم للكافر حرام، وكذلك تعظيمه، والخضوع له، ويكون الفاعل آثمًا بذلك ما لم يَخَف منه ضررًا أو أذى، كأن يكون حاكمًا عليه ومتوليًا أمره»، لكن ربما يكون ما دفعه إلى هذا الحديث نفوره مما اعتاده جباة الضرائب عامة من الشدة والغلظة وضرب الفلاحين وحبسهم، فهو لم يذكر شيئًا في الكتاب يخص الأقباط العاديين من فلاحين وتجار وغيرهم.
كانت التركية لغة حكام مصر في العصر العثماني، فتمتع من يتكلم بها بالمهابة بين السكان لأنه من الممكن أن يكون جنديًّا أو أميرًا.
مصر العثمانية كانت تدار بالنظام الإقطاعي، وترتيب هذا النظام، بحسب جرجي زيدان في كتابه «مصر العثمانية»، أولًا أن الأرض كلها ملك السلطان العثماني، وينوب عنه الباشا واليه في مصر، وبعد الباشا يأتي الملتزمون، وهم مُلاك الأرض الذين يقتنونها بعدما يطرحها الباشا في مزايدة علنية، ويتكفل الملتزمون بجمع الضرائب في الأراضي التي يحكمونها وكالة عن الباشا والسلطنة العثمانية، والمتلزم يعطي الفلاحين حق الانتفاع بالأرض دون امتلاكها، وإلى جانب تلك الأراضي كان للملتزم أرض خاصة تدعى «الأوسية» يستعمل في زرعها الفلاحين بالسخرة، وربما وصل عدد القرى التي يملكها الملتزم إلى 50 قرية.
تظهر قسوة هذا النظام على الفلاح في قصيدة أبي شادوف:
ولا ضرني إلا إن عمي محيلبة، يوم تجي الوجبة علي يحيف
ومن نزلة الكُشَّاف شابت عوارضي، وصار لقلبي لوعة ورجيف
يوم يجي الديوان تبطل مفاصيلي، وأهُرُّ على روحي من التخويف
ويا دوب عمري في الخراج وهمه، تقضى ولا لي في الحصاد سعيف
ويوم تجي العونة على الناس في البلد، تخبيني في الفرن أم وطيف
والوجبة، كما يشرح الشيخ الشربيني، هي تحمُّل الفلاح تكلفة الشاد (المشرف) والنصراني إن كان حاضرًا وجميع من يكون من طائفة الملتزم من مأكلهم ومشربهم وجميع ما يحتاجون إليه من عليق دوابهم. والكشاف جمع كاشف، والكاشف اتصف بهذه الصفة لأنه يكشف عن الإقليم المتولي عليه، ويزيل ما فيه من المفاسد والمظالم. أما الديوان، فالمقصود به وقت قبض المال من الفلاحين. والخَراج هو المال المُكتَسَب من زرع الأرض، وما يخرج منها كل عام. ومعنى العونة بحسب المؤلف أن يأتي رجل يقال له الغفير ينادي: العونة يا فلاحين، العونة يا بطالين، فيسرحوا للحفر والضم في الأوسية أرض الملتزم.
كانت التركية لغة حكام مصر في العصر العثماني، ولذلك تمتع من يتكلم بها بالمهابة بين السكان لأنه من الممكن أن يكون جنديًّا أو أميرًا، أو على الأقل يستطيع التفاهم معهم. يظهر هذا في إحدى حكايات المؤلف عندما أراد ثلاثة من الفلاحين نزول القاهرة فقال كبيرهم وصاحب الرأي: إن مدينة مصر كلها جنادي وعسكر يقطعوا الروس واحنا فلاحين ،وإن لم نعمل مثلهم ونرطن عليهم بالتركي وإلا يقطعوا روسنا، أنا تعلمت التركي زمان كنت أقعد حد المشد والنصراني ركبة بركبة.
ومن قصص الكتاب يتضح أن التركية بالنسبة إلى الفلاح، بحسب ما ينقل الشيخ الشربيني، ما هي إلا تكرار لألفاظ ملغزة وأحيانًا مضحكة، مثل «شلضم بلضم شقلب مقلب يوق يوق». والملفت أن نفس الانطباع عن اللغة التركية استمر للقرن العشرين، وظهر في السينما المصرية وعدد من الأعمال الإذاعية، منها مثلًا اسكتش «حظرت ناري» للفنان إسماعيل يس في فيلم «المليونير».
قد يعجبك أيضًا: هل يمكن تمييز المصريين من ملابسهم؟
الدين: بساطة الفلاحين وتعالي الفقيه
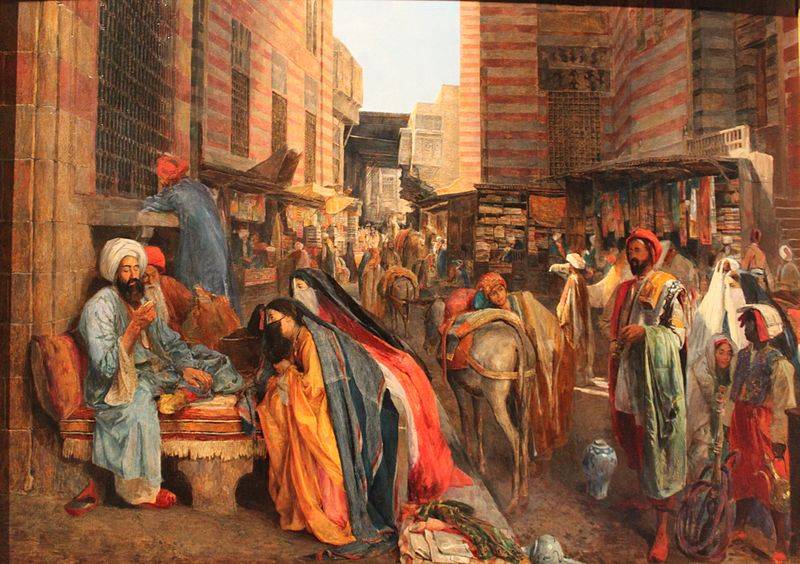
في الكتاب كذلك نلاحظ الشيخ الشربيني كشخص متعلم يعتقد أنه يعرف نسخة الدين المعتمَدة، يسخر من الفلاحين وممارساتهم الدينية التي يراها بعيدة عن صحيح الدين وعلومه، وابتعادهم أيضًا عن العربية الفصحى التي هي لغة القرآن وأساس الحياة القويمة والصفات الحسنة.
الدين في القرى، وبسبب قلة التعليم، يكون مختلطًا بتخيلات أهلها واجتهاداتهم الفردية في تصور الكون والعالم. عن ذلك يحكي الشيخ الشربيني قصة، لعله مؤلفها، أن فلاحًا دخل قصر هارون الرشيد، ولما رأى الديوان وكثرة العسكر ظن أن ذلك يوم القيامة، فقال لأحد الجنود: أخاف العرض على ربي لا يحاسبني على ضرب البهائم ونيك الحمير، لأني ما خليت حمارة في الغيط من خوف لأهجم على نسوان الكفر.
الكتاب يزخر بالقصص التي تبين بساطة فهم الفلاحين للدين، منها أنه سُئل فقيه ريفي عن آية «وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي»، ما معنى أقلعي؟ فقال أي سيري مثل المراكب المقلعة. ومنها أيضًا أنه «عندما تولى بعض فقهاء الريف عقد النكاح، فقال للولي: قل أنكحتك بنيتي خطيطة البيضاء اللون الشقراء الشعر عينها اليمين حولاء والشمال بلا حَوَل، بشرط أن تكون في طاعتك وتتقيد لدارها وتلزق الجلة فيها وتفرش فرشها وتسرج فتيلتها. ثم قال للخاطب قول قبلت شكاحها ونكاحها وهراشها وفراشها».
يحكي الشيخ الشربيني في الكتاب أن رجلًا من الفلاحين وصل فأحرم بالصلاة، وقال يا رب خلي لنا بهايمنا وكلابنا وقططنا وحميرنا وطلع لنا زرعنا وخلي لي وليدي عنطوز، هذا كيف وليدك يا رب، فقال له رجل عارف: كفرت يا فلاح، الله تعالى مُنَزَّه عن الصاحبة والولد، فقال له الفلاح أنا سمعت هذا الكلام من أبوي وجدي قبل موتهم، فقال له الرجل: كلكم كفرة أولاد كفرة.
من البدع التي استنكرها الشيخ على المتصوفة تناسخ الأرواح وإنكار البعث والنشور والجنة والنار.
في العصور السابقة على العصر الحديث كان التصوف منتشرًا في البلاد الإسلامية، وبخاصة في فترة الخلافة العثمانية، وقدم التصوف، بما يحتويه من أناشيد وتواشيح وبركة وكرامات ومعجزات، تجربة دينية مختلفة عن شعائر الدين التقليدية، وكان يطلَق أحيانًا على المتصوفة لفظ الفقراء لزهدهم أو لعدم امتهانهم أيٍّ من المهن وانشغالهم حصرًا بالذكر. وبالطبع أثار التصوف قلق العلماء لما به من أشياء غير مألوفة تُدخله في مجال البدع التي حذرت منها النصوص بحسب الفهم الأصولي للدين.
يستعرض مؤلف الكتاب عددًا من الأمور غير المألوفة أو البدع التي يستنكرها على بعض المتصوفة أو مدعي التصوف، أولاها ادعاؤهم بسقوط التكليف عنهم، لذا صار من حقهم ترك الصلاة والإفطار في نهار رمضان، فقد اعتقدوا أنهم في مقام الشهود مع الله تعالى، وصاروا في حالة الفناء في الله، وإذا فنى الشخص في الله سقط عنه التكليف.
البدعة الثانية التي ذكرها الشيخ أنه سمع من أحد الدراويش قوله إن البعث والنشور والجنة والنار لا حقيقة لهم، وجنة الشخص وناره وحسابه في نفسه، والدنيا لا تفنى ولا تزول، وإنما هي شمس تطلع وقمر يغيب.
البدعة الثالثة تناسخ الأرواح، ويقول الدرويش الذي ذكره الشيخ إن الشخص إذا مات وطلعت روحه دخلت في جسد آدمي أو حيوان حتى يدور عليها الدور، فترجع إلى صاحبها الأول، فيظهر بصورته التي كان عليها أولًا، وهكذا سائر العوالم.
البدعة الرابعة هي وحدة الوجود، واعتقادهم بأن الله يحل في الطبيعة والإنسان، ولا توجد معاصٍ أو منكرات، فيقول الواحد منهم: «أنت ناسوته، وهو لاهوتك، فالناسوت قائم بعين اللاهوت. وإن آدم على صورة الرحمن، وأنت من آدم وحواء، فأنت على صورة أبيك، وأبوك على صورة المعبود، فأنت ترجع إلى أصلك. وأيضًا إذا كانت الخلقة من التراب، ولاصَقَ التراب التراب، فلا حرمة في ذلك، فأنت إذا زنيت أو لُطت، فإنما هي تزاحم أجرام والتصاق تراب ببعضه».
الوقائع التي ينسبها المؤلف إلى الفقراء تفوق أحيانًا ما يمكن أن يراه شيخ فقيه «بدعًا» نظرية في الدين، فهو يحكي أنه من ضمن طقوس إحدى هذه المجموعات مضاجعة امرأة في ما بينهم كفعل يربط الجماعة إلى بعضها، فكانت مضاجعة المرأة بمثابة تعاهد على السر بينهم، ومن أفشى السر يكون القتل جزاؤه.
قد تكون هذه الوقائع حقيقية فتشير إلى ظاهرة موجودة في كل المجتمعات، وهي ظاهرة الطوائف الدينية السرية، وربما تكون محض اختلاق من الكاتب أو معاصريه لتحذير العامة من الاقتراب من مثل هذه المجموعات الدينية التي تخالف الجماعة الدينية الرسمية، فينسب إلى المجموعة التي تخالفه أسوأ شيء يضر بتماسك المجتمع، وهو شيوع الجنس والقتل دون حق.
احتمال آخر أن المؤلف أورد تلك الوقائع وهذا الكلام ربما لأنه رآه محيرًا وملغزًا وطريفًا، ولذلك رأى أن من المناسب عرضه ضمن الكتاب.
الأسماء: نيجل وجليجل وعفر ودعموم
الأسماء التي يحكي الكتاب عن أن الفلاحين يطلقونها على أبنائهم تبدو غريبة كذلك، فهم «يسمون جُنيجل وجليجل وعفر ودعموم وعيط وشلاطة ولهاطة وشبارة وزرارة وشلباية وعطاية وهدية وبلية وشقليط ومقليط وصفار وبرغوت وبهوار وجعمار والعفش والنتاش ومحمد بكسر الميم والحاء ومحمدين».
ويُكَنون بـ«أبو شعرة وأبو معرة وأبو شوالي وأبو شعيشع وأبو عوكل وأبو شادوف وأبو جاروف وأم جعيص وأم عميص وأم شليح وأم شواهي وأم دواهي»، ويلقبون بـ«شلاطه محلاب ومحمد القرب وكسبر العقلة وجلاية وكرساية وغاسولة وفارة وفرفارة وغارة وغايرة»، ويجيبون السائل بلفظ «هاه وهيه وإيشمالك وإي مالك وإيه هاه».
ويقول الشيخ إنهم ربما اعتمدوا في الأسماء على الفأل، فيذكر أن رجلًا وُلِدَ له غلام، فسمع رجلًا يقول إلى آخر: يا أعمش العين، فقال نسميه «عموش». ووُلِدَ لرجل أنثى، فسمع رجلًا يقول للآخر: هات الزبل، فقال لأمها سميها «زبيلة». وفي واقعة أخرى سُمي أحد الأولاد «عجيلًا» لأن عجلًا جاء ولحس المولود.
يختار أهل المدن أسماء أولادهم لغرض الوجاهة، بينما في الريف يختارون أسماء مرحة محببة كي ينضم العضو الجديد إلى الجماعة دون إثارة الحقد.
المؤلف، في الأغلب، اختار هذه الأسماء بعناية ليثير السخرية من طبائع أهل القرى، فهم لا يسمون الأبناء كما يقتضي الحس السليم (بالنسبة إليه) على أسماء الأنبياء أو الصحابة أو الأسماء العربية الدالة على الصفات الحميدة. هذه الأسماء إما أنها مضحكة في ذاتها بصورة طبيعية بسبب طريقة نطق اللفظ، مثل شلاطة ولهاطة وأم جعيص، وإما لأنها مرتبطة بقلة النظافة، مثل العفش وبرغوت وزبيلة، وإما أنها تشير إلى عيب أو نقص، مثل عموش، وإما لارتباطها بالفلاحة، مثل أبو شادوف وأبو جاروف.
قد يهمك أيضًا: نوستالجيا أغاني الأطفال الشعبية في مصر
يقول الشيخ الشربيني إن «أسماءهم مثل أسماء العفاريت أو رقع الشلاتيت»، وإنهم وضعوها لتناسب ذوقهم.
لكن لعل الغرض من التسمية هو ما يفرق بين أهل المدن وأهل الريف، فأهل المدن يختارون الأسماء لغرض الوجاهة والطموح الاجتماعي، بينما أهل الريف أكثر تواضعًا وعلى السجية، فيختارون أسماء مرحة محببة كي ينضم العضو الجديد إلى الجماعة دون إثارة الحقد أو العداوة، مثل تسميتهم شلاطة ولهاطة. وربما سبب آخر أثار حفيظة الشيخ، هو مط الكلام عند أهل الريف، الذي يدل على الكسل أو عدم الحماس، وهما صفتان مكروهتان لمن يرغب في النجاح في المدينة، ولهذا يأتي استنكاره لاستخدام أهل الريف عند النداء لفظ «هاه» و«هيه».
الطعام: أيا مطيب الجلبان والعدس إذا استوى

الطعام، بالطبع، كان حاضرًا في الكتاب. فألف الشيخ خطبة في المأكولات جاء فيها: «أيها الناس ما لي أراكم عن الزردة بعسل النحل غافلين، وعن الأرز المفلفل باللحم الضاني تاركين، وعن البقلاوة في الصواني معرضين، وعن الإوز السمين والدجاج المحمر لاهين، فما هذا يا إخواني إلا أحوال المفلسين».
وخطبة أخرى: «اللهم أدم النصر والتأييد والثبات، ولِمَّ الشمل بعد الشتات، ببقاء السلطان السكر النبات، ابن القناني، من أصله من القصب المَلَّواني، وأيِّده بأرماح القصب، وبسائط الرطب، وعناقيد العنب».
قلة الطعام في العصور القديمة جعلته حاضرًا في خيال الناس، يتفكهون بذكره ويتندرون بتمنيهم لأصنافه الشهية، فكان حديثهم عنه شبيهًا بحديث المحبين. وفي قصيدة أبي شادوف يحكي الشاعر عما سيفعل لو وجد أمامه ما يعجبه من المأكولات:
أَيَا مطيب الجلبان والعدس إذا استوى، وشرش بصل حولُو وميت رغيف
أيا محسن الخبز المقمر على النَدَّه، وفوقُو من السرسوب حلب نضيف
واقعد على ركبه ونص واشمَّر، عن الكف بيدي ما أخاف مُخيف
أنواع الطعام التي ضمتها قصيدة أبي شادوف هي الكِشْك، والمدمس، والبيسار، وبليلة، والمِش، وأم الخلول، والمشكشك، والخبيز، والفول المشيوي، والفطير، والجُلبان، والعدس، والخبز المُقمر، والرز باللبن، والجُبينة الطرية، والهَيطلية، والمصبوبة، ومفروكة اللبن الفسيخ، والسمك، والكرش، والترمس.
يشرح المؤلف طرق طهي الأطعمة السابقة، والفرق في المذاق والوصفات بين أهل بلاد البحر وأهل الكفور والصعيد والأتراك ممن سكنوا مصر أيامها، ثم يذكر إذا اقتضى المقام الفوائد الطبية لهذا الطعام أو ذاك، وما جيء بشأنه في كتب الأدب والطب والتراث، ويبين موقع هذه الأنواع في نفس الشخص الريفي: هل هو طعام هين أم طعام الأكابر؟ هل يجدونها دومًا أم أنها لا تُرى سوى في الأعياد؟
العدس كمثال: «في القانون الإكثار منه يورث الجذام، ويضر بالعصب، ويولد الأخلاط السوداوية. وأهل الريف يضعونه في بوشة فخار، ويحطونه في محماة الفرن، ويغمرونه بالماء حتى يستوي. أما أهل المدن، فإنهم يطبخونه طبخًا جيدًا، ويضعون عليه دهن اللية والسمن الخالص والحرارات، خصوصًا أبناء الترك، فإنهم يكثرون فيه الأدهان، وربما فعلوه باللحم الضأن».
وعلى سيرة الطعام يتحدث الكتاب عن مخرجات هذه العملية، في حين نظمت الحضارة الإنسانية أمر قضاء الحاجة بالطريقة التي تنتج أقل قدر من الإحراج والتأذي من رائحة البراز والبول وقبح المنظر.
فالريف في العصر العثماني احتفظ بوضع أكثر بساطة وسماحة، لكن المؤلف لم يترك الفرصة ليسخر من عدم معرفة الشخص القروي بالمراحيض العامة الموجودة في المدينة، ويورد أكثر من قصة لإظهار براءة القروي، أو سذاجته كما يرى.
من هذه القصص أن واحدًا من القرويين «هجم على الرجل الذي في الكنيف (مرحاض عام)، وقبض على أطواقه، ورفع ثيابه، وجلس بجانبه، وقال له: دي نقرة غويطة طويلة، أخرا أنا وايَّاك». وقصة أخرى أن جنديًا اشترى بيضًا من فلاح، ثم قال له: امضِ معي إلى المنزل لتأخذ الدراهم، لكن الجندي اضطر لقضاء الحاجة، فدخل إلى الكنيف، وأبطأ على الفلاح، فصاح الفلاح: أعطني حقي يا جندي، ما يحل لك تاخد بيضي وتخليني واقف على باب بيتك.
تعمد الكاتب التوقف عند ما يثير إحراج الناس في الحياة اليومية، فعلى سبيل المثال قَسَّم الضراط أربعة أقسام، ثم أورد كثيرًا من القصص حوله.
القرية لا تعرف المراحيض إلا أن تكون في دار الشاد أو المشد بالكفر (دار الحكم). ووفقًا للكتاب يكون مكان قضاء الحاجة وسط الزريبة، أو بجانب شجرة، أو في أي نُقرة، أو في منطقة حول القرية اعتاد الناس قضاء الحاجة فيها حتى صنعوا بذلك كومًا. يقول الشيخ على لسان أحد الشعراء:
سألتُ بني الأرياف ما لبيوتكم، مراحيض قالوا لا مراحيض للقوم
فقلت فماذا تصنعوا في نسائكم، فقالوا جميعًا نحن نخرا على الكوم
اعتمد الكتاب في إضحاكه على ربط القصص وأوصاف الأشخاص بأي شيء يتعلق بعملية الإخراج، وتكرار إيراد، بمناسبة أو دون مناسبة، ألفاظ مثل: بعرة، زبل، قلُّوط، ضراط، فساء، خراء، جلة، بول. يدرك الكاتب أن نوع الكتاب ينتمي إلى أدب المجون والخلاعة، لذا فمجال الكتاب هو كل شيء غير مقبول أن يُقال صراحةً وسط الناس في الحياة العامة، والمتعة التي يجنيها القارئ أو المستمع هي متعة هدم العالم ذي الضغوط والمسؤوليات والهموم والواجبات. تمنح قصص الطرائف هذه شعورًا بالحرية والقوة والسعادة.
تعمد الكاتب التوقف عند ما يثير إحراج الناس في الحياة اليومية، فهو على سبيل المثال أراد وصف خروج الغازات من الإنسان، فقال: الضراط على أربعة أقسام، الأول يخرج رقيقًا ضعيف الصوت ممتدًا، والثاني يجول في البطن بقرقرة، ثم يخرج ريحًا من غير صوت، والثالث يخرج ممتزجًا بالغائط، وصوته يشبه صوت قلة الماء عند امتلائها، والرابع يخرج بعنف، وله صوت عالٍ يفزع القلوب. ثم بعد تقسيمه هذه الأنواع يورد كثيرًا من القصص حول المسألة، ولا يدعها تمر.
مثال آخر وصفه للعلاقة بين الخصيتين والعضو الذكري: «الذكر في حكم الأب للخصيتين لأنه لا يفارقهما، وهما في حكم البنين له، ولهذا إن الخصيتيتن دائمًا في مقام الخضوع للذكر، وهو في مقام الرفعة عليهما، وهما أيضًا في مقام الإضافة، وهو في مقام الرفع والنصب».
الجنس: غنجها بلية، وجماعها رزية
يأخذ الشيخ على أهل الريف انفلاتهم من ضوابط التهذيب في العلاقات الجنسية، فأهل الريف، في نظره، يسارعون في إنفاذ رغباتهم دون مبالاة من لوم الآخرين أو نظرتهم. ما يكرهه الشيخ هو حركتهم العنيفة وصوتهم العالي وعدم التأني في العلاقات الجنسية، فيبتعدون عما يراه قواعد لا بد منها للجمال والذوق.
«أما نساؤهم عند الجماع فإنهن في حكم الضباع، يدخلن الأفران، ويُضرمون فيها النيران، ويعبق عليهم الدخان، ثم ينضجعون إلى شيء من القش، بعد أكلهم المدمس والبيسار، حتى يصير الشخص منهم كأنه حمار، ثم يضم زوجته إليه، وهي تتشقلب عليه، وينظر إلى عمشة عينيها، ويطرحها على جنبها، فتستغيث بربها، وتقول: أحيه جتك داهية، أحيه جتك مصيبة، أحيه جتك غارة، فغنجها بلية وجماعها رزية».
اقرأ أيضًا: المرأة في صعيد مصر: سيدة الرجل في الظلام وتابعته حين تشرق الشمس
ما يستكرهه الشيخ هو عدم اختيار أهل الريف لمكان معين لإقامة العلاقة، وتهيئة المكان بالروائح الطيبة، وعدم وضعهم مراحل للعلاقة، كأن يبدأ الطرفان أولًا بكلام الغزل، فأهل الريف لا يكترثون بقيمة الكلام وأثره، لذا ربما أتوا بأسوأ كلام يمكن أن يقال، مثل داهية أو غارة، وجعلوه في مقام الغنج والغرام.
وفي وصفه الأعراس عند أهل الأرياف يقول الشيخ: «يدور الأهالي بالعريس دورة وهم في صياح، والشعراء تمدح، والطبل يضرب، والمشاة حوله تلعب، والجدعان تخبط بالنبابيت، ثم بعد الفرح ينادي بينهم رجل: هاتوا النقوط. فيعطيه الشخص منهم الدرهم والدرهمين، والبرمكي يرمي نصفًا أو نصفين، بعد هذا يُقبلون على العروس ويكشفون عن وجهها، فإن كانت مليحة قالوا قمح زَريع أو سمسم مقشور، وإن كانت قبيحة قالوا شعير نبت فوق جسور».
وعن أهمية أول ليلة يقول الشيخ: «إنْ أخذ وجهها هنُّوه، وإلا جرسوه وهتكوه، فعُرسهم هتيكة وفرحهم مصيبة». وعند الصباحية، أي صباح اليوم الذي يلي العرس، يأتي الرجال إلى العريس ويقولون حكمنا عليك يا فلان، قوم هات العيش والمش ورطل دخان.
مما سبق يكون من المحتمل أن استهجان الشيخ لأعراسهم يرجع إلى ما رآه تَغَوُّل الجماعة على الفرد، الأمر الذي لو حصل في المدن لما طابت لأهلها الحياة.
يسرد الكتاب عددًا من القصص عن علاقات جنسية مع المُردان، أي الصبيان الذين لم تنبت لهم لِحَى، رغم التعارض بين هذا والمرجعية الإسلامية التي يتخذها الكاتب، فهو يذكر دون حرج أشعار غزل عن الصبيان، وبالطبع يأتي اسم أبو نواس.
يحكي الكتاب عن تغرير بعض المتصوفة بالغلمان، فيقول الواحد منهم للغلام: «أصب لك عمود النور في بطنك، فتنظر سائر الأولياء». ويورد قصة وقعت له شخصيًّا حين اختلائه مع الغلام حبيبه.
السؤال هنا: ما تفسير هذه الظاهرة في التراث؟ كيف لم يخشَ المؤلف، الشيخ يوسف الشربيني، من لوم وتقريع العلماء والشيوخ وهو يذكر مثل هذه الأفعال؟
نظرة عامة: وليس في البلاد مثل مصر

كتاب «هز القحوف» سبقه كتاب «الفاشوش في حكم قراقوش» للكاتب المصري ابن مماتي، المعاصر لحكم صلاح الدين الأيوبي، وكذلك ديوان «نزهة النفوس ومضحك العبوس» للكاتب المصري ابن سودون، أحد شعراء القرن التاسع الهجري المعاصر لحكم المماليك، وذكر المؤلف أن غرضه من الكتاب أن يحاكي به كلام ابن سودون.
ابن سودون كان شاعرًا غير عادي يتوقف عنده من جاء بعده، ولعله صاحب الفضل في رفع شأن الفكاهة في الأدب باعتبارها عملًا فكريًّا. من
من شعر ابن سودون الذي يورده شوقي ضيف في كتابه «في الشعر والفكاهة في مصر» على سبيل المثال:
إذا ما الفتى في الناس بالعقل قد سما، تيقَّن أن الأرض من فوقها السما
وأن السما من تحتها الأرض لم تزل، وبينهما أشيا متى ظهرت ترى
وكم عجب عندي بمصر وغيرها، فمصر بها نيل على الطين قد جرى
وفي نيلها من نام بالليل بله، وليست تبل الشمس من نام بالضحى
سخرية صاحب الكتاب من الفلاحين أمر مستنكَر قطعًا، وإن كان شخص على هذه المعرفة الدقيقة بحياة الريف لا بد أنه قضى وقتًا طويلًا في القرى، فربما الكاتب ينتحل شخصية أخرى عند الكتابة هي شخصية عالم أزهري ابن الكتب والتراث، يتعجب من أمور الناس كأنه قادم من زمن آخر.
ما يدعم هذه الفرضية أن المؤلف يقول إن ما حمله على تأليف الكتاب هو شيخه أحمد السندوبي، الذي من اسمه يظهر أنه من بلدة سندوب في دلتا مصر، ويفتخر الكاتب كثيرًا ببلدته شربين، التي هي كذلك إحدى بلدات الدلتا.
وفي أُرجُوزة أتت في نهاية الجزء الأول من الكتاب ربما رغب الشيخ يوسف الشربيني أن يخفف من حدة لهجته، فذكر أن البلدان التي عرضها بلدان بعيدة عن النيل، وليست مصر بالتأكيد، ومصر يقصد بها القاهرة:
وكل هذا في قرى قد بعدت، عن نيلنا وبالجبال اتصلت
وليس في البلاد مثل مصر ، وأهلها كُفيتَ شر الحصر
لأنها كنانة الله وَرَدْ، ونيلها يُجلي برؤياه النكد




