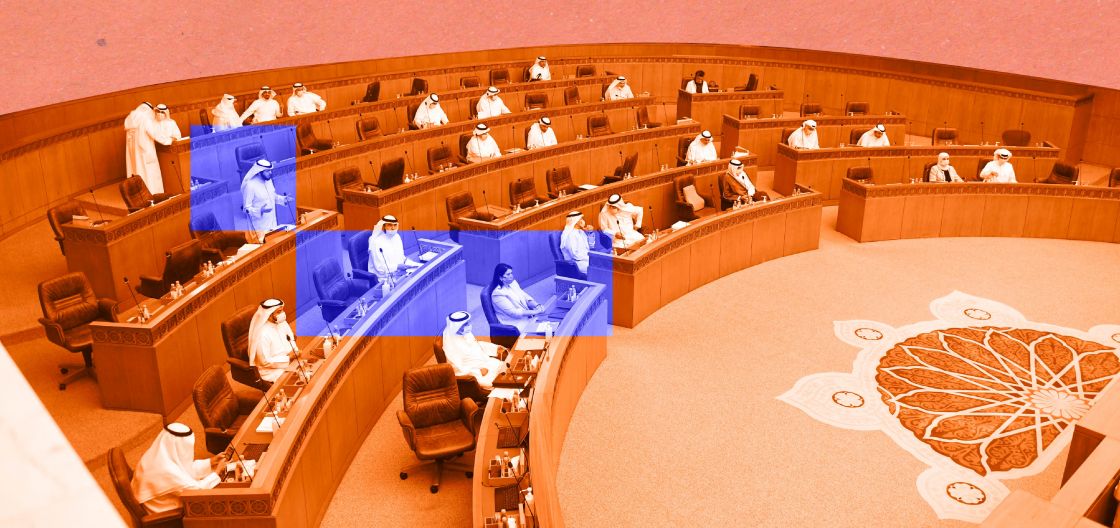ما نراه اليوم في الساحة السياسية الكويتية من تناقضات وهشاشة للتحالفات، ما هو إلا نتيجة خلل عميق في بنية النظام السياسي. في الغالب يركز عامة الناس على النتائج الظاهرة لهم مثل قضايا الفساد، أو قصر عمر الحكومات بسبب التعطيل والتأزيم من مجلس الأمة وغياب تجاوب مجلس الوزراء، أو الصراع بين أقطاب المعارضة والتهم المتبادلة، وعمليات شراء الولاء السياسي.
ونتيجة لهذا التصور السطحي تصبح النظرة للحل مقتصرة على مطالبات تتعامل مع النتائج، لا الأسباب التي أدت إليها، من قبيل «رحيل الرئيسين»، وليس إصلاح المنظومة التي مكنتهما من السلطة، والتي أوصلت قبلهما شخصيات مشابهة مثل جاسم الخرافي وناصر المحمد.
ورغم تغيرهم بعد 2011 فإن المشهد لم يتغير، لأن قواعد اللعبة ظلت ثابتة وهي نظام الصوت الواحد، والحكومة التي لا تنبثق عن المجلس، وغياب مؤسسات المجتمع المدني وتحديدًا الأحزاب السياسية، وقدرة الأمير على حل المجلس، والمحاصصة السياسية كوسيلة لكسب تأييد البرلمان والمكونات الاجتماعية المختلفة.
لهذا نركز هنا على الأسباب التي تعيد إنتاج كل هذه الظواهر. أناقش ما قد أسميه «أصل العلَّة»، لأحاول اكتشاف جذور الخلل في النظام الكويتي العالق في مكانه منذ بداية الستينيات، فلا هو ديموقراطي بحكومة ذات أغلبية برلمانية قادرة على الإنجاز، ولا سلطوي يتمتع بمركزية في صنع القرار مما يسهل عليه تحقيق مشاريعه التنموية وتصوراته لشكل الاقتصاد والمجتمع والدولة.
سأطرح تصورًا بديلًا في ما يمثل مقترح تسوية للإصلاح السياسي ليست مثالية ولكنها ضرورية وممكنة، على أن يسبقها حوار وطني شفاف وعلني، يُشرك جميع القوى الفاعلة في تحديد مستقبل البلد، ويقود لتعديلات دستورية شبيهة بما حصل في المغرب بعد أحداث الربيع العربي.
أنا هنا أكتب بصفتي مواطن عربي محب للكويت، وأنظر لها كأمل ونموذج لديه مقومات النهوض لتحقيق تجربة ديمقراطية وتنموية خليجية تراعي كرامة الإنسان وحقوقه. ولا أدعي أن ما أطرحه يمثل حلًا نهائيًا للأزمة الحالية، بل محاولة لعرض فكرة أراها واقعية وطموحة وقابلة للحدوث.
التاريخ كمفسر للواقع

الكويت عالقة في فجوة مفرغة وعاجزة عن المضي قدمًا في مواجهة تحديات مهولة، مثل العجز في الموازنة الذي وصل لأرقام هي الأعلى في تاريخ البلاد: 10.8 مليار دينار، أي ما يعادل 35.5 مليار دولار. وهي أكثر دول الخليج والشرق الأوسط اعتمادًا على النفط بعد العراق، إذ يشكل 90% من إجمالي الصادرات.وهناك بطء واضح في إصدار التشريعات أو اعتماد المشاريع التنموية، ناهيك عن مسألة تنفيذها والتي قد تطول لسنين وعقود طويلة.
ولكل هذه الأسباب يمكن القول إن المنظومة البيروقراطية الكويتية مصممة بشكل يجعل دماء المشاريع والقوانين تتوزع بين الحكومة والبرلمان، وكل المكونات الاجتماعية شريكة في عملية المحاصصة، وتعيش حالة من العلاقة الزبائنية مع الحكومة؛ مما يجعل المتابع غير قادر على اكتشاف موطن الخلل أو المتسبب في الفساد، ويجري تراشق التهم بين مختلف الأطراف في دوامة تعيد إنتاج ذاتها بشكل مستمر، دون أن يتحقق التغيير أو يتحمل أي طرف المسؤولية عن الوضع الراهن.
لفهم «أصل العلَّة» التي أنتجت هذا الحال، لا بد من العودة لظروف نشأة النظام السياسي الحالي، وموطن الخلل الدستوري الذي يجعل البلاد غير قادرة على المضي قدمًا، وهنا تكمن أهمية التاريخ كمفسر للواقع.
شهدت الكويت تجربة سياسية استثنائية جعلتها تتميز عن بقية دول الخليج، فقد كانت منذ البداية دولة تقوم على التوافق النسبي بين الحاكم والمحكوم؛ فلم يتأسس حكم آل الصباح بالقوة أو الإكراه، وإنما الشراكة والتفاوض السلمي بين مراكز القوى التقليدية (الأسرة المالكة، وطبقة التجار، والقبائل البدوية، والمذاهب، والحضر من سكان مدينة الكويت).
وهنا لا بد من الالتفات لطبيعة العلاقة بين الشيوخ والتجار، أهم القوى السياسية الفاعلة قبل ظهور النفط، إذ كانوا يتقاسمون الأدوار في ما بينهم ويدعمون بعضهم البعض؛ فالنظام السياسي يقوم على التمويل والدعم المالي الذي يأتيه من التجار آنذاك، وفي المقابل يحافظ الشيوخ على الأمن والاستقرار؛ مما جعل الكويت قبلة لكثير من العوائل التجارية في القرن التاسع عشر.
تطورت هذه العلاقة من الشراكة في صيغتها التقليدية إلى نظام مؤسسي في مجلس شورى 1921 بالتعيين، ومن ثم مجلس استشاري منتخب 1938، وصولًا إلى مجلس الأمة بعد اعتماد دستور الكويت الدائم في 1962.
ورغم سرعة التطورات التي حدثت منذ 1921 إلى 1962 مع إعلان الدستور الدائم، فإن المرحلة التي تلتها كانت بها انتكاسات كثيرة مثل تزوير انتخابات 1967 وحل المجلس مرتين بشكل غير دستوري (1976 و1986)، وما صاحبه من تعليق للعمل بالدستور وتعطيل للحياة السياسية في المرة الأولى قرابة الأربع سنوات، وفي الثانية استمرت إلى ما بعد غزو العراق، وغيرها من الأزمات والتجاوزات من السلطة التنفيذية.
إلى أن وصلت البلاد إلى حالة من التسوية أو الوفاق بعد الغزو، وذلك نتيجة لضغوط داخلية من قبل المعارضة آنذاك، وأخرى خارجية تتعلق بصورة الكويت أمام العالم أثناء الغزو. لينعقد بعد كل هذا مؤتمر جدة الشعبي، الذي جمع الحكومة والمعارضة وأعاد الاعتبار للدستور، وكانت به دعوة للوحدة الوطنية مع التمسك بالمكتسبات وضرورة عودة الحياة النيابية.
بعد مسيرة طويلة من التدافع بين مختلف مراكز القوى، أدت هذه التحولات والتراكمات التاريخية إلى ملكية شبه دستورية، فيها بعض القيم الديمقراطية مثل شراكة الشعب في صنع القرار، من خلال انتخاب السلطة التشريعية والفصل بين السلطات نسبيًا، والرقابة على أداء السلطة التنفيذية، وسلطة سحب الثقة من الوزراء، والحق في عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء مما قد يؤدي إلى إعفائه من قبل الأمير، أو إعادة تشكيل الحكومة مرة أخرى من قبل نفس الشخص، وهو ما كان يحصل في معظم الحالات.
أصل العلة

أدى هذا الوضع لحالة من التأزيم المستمر وانغلاق الأفق السياسي، وخير دليل على ذلك عدد الحكومات منذ استقلال الكويت (1961) إلى اليوم، فهنالك تقريبا 39 تشكيلة وزارية بمعدل حكومة كل سنة ونصف كمتوسط، من بينها 16 حكومة لم تكمل عامًا واحدًا.
وفي آخر السنوات ازداد الوضع تعقيدًا، ليصبح متوسط عمر بعض الحكومات بالأشهر والأيام، أو حكومات تصريف أعمال بحكم الأمر الواقع. والذي جعل الأمر أكثر تعقيدًا أن من يتولون مهمة رئاسة الحكومات غالبًا نفس الأشخاص من الأسرة المالكة، رغم صداماتهم الكثيرة مع مجلس الأمة. مثال على ذلك ترؤس ناصر المحمد لسبع حكومات رغم علاقته المتوترة مع المجلس في معظم الفترات، مما خلق جوًا مشحونًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأدى لحالة من غياب الانسجام بين الطرفين، فأصبحا غير قادرين على تحقيق رؤية مشتركة أو خطة عمل واضحة.
مثال آخر على انغلاق الأفق أن هنالك 9 مجالس تقريبًا حُلَّت قبل أن تكمل مدتها، وغالبا تكون للمعارضة أغلبية فيها. بينما هنالك 7 مجالس فقط أكملت مدتها، وغالبًا تستمر لثلاث أسباب: إما لضعف تمثيل المعارضة فيها بسبب مقاطعة الانتخابات، أو لقدرة الحكومة على استمالتها بالمناصب والهِبات وتبني بعض المطالب الشعبية، أو من خلال تفكيك المعارضة وتشتيت شملها.
ولأن الحكومات لا تنبثق من المجلس وليس لديها مشروع مقنع، تتجه غالبًا لشراء الولاء السياسي وتلبية مطالب مَن يسمون بنواب الخدمات، مما يكرس ثقافة المحسوبية ويشرعنها، بل ويجعلها حالة طبيعية في النظام السياسي. وهذا يثقل كاهل الدولة، ويجعل الإنفاق الحكومي يتجه لبند الرواتب أكثر من المشاريع والاستثمارات التي تحقق مصلحة البلاد على المدى البعيد، لتصبح وظيفة الحكومة محاولة البقاء والاستمرار أكثر من التخطيط للمستقبل، فهي تبحث عن المكاسب السريعة لا أكثر.
كشفت دراسة برلمانية في 2017 أن 79% من موظفي الدولة يعانون من البطالة المقنعة، وأن الترهل الإداري في الكويت عالٍ جدًا مقارنة بالمتوسط العالمي. من دلائل هذا أن 71% من إجمالي موازنة 2021/2020 اتجهت لبند الرواتب والدعوم. ولذلك هنالك أكثر من 354,229 من المواطنين يعملون في القطاع الحكومي، يشكلون 85% من إجمالي المشتغلين في الكويت، بينما العاملون في القطاع الخاص يشكلون 15% فقط.
إذا قسنا هذا على بعض الدول الخليجية سنجد أن سلطنة عمان مثلًا لديها 54% من المواطنين يعملون في القطاع الخاص وليس الحكومي، ودولة خليجية أخرى مثل السعودية لديها خطة طموحة لجعل 65% من القوى العاملة الوطنية تعمل في القطاع الخاص بحلول 2030
التغيير والبدائل

المنظومة الحالية في الكويت توفر بيئة خصبة للفساد والمحسوبية والترهل الإداري، ولا يمكن أن يتغير حالها دون إعادة هيكلة النظام السياسي، وهذا لا يعني بالضرورة إحداث تغييرات راديكالية غير واقعية، أو تبني نموذج سياسي مشابه لدول الخليج الأخرى التي تعاني من التفرد السياسي وضعف المشاركة الشعبية وتراجع مساحة حرية التعبير.
البديل يجب أن ينطلق من واقع الكويت وخصوصيتها الثقافية، وأن يراعي طبيعة المجتمع الكويتي الذي اعتاد على الحرية والحق في المشاركة السياسية. نعم لا بد أن يلبي النموذج الطموح والتطلعات، ولكن دون أن يتجاهل مراكز القوى في المعادلة السياسية.
الواقع المتعثر يستدعي إيجاد تسوية مختلفة لشكل العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة، تقوم على فكرة الفصل بين الوزارات الخدمية والسيادية، بحيث تتبع الوزارات السيادية (الديوان والدفاع والداخلية والخارجية) أميرَ البلاد والأسرة الحاكمة بشكل عام، بينما يرأس بقية الوزارات وزير أول من عامة الشعب، يمثل الحزب أو الكتلة ذات الأغلبية في المجلس.
النموذج المغربي

هذا النموذج البديل يستدعي وجود حوار وطني قبل أي شيء، لتنبثق عنه تعديلات دستورية تنال تأييد ثلثي الأعضاء في المجلس ويصادق عليها الأمير، وقد يكون من الجيد لو عُرضت للاستفتاء الشعبي حتى تنال درجة أعلى من الشرعية. وهذا سيكون مشابهًا للتعديلات الدستورية المغربية التي حصلت بعد حركة 20 فبراير في المغرب بالتزامن مع ثورات الربيع العربي، إذ شُكِلت لجنة لصياغة تعديلات دستورية مهمة، مثل إلزام الملك بتكليف رئيس الوزراء من الحزب أو التحالف الذي لديه الأغلبية في البرلمان.
في حالة الكويت يجب السماح بوجود الأحزاب أولًا، وتغيير نظام الصوت الواحد ليتوافق مع طبيعة العمل الجماعي، إذ لا يمكن أن يعمل أي برلمان وتتشكل منه حكومات لديها برامج بناءً على أفراد لا يجمعهم أي تصور. من الخيارات البديلة لنظام الصوت الواحد، نظام التمثيل النسبي، بحيث يكون التصويت مبنيًا على نظام القوائم التي بها أكثر من شخص في أكثر من دائرة، ويصوت الشعب هنا بناءً على البرامج التي تحملها هذه الأحزاب والكتل البرلمانية، بحيث يكون لديها مشروع واضح قبل دخولها للمجلس، وتصبح فعلًا قادرة على تحقيق التغيير بعد حصولها على الأغلبية أو تحالفها مع الأحزاب والكتل الأخرى لتشكيل الحكومة، وبهذا تكون محاسبة ومسؤولة أمام الشعب عن كل ما له علاقة بالوزارات الخدمية.
من التعديلات المهمة في المغرب أن يكون لرئيس الوزراء الحق في تشكيل حكومته بعد التشاور مع الملك ونيل الأغلبية البرلمانية، مما يعني وجود انسجام بين وزراء الحكومة في ما بينهم، وكذلك تمتعهم بأغلبية برلمانية. على الجانب الآخر في الكويت، غالبًا يقوم مجلس الوزراء على محاصصة طائفية وقبلية، وفيه محاولة لاسترضاء واحتواء مراكز القوى في العملية السياسية، مما يجعل الحكومة في النهاية مشكّلة من وزراء غير منسجمين ولا يجمعهم توجه أو مشروع، وإنما أفراد يعمل كل واحد منهم بشكل منعزل عن الآخر، كجزر متشظية في المحيط لا تجمعها أرضية مشتركه، تتلاطمها الأمواج من كل حدب وصوب. قد يكون هناك تضامن بين أعضاء مجلس الوزراء، لكن الحكومات لا تقوم على مجرد التضامن، وإنما هي بحاجة لتصورات وتوجهات مشتركة حتى تعمل على رؤى منسجمة تحقق أهدافًا واضحة وقابلة للقياس.
إضافة لذلك، ركزت التغييرات في الدستور المغربي على تسليم عدد من الحقوق لرئيس الوزراء، بما في ذلك حل البرلمان وتعيين كبار الموظفين، ليس فقط في الحكومة بل بالشركات الحكومية كذلك. مُنح البرلمان أيضًا حق منح العفو، بعدما كان ذلك في السابق من صلاحيات الملك فقط. وكذلك أن يكون نظام القضاء مستقلًا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية؛ فلا يمكن ضمان أي إصلاح سياسي أو نزاهة العملية الديمقراطية واستمراريتها دون قضاء مستقل.
وأخيرًا، شملت التعديلات قضايا أخرى تتعلق بحقوق الأقليات والمكونات الثقافية واللغوية مثل الأمازيغ، وهي ليست محور نقاشنا في هذا المقال، إلا أنه من الواجب الإشارة إلى أهمية مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية وتمثيل الفئات المهمشة، حتى لا تكون مثل القنبلة الموقوتة التي قد تنفجر في أي لحظة أمام النظام (البدون مثالًا، كقضية يجب النظر لها ومنحها الأولوية في أي عملية إصلاح سياسي أو تعديلات دستورية في الكويت).
المملكة المغربية قد لا يكون حالها مثاليًا، ولكنها على الأقل خرجت بأقل الخسائر من ثورات الربيع العربي، بل حققت تقدمًا واضحًا في الانتقال السلمي للسلطة، وإشراك كل الفئات في العملية السياسية، من إسلاميين ويساريين اشتراكيين وتيارات قومية يمينية وليبرالية متعددة. وفي نفس الوقت ارتفعت معدلات النمو الاقتصادي في المغرب لتصبح من بين الأعلى في العالم العربي في الفترة الممتدة من 2011 إلى 2021.
يمكن القول إن المغرب هو الرابح الأكبر أو الوحيد في المنطقة العربية بعد أحداث ما سمي بالربيع العربي، إذ تحولت معظم الاحتجاجات إلى حروب أهلية (ليبيا واليمن وسوريا)، أو نجحت الثورات نسبيًا مقابل تدهور الاقتصاد مثل تونس (وهو ما تسبب بعد ذلك في توفير بيئة حاضنة للثورة المضادة وأدى لانقلاب قيس سعيد)، أو زادت القبضة الأمنية والمعالجات البوليسية مثل مصر ودول الخليج.
أدت هذه العوامل لجعل الاقتصاد المغربي الأكثر تنوعًا في العالم العربي، إذ تنتعش فيه قطاعات السياحة والصناعة والزراعة واللوجستيات والطاقة المتجددة والخدمات. في الصناعة مثلًا، هناك أرقام مبهرة في ما يخص صناعة السيارات (تجاوزت إيراداتها 8 مليارات دولار في 2021) وأجزاء من مكونات الطائرات وتوطين التقنية، لتتجاوز الصادرات الصناعية حجم الصادرات الزراعية. أما القطاع السياحي فقد وصل لأرقام قياسية هي الأعلى في إفريقيا، إذ تجاوز 13 مليون سائح قبل جائحة كوفيد-19.
كل هذا في ظل تحسن البنية التحتية من مطارات ومواني، جعلت من المغرب بوابة أفريقيا والجسر الذي يربطها بأوروبا، وقطارات فائقة السرعة وطرق سريعة دعمت التحول لنظام لامركزي تتوزع فيه التنمية بشكل جيد بين المناطق والجهات. كل هذه المؤشرات تدل على أن المغرب تمكن من الخروج بصيغة متوازنة شملت إصلاحات سياسية كبيرة مع الحفاظ على الاقتصاد، وهي معادلة صعبة الحصول.
لا شك أن المغرب لا يزال يعاني من كثير من المعضلات، خصوصًا في مسائل التعليم ومحو الأمية وتزايد الطبقية وعدم وجود عدالة في توزيع الثروات، مع تحديات سياسية كبيرة في صراع الصحراء الغربية وحركة البوليساريو والخلافات الحادة مع الجزائر، مما يعطل التجارة الإقليمية وغيرها من الملفات العالقة إلى الآن.
لكن النظام السياسي يتقدم، والتجربة الديمقراطية في تطور ملحوظ، والأوضاع الاقتصادية تتحسن، وكل هذا يدفعنا للاعتراف بضرورة الاستفادة من التجربة المغربية في الإصلاح السياسي. السياسة فن الممكن، وإذا لم يكن بالإمكان تحقيق التطلعات، فلا يجب الرجوع إلى الخلف أو القبول بالوضع كما هو. هذا الحل ليس مثاليًا ولكنه قابل للحدوث، لأنه يحفظ للأسرة المالكة مكانتها ودورها ويجنبها الصدام مع الشعب.
وهي فعليًا ليست مجرد سلطة شرفية أو بروتوكولية، فالأمير والأسرة في الكويت حسب المقترح الذي أقدمه هنا ستكون لهم السلطة السيادية في وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والديوان، وهذا يبعدهم عن الإشكالات الدائمة التي تصاحب الوزارات الخدمية، وهي معنية بحياة الناس اليومية، وغالبًا لا يرضون عنها. سياسات التوطين مثال على ذلك، فقد ترضي الباحثين عن عمل، ولكنها تغضب التجار. أو توجهات الإعلام، فسيكون هنالك مؤيد ومعارض لها بشكل دائم، خصوصًا بين المحافظين واليساريين. أو السياسات المتعلقة بالترفيه والسياحة وكيف تنقسم حولها فئات المجتمع. وفي نفس الوقت يضمن المقترح وجود أغلبية للحكومة الخدمية في البرلمان، مما يساعدها على الإنجاز في المشاريع والتشريعات، وتكون مراقبة ومحاسبة بالكامل من مجلس الأمة.
فك انغلاق الأفق

واقعيًا، ستنبثق حكومة الوزير الأول الخدمية من البرلمان، أي أنها لن تصل للسلطة إلا إذا كانت لديها أغلبية برلمانية وهذا يعني قدرتها على وضع برنامج ورؤية اقتصادية واجتماعية وسياسية متكاملة للبلد، وبطبيعة الحال ستكون مسؤولة بشكل واضح ومباشر عن كل الشؤون الخدمية مثل التعليم والصحة والبلديات والتجارة والصناعة والسياحة والعمل والأشغال، وحتى النفط والغاز والمالية. وهنا يكون للناخب الحق في محاسبة هذه الحكومة من خلال الصندوق والانتخابات كل أربع أو خمس سنوات، حسب ما يُتفق عليه.
وحتى لا يكون هناك صراع دائم حول الموازنة، من الجيد أن يكون هناك اتفاق دائم على النسب بين الوزارات السيادية التابعة للأمير والوزارات الخدمية التابعة للوزير الأول أو رئيس الوزراء. مثال على ذلك أن تنال الوزارات السيادية 20% من إجمالي الموازنة، وأن تتجه البقية للوزارات الخدمية. وهذه النسب قد تتغير في حالات الطوارئ التي يجب أن يُفصلّها الدستور، مثل الحرب والكوارث الطبيعية وغيرها.
هذه مجرد أرقام مقترحة، ويمكن الاتفاق على التفاصيل بناء على الحوار بين الطرفين. المهم أن تكون العملية واضحة ومقننة ومفصلة، وألا تُترك للأهواء والنوايا. تبعية وزارات مثل المالية وملفات مهمة مثل الضرائب لحكومة الوزير الأول سيجعل الأمير والأسرة بعيدة عن هذا الصراع، فتصبح العملية بين الأحزاب والكتل السياسية.
اعتاد أعضاء مجلس الأمة سواء من المعارضة أو الموالاة على خطابات غير واقعية سياسية، فهي ترفض أي سحب للدعم أو الضرائب، وفي نفس الوقت تنتقد الاقتصاد الريعي. الضرائب في حد ذاتها ليست مشكلة إذا أُعيد إنفاقها في الاقتصاد بشكل عادل وحُصّلت من الغني للفقير، فهي من أشكال إعادة توزيع الثروة، وأكثر المجتمعات تقدمًا تضم أنظمة ضريبية، وخير مثال على ذلك الدول الإسكندنافية.
المهم هو اختيار النظام الضريبي المناسب، مثل الضرائب على الأراضي الفضاء والضرائب على أصحاب الدخل المرتفع وضرائب الثروة، وليس ضريبة القيمة المضافة التي تأخذ من الفقير والمحتاج والعاطل عن العمل أكثر من الغني وصاحب الدخل العالي. وبهذا عندما تصبح المعارضة أو أي مكون آخر في السلطة ولديها الوزارات الخدمية، ستكون مجبرة على قبول هذه الإكراهات وبناء نظام ضريبي لتمويل مشاريع الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية. حينها لن تكون هناك مزايدات في الخطاب، وإنما مسؤوليات مباشرة وخطط عمل واضحة وبرامج اقتصادية يجب تنفيذها في وقتها.
الوزارات الخدمية لم تعد غنيمة أو وسيلة لشراء الولاء السياسي للمواطنين، فسابقًا كان يُنظر إلى أبسط خدمة مثل فتح مدرسة أو شارع أو توصيل الكهرباء والمياه كإنجازات كبيرة، تستوجب شكر المجتمع الحكومة عليها. اليوم تغير الوضع، وهذه الخدمات أصبح الشعب ينظر لها كحقوق بديهية مترتبة على كونهم مواطنين في البلد. وفي نفس الوقت أصبحت الحكومة تتحدث عن ضرورة ترشيد الإنفاق وتغيير نمط العيش، بينما يرتفع سقف التوقعات والتطلعات من الأجيال الصاعدة للحديث عن ملكية دستورية كاملة ورئيس وزراء منتخب وفصل كامل بين السلطات ووجود رقابة وشفافية، فلا ضرائب دون تمثيل سياسي.
لذلك إذا لم تواكب الحكومة هذه التغيرات في طبيعة العلاقة بين الطرفين، فإن انغلاق الأفق السياسي وتوقف التنمية الاقتصادية سيبقى ويتعمق أكثر في الكويت. ولذلك فإن فكرة الوزير الأول، والفصل بين الوزارات السيادية والخدمية، والسماح بالأحزاب السياسية، وتغيير نظام الصوت الواحد، وإيجاد تعديلات دستورية جديدة، تمثل عقدًا اجتماعيًا جديدًا يشارك الكل في صياغته ويُستفتون عليه، وهذا في رأيي الحل والمخرج الآمن من النفق المظلم الذي تعيش فيه الكويت حاليًا.