إن التاريخ الخليجي أو تاريخ الدول والمدن في الخليج العربي كُتب بعضه ولا يزال يكتب بعضه الآخر بطريقة تراعَى فيها المحرمات الثلاثة على الباحث، خصوصًا الخليجي:
- مخالفة السياسات العامة للأسر الحاكمة
- مخالفة التيار الديني السائد (سني – شيعي - إباضي) في هذه الدول
- مراعاة التغير الاجتماعي والثقافي لسكان دول الخليج
هذا التاريخ المسكوت عنه خوفًا أو طمعًا هو ما يسمى «التاريخ المهمش»، فهو ليس تاريخًا هامشيًا من ناحية قيمته التاريخية، ولكنه تاريخ هُمش بسبب ما سبق ذكره من الثالوث المحرم عند كتابة التاريخ في الخليج.
الأمثلة على هذا التاريخ المهمش كثيرة، منها ما هو سياسي مثل الصراع على السلطة بين أسر سادت ثم بادت مع أسر تحكم اليوم، ومنها ما هو ديني أيديولوجي كموضوع مقالنا هذا، ومنها ما هو اقتصادي اجتماعي كنقاش مهنة الغوص على اللؤلؤ بطريقة أكثر عمقًا وفهمًا لميكانيكية هذه المهنة، والعلاقة بين رأس المال والعمال بشكل أكثر تفصيلًا.
هذا التهميش وغياب النقد البناء أبرزا مشكلتين هما، من وجهة نظري، كتابة التاريخ السردي دون منهجيات واضحة يمكن محاكمتها، الأمر الذي أسهم في بروز إشكالية الهوية والتي تناقش اليوم بشكل أكثر عمقا من العقود السابقة.
المشكلة الثانية، مما سنناقشه في هذا المقال كذلك، هي ظهور الكتابة بشكل متحيز، إما سياسي أو ديني وربما فئوي أو مناطقي وقبلي، وهذا التحيز مرتبط ارتباطًا وثيقًا بغياب المنهجية الواضحة للكثير من المؤرخين الخليجيين على وجه الخصوص، فأفكارهم الخاصة واعتقاداتهم السياسية والدينية أُدخلت قسرًا في التاريخ، وصار بعضهم يبحث في التاريخ وفي ذهنه نتيجة مسبقة، ولا يبحث في التاريخ ليصل لأقرب نقطة من الحقيقة.
هنا نحاول تسليط الضوء على جزء بسيط من إشكالية/مشكلة التاريخ المهمش في الخليج بشكل عام، وتاريخ نجد والكويت والزبير بشكل خاص، وذلك من خلال مناقشة نسبة العلماء للبلدان التي وُلدوا فيها أو هاجروا منها أو استقروا فيها، وكيف أن بعض الكتابات التاريخية في العقود الأخيرة صنفت هؤلاء العلماء تصنيفات متناقضة، حتى أن بعضها خالف ما دَوَّنه هؤلاء العلماء في مخطوطاتهم وكتبهم عن نسبته، دون أن يوضح هؤلاء الباحثون الأسباب التي دعت أولئك العلماء إلى اتباع مثل هذا التصنيف.
الانتساب للبلدان في منهجيات التاريخ الإسلامي

عند البحث في كتب التراجم التي كُتبت في الحضارة الإسلامية، نجد أن هناك منهجيات اتبعها المؤرخون المسلمون في تلك الحضارة للترجمة وتدوين تاريخ العلماء والأعيان. هذه المنهجيات تساعدنا في فهم كيف نُسب العلماء والأعيان، ولمن نُسبوا في كتب التاريخ، خصوصًا تلك الكتب التي ناقشت تواريخ المدن.
عند مقارنة ما سبق مع ما كُتب في العقود الماضية في العالم الإسلامي عمومًا والخليجي تحديدًا، نجد أن هناك تلازمًا وتشابهًا بين منهجية ما كُتب وأُرخ له خلال القرن العشرين وأيامنا هذه في تاريخ الخليج العربي، من الناحية المنهجية مع مؤرخي الحضارة الإسلامية.
لا شك أن هناك بعض الاختلاف بين منهجيات الباحثين اليوم ومنهجيات مؤرخي العصور الإسلامية السالفة، إذ أن المنهجيات السابقة كانت أكثر وضوحًا ودقة مما كُتب في السنوات الثلاثين الأخيرة، خصوصًا من ناحية وضوح المنهجية، فباحث اليوم لديه إشكالية في تحديد انتماء العلماء على وجه الخصوص لدولة قُطرية حديثة النشوء، وقد يكون هناك تداخل مع مفهوم الهوية الوطنية الحديثة، لكن هذا ليس الموضوع الذي نتناوله هنا.
يذكر الباحث السعودي محمد بن عبد الله الرشيد في كتابه «ألقاب الأسر»، أن الأسباب تتنوع إذا تعلق الأمر بالألقاب لاعتبارات كثيرة، منها اختلاف الأقاليم والبلدان والعادات والطباع. واللقب في الغالب يرجع لغلبة شيء على شيء، مثل غلبة النسبة إلى القبيلة أو المهنة والصنعة، وقد تكون الغلبة للبلدان، وهذه الغلبة هي ما نبحث عنه.
التاريخ الإسلامي حافل بنسبة الأعيان (والعلماء على وجه التحديد) إلى البلدان، كالمكي والمدني والقاهري والدمشقي والبغدادي، ويَذكر الرشيد أن النسبة للبلدان انتشرت بشكل كبير عند المصريين أكثر من غيرهم. ويقول الباحث المصري ياسر نور في بحثه «الأبعاد الحضارية في كتاب الأنساب للسمعاني»، إن هناك متغيرًا دخل على منهجية الأنساب عند العرب بعد حركة الفتوحات، وانتشار العرب في المدن و الأمصار التي فتحوها. هذا الاستقرار أدخل انتسابًا جديدًا للعربي، فصار يُنسب إلى البلد التي يسكنها أو الحرفة التي يشتغل بها، ولهذا يقول الحافظ العراقي:
وضاعت الأنساب في البلدان فنسب الأكثر للأوطان
أما «البغدادي» فهو من الألقاب التي تَلقب بها صاحب كتاب «تاريخ مدينة السلام»، وكانت له منهجية واضحة عند تأريخه لتراجم الأعيان في بغداد وما جاورها، إذ نجد أن الخطيب البغدادي في كتابه يقول: «تسمية الخلفاء والأشراف والكبراء والقضاة والفقهاء والمحدثين والقراء والزهاد والصلحاء والمتأدبين والشعراء من أهل مدينة السلام الذين ولدوا بها وبسواها من البلدان ونزلوها، وذكر من انتقل عنها ومات ببلدة غيرها ومن كان بالنواحي القريبة منها ومن قدمها من غير أهلها». نفهم من الاقتباس السابق أن البغدادي يترجم في كتابه لمن وُلد في بغداد ومن سكنها، حتى وإن انتقل عنها ومات خارجها.
واتبع ابن عساكر في كتابه «تاريخ مدينة دمشق» منهجًا قريبًا من منهج الخطيب البغدادي، فقد ترجم لكل من كان من أبناء دمشق أو بعض المدن والقرى المحيطة بها، وكذلك ترجم لمن مر بها وسكنها أو كان غريبًا عنها وله أثر فيها. ولا يمكن الحديث عن منهجيات المؤرخين المسلمين دون الحديث عن المقدمة المتميزة للدكتور المحقق بشار عواد لكتاب «تاريخ بغداد»، إذ برز دوره في نقد وتبيان منهجية البغدادي في أكثر من مئتي صفحة، موضحًا وناقدًا ومدافعًا عما كتبه الخطيب.
ما يهمنا في هذا المقال هو ما يتعلق بنسبة العالم للبلد، خصوصًا في إدخال البغدادي لتراجم بعض علماء وأعيان المناطق المجاورة، إذ ينتقد عواد ذلك بقوله: «... فهو صنيع لم أفهمه جيدًا، ولم أجد له مبررًا سوى توسيع الدائرة والاستكثار...».
إن نقد بشار عواد لمؤرخ وعالم كالخطيب البغدادي يجب أن يدرَّس في الجامعات العربية والخليجية، إذ أن النقد يطور المنهجية ويقويها. وما سنركز عليه هنا منهجية من كتب في التراجم الخليجية، ومن أخرج بعض علماء تلك المدن والمشيخات لأسباب أيديولوجية تخص زماننا اليوم لا الزمان الذي عاش فيه العلماء.
هل لكتب التراجم الخليجية المعاصرة منهجية واضحة؟
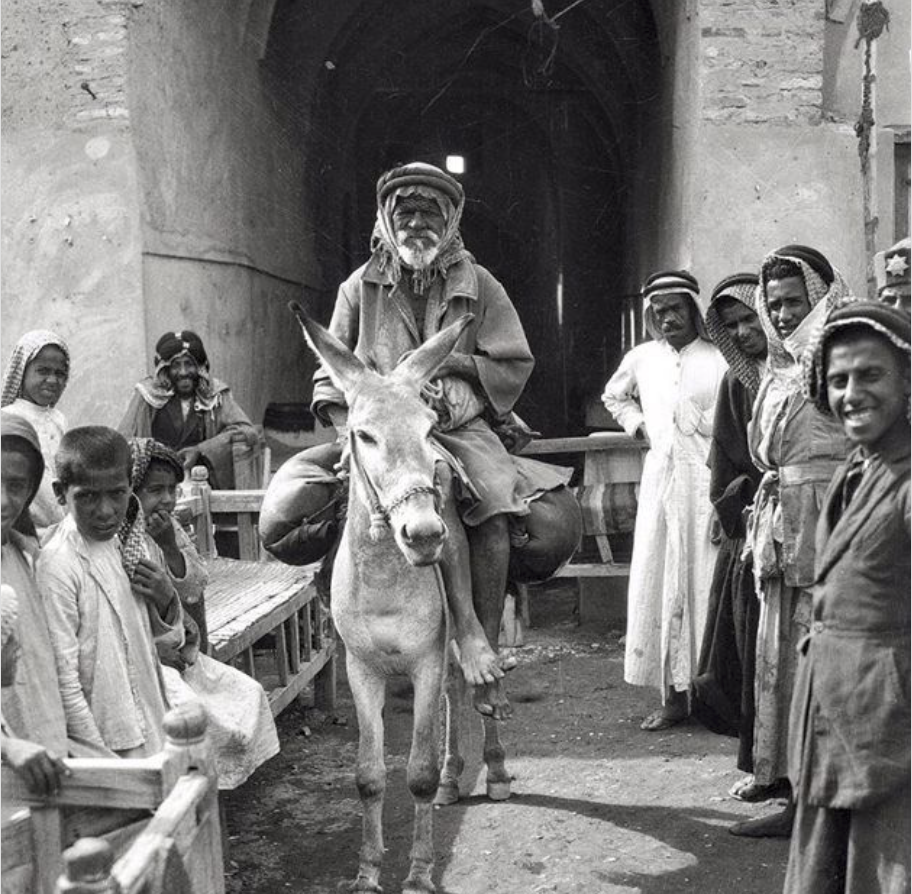
عند مطالعة معظم كتب التراجم التي أرخت لعلماء نجد والزبير والكويت، وهي ليست كثيرة، نجد أن بعضها لا يذكر في مقدمته منهجيته في نسبة العلماء للبلد التي أرخ لها، مثل كتاب ابن غملاس «الإعلام في أعيان بلد الزبير بن العوام»، أو كتاب محمد القاضي «روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين»، وكذلك كتاب عدنان الرومي «علماء الكويت وأعلامها خلال ثلاثة قرون».
بينما نجد منهجية واضحة لدى كُتاب آخرين يستطيع القارئ محاكمتها، مثل عبد الله البسام في كتابه «علماء نجد خلال ثمانية قرون»، والذي ذكر منهجيته بشكل واضح في مقدمة الطبعتين الأولى والثانية.
يقول البسام في مقدمة الطبعة الأولى: «... ثم إني في كتابي ترجمت لعلماء كثيرين ممن عارضوا الدعوة السلفية التي جددها الزعيم الإسلامي المصلح الإمام محمد بن عبد الوهاب...»، ثم يضيف في منهجيته في الطبعة الثانية نقاطًا منها: «خامسًا: إن الكتاب كاسمه مخصص (لعلماء نجد)، سواء كانوا منها ثم ارتحلوا إلى غيرها، أو أنهم قدموا إليها من غيرها واستقروا فيها، وجعلوها لهم وطنًا، فلم أخص بالنجدي الأصل الذي لم يبرحها»، وهذا الوضوح المنهجي أخرج البسام من الحرج، فقد أرخ وفق معايير واضحة ومحددة.
أما أشهر الكتب التي أرخت لمشيخة الزبير وترجمت لعلمائها وأعيانها فهو كتاب «إمارة الزبير بين هجرتين» لعبد الرزاق الصانع وعبد العزيز العلي، خصوصًا الجزء الثالث الذي حوى تراجم الأعيان ومن ضمنهم العلماء. منهجية الكتاب واضحة، إذ ذكر المؤلفان في مقدمة الجزء الثالث أربع نقاط جوهرية للترجمة للأعيان: «هذا وإن من ورد لهم اسم في هذا الكتاب... هم إما: (1) زبيري ولادةً وإقامةً وتحصيلًا ووفاة، (2) أو إن البلد اكتفى منه بإقامة أو دراسة ثم خرج إلى بلد آخر ومات فيه (3) وإما أن تكون الزبير محطة لهذا الدارس الذي جاء من خارجها لغرض الدراسة ثم عاد يكمل رحلته وتوفي في البلد الأخير (4) وإما أن يكون قصد الزبير للتلقي أو التدريس فكانت نهايته فيها...».
أما سعود الربيعة فقد خصص قسمًا كاملًا في مقدمة كتابه «الحركة العلمية بين نجد والزبير خلال ثلاثة قرون» سماه منهج البحث، شرح فيه معاييره في تنصيف المترجم لهم على الرغم من عدم وضوح هذه المعايير مقارنةً بالصانع والعلي أو البسام. يقول الربيعة: «... كذلك لم أُغفل من له فضل بعد الله على بلد الزبير من العلماء غير النجديين والذين إذا ذُكر الزبير ذكروا معه، مثل الشيخ محمد أمين الشنقيطي ... اعترافًا بجليل قدرهم وتقديرًا لبذلهم في سبيل الله نشر العلم في هذا البلد». ويتبين من خلال قراءة منهجه أنه يعتبر الزبيريين نجديين؛ ولذلك كانت إضافته للعلماء الذين لا تعود جذورهم لنجد رغم أنه أرخ لعلماء من الكويت، مثل الشيخ عبد الله الخلف الدحيان.
هذا، ولا يمكن تجاوز ما كتبه المؤرخون العراقيون في التاريخ الحديث في التراجم لصلة العراق جغرافيًا وثقافيًا بالجزيرة العربية، ولعلي أختار ما كتبه الدكتور عماد عبد السلام رؤوف في كتابه «التاريخ والمؤرخون العراقيون في العهد العثماني»، والذي ترجم فيه لبعض العلماء النجديين/الزبيريين. ويوضح رؤوف في مقدمة الطبعة الثانية للكتاب منهجيته حين يقول: «أما العراقي، ففي ظل عدم وجود قوانين جنسية وأنظمة الإقامة وحدود مرسومة للبلاد ... لم يبقَ أمامنا إلا أن نَعُد العراقي هو كل من وُلد في العراق أو وفد إليه صغيرًا فعاش في أرضه، وتلقى العلم على يد علمائه، وألف بلغة أهله، ونُسب إلى بعض مدنه ... وتوفي فيه».
من هنا نجد أن المؤلفات الحديثة التي ذكرناها تشترك في بعض المعايير مثل الوفاة والولادة والإقامة عند نسبة العلماء والأعيان للبلدان، وإن وُجدت فروقات مثل الذي اختص به البسام دون غيره في نسبة العلماء لجذورهم النجدية حتى وإن وُلدوا خارج نجد. فنجد عثمان بن سند على سبيل المثال يترجَم له في الكتب النجدية والزبيرية و الكويتية والعراقية، ولعل هذا الأمر من إشكاليات تداخل هوية الدولة القُطرية الحديثة ومفاهيم المواطنة المستحدثة، وكذلك محاولة إيجاد عمق ثقافي لهذه الدول والمشيخات من خلال نسبة العلماء لها، وإن كان أثرهم فيها معدومًا.
في البحث عن الإرث الثقافي: التنازع على الطبطبائي وابن سند

استقلال المشيخات والإمارات في الخليج وقيام الدول القُطرية رافقه مرحلة التأسيس الثقافي ورحلة البحث في التاريخ عن عمق يربط بين الدولة الحديثة وإرثها التاريخي. ومن أبرز العقبات التي واجهت الباحثين عن هذا الإرث أن الدول الخليجية، والعراق من ضمنها، تتشارك في اللغة والدين والكثير من العادات والتقاليد، وليست مثل الدول الأوربية على سبيل المثال، إذ أن اللغة والإرث الثقافي فيه اختلاف نوعًا ما.
في كتابه «إطلالة على سيف كاظمة» الذي جمعه عباس الحداد، يصف خالد سعود الزيد مرحلة ما قبل استقلال الدول بوصف جميل، إذ يقول: «لن تكون محتاجًا إلى جواز سفر ولا إلى بطاقة للعبور من الكويت إلى أي قُطر من أقطار العروبة والإسلام، لا حواجز ولا حدود ولا انتماء لغير المدينة أو القرية التي وُلدت بها ونشأت فيها».
لكن بعد ذلك اختلفت منهجيات المؤرخين الذين كتبوا عن الخليج في نسبة العابر من العلماء والشعراء إلى الدولة الحديثة بعد ترسيم الحدود. وفي التأريخ لتاريخ الأدب في الكويت على سبيل المثال، نجد أن كثيرًا ممن كتب في هذا الموضوع على خلاف حول من أسس تاريخ الأدب في الكويت: عثمان بن سند أم عبد الجليل الطبطبائي؟ ولأن هذا المقال لا يُعنى بهذا الأمر تحديدا، أحيل القارئ إلى بحث طارق الربعي كانطلاقة أولى للمهتمين بهذا الخلاف.
عودًا إلى قضية الانتساب وعلاقته بالهوية الثقافية للدولة القُطرية اليوم، فالصراع بين الباحثين على نسبة عثمان بن سند أو عبد الجليل الطبطبائي للكويت الحديثة مثال جيد لفهم هذه النقطة. خليفة الوقيان في كتابيه «القضية العربية في الشعر الكويتي» و«الثقافة في الكويت»، يخالف رأي خالد سعود الزيد في كتابه «أدباء الكويت في قرنين»، وكذلك بعض مقالات الزيد في أن الأب الثقافي لشعراء الفصحى في الكويت هو عبد الجليل الطبطبائي.
هذه النقطة تحديدًا المقال غير مَعني بها، لكن خلال نقاش هذه النقاط بين الوقيان والزيد نجد فكرة الانتساب واضحة، وهي الأصل في محاولة كل منهما إعطاء السند أو الطبطبائي ريادة شعر الفصحى في الكويت، ومن أراد الاستزادة لعله يراجع ما كتبه الربعي .
الطبطبائي والسند كلاهما يشترك في كثرة التنقل بين المدن والمواني الخليجية وجنوب العراق؛ ولذا فإن العديد من الباحثين ينسبونهما إلى الدولة الحديثة، مثل الكاتبين السابقين، وكذلك بعض الكُتاب العراقيين مثل إبراهيم الوائلي وعماد رؤوف في نسبة الطبطبائي والسند للبصرة والعراق، أو إلى قطر، عندما تفرد ديوان عبد الجليل الطبطبائي المطبوع في قطر بذكر ولادته في الزبارة، على الرغم من أن معظم المصادر الأخرى تذكر ولادته في البصرة، وأما المصادر النجدية فتنسب السند لنجد بحكم أصول أسرته العائدة لحريملاء.
عودًا إلى صراع الكويتيين حول نسبة السند والطبطبائي للكويت الحديثة، نجد أن الوقيان يحاول إضعاف انتساب الطبطبائي للكويت من خلال ذكر بعض الشواهد التي لا تدل على أن علاقته بالكويت كانت علاقة كبيرة، مثل ما ذكره في كتاب «القضية العربية»، يقول الشاعر مشيرًا لتعلقه بالزبارة:
هواي زباري ولست بكاتم هواي ولا مصغٍ للاحٍ وعاتب
ويحاول في موضع آخر من الكتاب أن يكمل نقده فيقول: «تشير معظم المصادر العراقية ... إلى أن اسم الشاعر هو عبد الجليل البصري نسبةً لمدينة البصرة التي ولد فيها...».
أما في كتاب «الثقافة في الكويت»، فيقول إن عثمان بن سند كان موضع خلاف بين الباحثين من حيث نسبته للكويت أو العراق، وكان الطبطبائي محل خلاف بين الباحثين كذلك في نسبته للعراق وقطر والبحرين والكويت، ويبرر الوقيان ذلك بأن هذا الأمر مألوف بسبب عدم وجود قيود على التنقل.
الزيد من جهة أخرى لم يترجم لعثمان بن سند في كتاب «أدباء الكويت في قرنين»، رغم ترجمته للطبطبائي، وربما يكون السبب شهرة السند بالعلم الشرعي أكثر من كونه شاعرًا، على الرغم من ورود بعض النصوص التي تجعل الطبطبائي في مصاف العلماء مثل عدنان الرومي.
حاول أحد أحفاد عبد الجليل الطبطبائي، محمد الطبطبائي في تحقيق ديوان «روض الخل والخليل»، إثبات وجود وأثر جده في الكويت من خلال نسب بناء مسجد في الكويت لجده عبد الجليل الطبطبائي، رغم أن الذي بنى المسجد ينتسب لأسرة مختلفة هي العبد الجليل. ولم يتوقف الأمر عند هذه النقطة كما يذكر الوقيان في كتابه، بل حاول محمد الطبطبائي إيجاد بيت واحد لجده في مدح الكويت فلم يستطع.
هنا يجب التوقف ومناقشة مشكلة المنهجية في الكتب التي سبق ذكرها، إذ لا توجد منهجيات واضحة لجميع هذه الكتب في مسألة نسبة العلماء والشعراء للدول الحديثة، خصوصًا كتب الوقيان والزيد والرومي. من هنا كان من الصعوبة حسم الأمر على الرغم من رجحان كفة الوقيان بعض الشيء؛ لأنه وجد نصًا مخطوطًا يصف ناسخه عثمان بن سند بـ«الفيلكاوي مولدًا والقرين مسكنًا»، والقرين هو الاسم القديم للكويت.
استدل الوقيان على أن الطبطبائي تتنازعه أربع دول، بينما السند تتنازعه دولتان هما الكويت والعراق، ولعله لم يطلع على نسبة الزبيريين للسند بأنه منهم، وكذلك فعل النجديون. فهل مولد عثمان بن سند في الكويت يجعله كويتيًا حتى قبل أن تُسمى الكويت كويتًا؟
الإشكالية المنهجية الأخرى هي تطبيق معايير الهوية والجنسية اليوم على زمن تاريخي لا تنطبق عليه هذه المعايير، بالرغم من إلمام الوقيان والزيد بهذه الإشكالية، فقد أشار كلا الرجلين لهذه القضية كما بيَّنا سابقًا، ولعل السبب هو محاولة إيجاد عمق ثقافي للدول المؤسسة حديثًا. لذا ما انتقد به الوقيان من وصف الطبطبائي بالبصري، نجد عثمان بن سند يصف نفسه طوعًا بالبصري، كما جاء في كتابه «سبائك العسجد» المطبوع في الهند 1315 هجري.
سِيَر العلماء بين مطرقة السياسة والمذهب وسندان البحث العلمي والإنصاف

كان الصراع التاريخي الديني/الأيديولوجي في الجزيرة العربية عنيفًا أُزهقت فيه أرواح، وكانت الردود من جميع الأطراف حادة، ووصلت إلى التكفير في مناسبات عديدة. المقصود بالصراع هنا تحديدًا هو الصراع بين أنصار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومعارضيهم، وكيف انعكس ذلك على عدم التأريخ والترجمة لكلا الطرفين، أو تجاوز ذكر ما حدث فعلًا وتحليله في الكتب الحديثة التي كتبت عن تاريخ المدن والمشيخات.
التركيز هنا سيكون على كتابين هما «إمارة الزبير بين هجرتين» للصانع والعلي بدرجة أساسية، وكذلك كتاب «الحياة العلمية في الأحساء» لعلي الصيخان، وكتاب «مشاهير علماء نجد وغيرهم» لآل الشيخ، وأخيرًا كتاب بن حميد «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة» بدرجة أقل.
الصراع بين الفئتين كان ولا يزال حاضرًا وإن خفتت ناره لكنها لم تنطفئ، فالمتصفح لمواقع التواصل الاجتماعي يجد هجومًا على رموز كل طائفة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه وتلاميذه من جهة، والشيخ محمد بن فيروز وأتباعه وتلاميذه من جهة أخرى.
هذا الصراع حاول الكثير من المؤلفين في تراجم العلماء والحياة العلمية في مدن الزبير ونجد والأحساء تجاوزه أو الاصطفاف والانحياز لفئة دون أخرى، كما فعل عبد الله بن بسام في كتاب «علماء نجد»، إذ ذكر في المقدمة: «ثم إني في كتابي ترجمت لعلماء كثيرين ممن عارضوا الدعوة السلفية»، فقد وقف في صف جهة دون أخرى، وهذا يُحسب له، إذ أنصف من سماهم بالمعارضين بذكرهم في كتابه عن العلماء.
لم تكن بعض الكتب التي ترجمت للدعوة السلفية/الوهابية فقط من أسقطت تراجم معارضيها، كما فعل آل الشيخ في كتابه «مشاهير علماء نجد وغيرهم»، بل فعل ذلك محمد بن عبد الله بن حميد صاحب كتاب «السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة»، فقد أهمل الترجمة للشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه كما ذكر ذلك بكر أبو زيد الذي حقق الكتاب في المقدمة، إذ قال: «... مواقف له تعارض الدعوة الإصلاحية ... وهذا الحمل منه على علماء التوحيد وولاة أمر المسلمين قد جر المؤلف إلى التجاهل، بإسقاط تراجمهم الحافلة بدءًا من الإمامين المحمدين المذكورين، وأقرانهما وتلاميذهما...».
الذين كتبوا عن تاريخ مشيخة الزبير قديمًا وحديثًا حاولوا تحاشي تحليل هذا الصراع الفكري بين ما يُعرف بالوهابية/السلفية، ومن خالفهم من العلماء النجديين الذين هاجروا وسكنوا البصرة والزبير. هذا الصراع لم يكن خافيًا، بل وُجد على امتداد تاريخ المشيخة حيث كان علماء الزبير في الغالب مخالفين للأيديولوجيا الوهابية/السلفية ولهم ردود عليها، كما كان لأتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ نفسه ردود على من سكن في مشيخة الزبير. من الأمثلة على ذلك ما ذكره ابن غملاس في مخطوطة «الإعلام في أعيان بلد الزبير بن العوام»، التي حققتها مكتبة البابطين، في ترجمته للشيخ محمد الهديبي المتوفى سنة 1261 هجري، أي بعد سقوط الدولة السعودية الأولى: «... أمَا تذكر حين أجازك شيخنا ابن فيروز وأوصاك بوصية منها: احذر تصب بعارض من محن أهل العارض، أو محق أهل العارض...».
في المقابل نجد الشيخ سليمان بن سحيم، وهو معارض لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد هاجر واستقر في الزبير، يتصل بالعلماء خارج نجد ويحرضهم على الشيخ ابن عبد الوهاب. وابن سحيم تحديدًا، وصل الأمر بينه وبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى عبارات شديدة، منها ما ذكره في رسالة له لعلماء المسلمين ذكرها حسين بن غنام مؤرخ الدعوة الوهابية/السلفية، ونصها: «... فالذي يحيط به علمكم أنه قد خرج في قُطرنا رجل مبتدع جاهل مضل ضال...». وكان جواب ابن عبد الوهاب عليه في بعض رسائله يحوي الحدة ذاتها، إذ يقول في رسالته إلى ابن سحيم: «… فإن الذي راسلكم هو عدو الله ابن سحيم...». بل وصل الأمر للتكفير، إذ ذكر ابن عبد الوهاب خلال رسالته إلى سليمان بن سحيم نفسه قوله: «… وأنت إلى الآن أنت وأبوك لم تفهموا؟ شهادة أن لا إله إلا الله، أنا أشهد بذلك...»، وما سبق مذكور عند ابن غنام.
ذِكر الأمثلة السابقة كان للتدليل على أن الترجمة لعالم مثل سليمان بن سحيم تم تجاوزها في الكتب الزبيرية، ما عدا صاحب كتاب «الحركة العلمية بين نجد والزبير». فصاحبا كتاب «إمارة الزبير بين هجرتين»، رغم تخصيصهما جزءًا كاملًا للحياة العلمية والأدبية والمساجد في الزبير، فإنهما ترجما لعلماء الزبير دون الإشارة إلى الخلافات المذهبية والفكرية مع دعوة محمد بن عبد الوهاب، ولم يترجما أصلا لسليمان بن سحيم.
الوحيد الذي أشار على استحياء إلى الخلاف بين ابن سحيم مع دعوة ابن عبد الوهاب كان صاحب كتاب «الحركة العلمية بين نجد والزبير»، حين نقل عن حسين الشيخ خزعل قوله: «... إلا أن الشيخ سليمان، عفا الله عنه، أظهر العداء للشيخ ودعوته، وكان بينهما رسائل أوردها صاحب حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب حسين خلف الشيخ خزعل...».
تكمن أهمية ذكر الخلاف بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والعلماء الذين هاجروا من نجد إلى الزبير أو البصرة، في أن هؤلاء العلماء كان لهم أثر كبير في نشأة الحياة العلمية في الزبير، خصوصًا طلبة الشيخ محمد بن فيروز، وهم كثر، ومن أبرزهم محمد بن علي بن سلوم، وإبراهيم بن جديد، ومحمد بن حمد الهديبي، وعبد الله بن داوود، وناصر بن سليمان بن سحيم. هؤلاء العلماء وانتسابهم للبلدان المختلفة يجعلنا نصنف أصحاب هذه المنهجيات من باحثي اليوم وما خطُّوا من تراجم سياسيًا وأيدولوجيًا، ومن ذلك ما كتبه علي الصيخان في كتابه «الحياة العلمية في الأحساء»، حين قسم طلاب العلم الذين درسوا على علماء الأحساء لعدة أقسام.
ما يهمنا من هذه الأقسام الطلبة النجديون والعراقيون. لم يوضح الصيخان منهجيته في تصنيفه للعلماء في بداية الكتاب ومقدمته، حتى أنه لم يعرِّف من هو العالم الأحسائي: هل هو على منهج البغدادي وابن عساكر من المتقدمين، أم على منهج البسام من المتأخرين؟
صنَّف الصيخان الشيخ إبراهيم بن جديد على أنه نجدي، ثم ذكر بعد أن ذكر نسب الشيخ «النجدي ثم الزبيري الحنبلي». وفي الفئة، فئة طلبة العلم النجديين، وضع عثمان بن جامع، وأضاف بعد ذكر نسبه «النجدي ثم الزبيري الحنبلي». وترك هذه الصفة حينما ترجم لمحمد بن سلوم وصالح بن سيف العتيقي، إذ اكتفى بذكر علاقتهما بالزبير خلال الترجمة.
هل يُصنف العالِم بين نجدي أو عراقي بناء على مدى العداوة مع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟
في الجانب المقابل، وتحت تصنيف طلبة العلم العراقيين الذين درسوا في الأحساء، وضع عثمان بن سند «النجدي الأصل البصري»، وكذلك عبد الله بن داوود «الزبيري»، وأخيرا ناصر بن سليمان بن سحيم «الزبيري».
بعد التدقيق في ما كتبه المؤلف، لا نفهم كيف أسس الباحث تصنيفه بين النجدي والعراقي: هل كان ذلك مرتبطًا بالتراتبية وقد نقلها كما قرأها في المخطوطات، أم أن وصفه لهم كان عشوائيًا دون تراتبية معينة بين الأصل والمولد والاعتقاد والمذهب؟ هل مكان الولادة هو الأصل في التصنيف؟ إذا كان مكان الولادة هو الأصل، فقد وضع عثمان بن سند وعبد الله بن داوود في صف الطلاب العراقيين، رغم ذكره أن الأول وُلد في «جزيرة فيلكا الكويتية»، والثاني ولد في «بلدة حرمة من قرى نجد».
أما إذا كان تصنيفه على الأصل، كما فعل البسام، فالواجب أن يكون الجميع في الفئة النجدية مثلًا. وفي حال كان التصنيف وفقًا لمكان التأثير، فابن جديد وابن سلوم والعتيقي كان تأثيرهم في البصرة والزبير أكبر، وتأثرهم بالشيخ محمد بن فيروز أكبر من تأثرهم بأي نجدي غيره.
هذه النقطة تجعلنا نتساءل: هل التصنيف يجري بحسب قرب أو بعد العالم من دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ هل لهوية الباحث الوطنية اليوم علاقة بما كتب؟
هذا التساؤل مبني على كلام الصيخان حين ناقش الردود العلمية، فقد ذكر أن علماء الأحساء كانت ردودهم خلال مدة البحث باتجاه واحد وهو الرد على «الدعوة السلفية في نجد»، ثم وصف الردود بأنها تتسم «في الغالب بالشدة والقسوة»، وكان علماء الأحساء «هم بدؤوا بها». ثم وصف الشيخ محمد بن فيروز، وهو من أشد خصوم الدعوة الوهابية/السلفية، حين ناقش «مؤلفات علماء الحنابلة» بأن ابن فيروز كانت له «مؤلفات قليلة لا تدل على سعة علمه كما وصفه معاصروه، وقد يعود السبب إلى انشغاله بالتدريس كما مر في ترجمته»، على الرغم من أنه ذكر في ترجمة ابن فيروز أن رئاسة المذهب الحنبلي انتهت له في الأحساء، ثم عدد طلبته. فهل وصفُ الصيخان لابن فيروز بأن مؤلفاته قليلة يأتي من باب أيديولوجي؟ ومؤلفاته قليلة مقارنةً بمن؟ فما معيار القلة والكثرة هنا؟
ما سبق يدعونا إلى التساؤل أيضا حول منهجية المؤلف؛ لأنه لم يوضحها في تصنيف الطلبة بين العراقي والنجدي. فهل تصنيفه كان مبنيًا على مدى العداوة مع دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ إذ أن عبد الله بن داوود وعثمان بن سند يشتركان في ردودهما على الدعوة الوهابية/السلفية ومخالفتهما لها من خلال الكتابات الصريحة، فابن داوود كتب «الصواعق والرعود في الرد على ابن سعود»، وابن سند كتب «مطالع السعود بطيب أخبار الوالي داوود».
نقطة العداء للدعوة الوهابية/السلفية فيها غموض، إذ أن ابن جديد كما ورد عند عبد الله بن غملاس في كتابه «الإعلام في أعيان بلد الزبير بن العوام» قوله في ترجمة الشيخ إبراهيم بن جديد: «ومما شاع في حلمه أن بعض أهل نجد هجاه وكفره وأطلق لسانه بالكلام الشنيع فيه لكونه أنكر على ابن عبد الوهاب، والهاجي موافق لابن عبد الوهاب، فاتفق أنه افتقر ونسي ما جرى، فسافر إلى بلد الزبير، والشيخ المترجم إذ ذاك عينها الباصرة وكلمته مقبولة عند البادية والحاضرة، فعندما سمع بوصول الهاجي أرسل إليه بكسوة ودراهم وقال: بمقابلة هديتك التي أهديت إلينا هذه السنة، وأرسل إلى الأمير أن لا يتعرض أحد له بسوء، فعند ذلك خجل الرجل وصار يثني على ابن جديد ويمدحه».
الغريب أن عثمان بن سند ترجم في «سبائك العسجد» لعبد الله بن داوود بالنجدي، فيستغرب وصفه بأنه زبيري رغم وجود شاهد تاريخي وشاهد ولادة في بلدة نجدية؟ ولذا فالأجدر إيضاح منهجية التصنيف.
ابن سلوم صنفه مؤلف كتاب «دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» على أنه من خصوم الدعوة، وقد ترك نجدًا إلى الأحساء ثم الزبير مع شيخه محمد بن فيروز. وكتب المؤلف في الهامش عند الحديث عن ابن سلوم أن عبد الله البسام صاحب علماء نجد يميل إلى أن ابن سلوم ليس من خصوم الدعوة الوهابية/السلفية. فما أساس تصنيف الصيخان لهؤلاء العلماء؟ سؤال يحتاج القارئ والمتابع لإجابة عليه.
تصنيف مبهم ضاع بين مبادئ أيديولوجية ومعايير وطنية

عبد الرحمن آل الشيخ في كتابه «مشاهير علماء نجد وغيرهم»، ومع أن العنوان يخالف المضمون نوعًا ما، فقد ذكر في مقدمة الطبعة الثانية «أحببت المساهمة ولو بجهد المُقِل، فجمعت هذه الرسالة في تراجم بعض مشاهير علماء نجد المتوفين ابتداءً من الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى هذا اليوم … وبعدهم بعضًا من علماء مكة المكرمة، ووضعت في آخرها تراجم بعض رجال النهضة الإصلاحية من علماء الأمصار الذين تأثروا بدعوة الإسلام السلفية...».
ورغم أن المؤلف ذكر في الهامش أنه قد فاتته الترجمة لكثيرين، وعلل ذلك بعدم قدرته على زيارة البلدان مثل الزبير والأحساء وقطر والبحرين وغيرها، وهو عذر له وجاهته، فإنه أهمل الترجمة لبعض مشاهير علماء نجد ممن عارض الدعوة السلفية/الوهابية، مثل الشيخ محمد بن فيروز وعثمان بن سند ومحمد بن سلوم، وغيرهم من العلماء النجديين الذي هاجروا واستقروا في الزبير والبصرة.
هذا الإهمال ربما كان سببه عداوة هؤلاء للدعوة الوهابية/السلفية، إذ أنه ترجم لعلماء من الكويت والزبير ممن هم أقل شهرةً من ابن فيروز، وعلى سبيل المثال فقد ترجم لعبد العزيز الرشيد من الكويت وعبد المحسن البابطين، وكذلك محمد بن عوجان، خصوصًا أن عنوان الكتاب «مشاهير علماء نجد وغيرهم»، فشهرة العالم عنده سبب للترجمة، لكن لكونهم من معارضي دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كان سبب عدم تضمينه لهم في الكتاب أيديولوجيًا.
بعيدًا عن الصراع الأيديولوجي بين أنصار الدعوة والوهابية/السلفية ومعارضيهم من النجديين تحديدًا، نجد عدنان الرومي في كتابه «علماء الكويت» لا يضع منهجيةً لمن هو الكويتي، ومع ذلك يستثني علماء كان لهم أثر كبير في الحياة الثقافية والسياسية في الكويت، مثل الشيخ محمد الشنقيطي، وحافظ وهبة، وعبد العزيز العلجي، وعبد المحسن البابطين الذي كان قاضي الكويت في 1938، بينما يصنف عثمان بن سند وعبد الجليل الطبطبائي وسيد عمر عاصم ومحمد الفارس على أنهم كويتيون، فما المعيار لهذا التصنيف؟
الشيخ محمد الفارس وصف نفسه في مخطوط نُشر في كتاب «علماء آل فارس في الكويت»، مرةً في عام 1850 أنه نجدي فقط دون أي إضافه، وقبل هذا التاريخ بخمس سنوات وصف نفسه بأنه «التميمي أصلًا النجدي منشأً الكويتي مسكنًا»، فنجدية الرجل مقدَّمة على كونه كويتيًا، رغم أن فضله وعلمه سابقان على طلبة العلم في الكويت.
المثال هذا يدعونا إلى التساؤل: لماذا استثنى الرومي قاضيًا للكويت مثل عبد المحسن البابطين وهو نجدي زبيري، ولم يصنفه من الكويتيين؟ ولماذا لم يصنف الشنقيطي وحافظ وهبة كذلك؟ هل بسبب انتقالهم إلى الزبير ونجد، أم لكونهم قدموا في فترة متأخرة مع بدايات القرن العشرين فتغير مفهوم الهوية في المجتمع الكويتي؟ خصوصًا أن الشيخين حافظ وهبة والشنقيطي كان لهما دور بارز في تأليب الكويتيين ضد الإنجليز خلال الحرب العالمية الأولى، وقد أشار الرومي لذلك حين ترجم لهما.
مما سبق يتبين أن عدم وضوح منهجية المؤلفين يجعل مؤلفاتهم متحيزة، أو قد تبدو كذلك ضد أشخاص بعينهم لمخالفتهم للأيديولوجيا التي يتبناها المؤلف. هذا الانحياز قد يكون أحد أسبابه الهوية المستحدثة للدولة المدنية، فالجنسية اليوم والانتماء لبلد له حدود معينة يدفع بعض الباحثين إلى إثبات ولائهم للبلد، من خلال تحيزهم في البحث العلمي عمومًا والتاريخي بشكل خاص. هذا التحيز تُشكله مفاهيم مغلوطة للمواطنة اليوم، فكل نقد للإرث الثقافي هو نقد للوطن ذاته.
الهوية الوطنية في كثير من الأحيان ضبابية وملتبسة، فيها ما هو طارئ ومصلحي وظرفي على ما هو ثابت وطويل الأمد ومبدئي، كما وصفها عبد الحسين شعبان في كتابه «الهوية والمواطنة»، ولذلك فإن ما هو من المحرمات اليوم قد يكون من الأمور الواجب الحديث عنها في المستقبل، وما تبدُّل مواقف الشعوب الخليجية مع تغير قياداتها بغريب على المتابع للشأن الخليجي.
ألا نجِدُ اليوم من يتحدث عن الصحوة الإسلامية بنوع من السخرية، ويتنصل بعض الباحثين مما كتبوا في تلك الفترة؟ الذي تغير هو مفهوم الهوية الوطنية بالنسبة لهؤلاء الكتاب، وتغيرها مرتبط بعوامل لا شأن لها بالمبادئ في الغالب ولا بالبحث التاريخي. الكتابة بمنهجية واضحة تدفع الباحث إلى البحث بطريقة صحيحة، وتزيد وتُعمق الحقل العلمي والتاريخي.




