أنت الآن في نقاش محتدم مع أصدقائك، عن رغبتكم في شكوى رئيسكم في العمل. الشكوى في حال تحقق مرادها، ستجعل الأمور في المستقبل أفضل ما يكون، لكنها قد تعرضكم أيضًا للخطر. دائمًا سيكون هناك أحدكم الأكثر حماسة لإكمال الأمر، سيكون هناك آخرون يحاولون الوصول إلى صياغة وسط. وبالطبع، سيكون هناك من سيجد دائمًا أن عواقب هذا الفعل ستزيد الأمور تعقيدًا، ولن تحل أي شيء. في النهاية، العمل رغم عيوبه يوفر لكم دخلًا ثابتًا، ومهمتكم أن تؤمِّنوا حياتكم، وليس أن تغيروا العالم.
في أي نقاش مجتمعي، غالبًا ما تتردد كلمة «محافظون» للدلالة على ميل اجتماعي ما، غير ثوري، لا يرجو الاصطدام بالجماهير، ولا يجد مشكلة كبيرة في شكل المجتمع كما هو الآن.
رغم استخدامها الكثيف، فإن «المحافظة» لا تبدو شيئًا واضحًا وبسيطًا يمكن فهمه أو توقع معاييره في الحكم على الأشياء. يبدو المحافِظ أحيانًا أكثر أريحية من الإسلاميين بمراحل، وأحيانًا متشددًا دينيًّا، وأحيانًا قوميًّا، مرة يشجع تعليم المرأة وعملها، ومرة يرفض ذلك بكل ما يملك من قوة.
«المحافظون»، كما قد يبدو من الكلمة نفسها، من يريدون الحفاظ على وضع ما (الوضع القائم). لكن الوضع القائم نفسه عرضة للتغيير، والمحافظة أوسع من أن تكون إيمانًا بوضع ما بعينه، هناك ما يجمع المحافظين أكثر من ذلك.
شبح يحوم في كل مكان
«المحافظون» ليسوا بالضبط مؤمنين بالنظام. إنهم محافظون عليه بالتزامهم به، بضجرهم من نقده، بحكمتهم التي ترى أن مآل النقد لن يكون جميلًا.
تبدو المحافظة، في جزء منها، رد فعل على ميل أكبر هو الاحتفاء الكوني بالتغيير، منذ بدأت أسطورة «التقدم التاريخي» أو «الحداثة»، أي منذ أن أصبح التغيير في ذاته أمرًا إيجابيًّا، وأصبح هناك جنات دنيوية كثيرة: جنة المساواة الشيوعية أو الحرية الليبرالية أو الخلافة الإسلامية، جنة اللحاق بـ«الدول المتقدمة»، جنان كثيرة أصبح الناس يتوقون إليها.
في مقابل كل هؤلاء، تفترض «المحافظة» أن الوضع القائم، أيَّ وضعٍ قائم، أفضل دائمًا من احتمالات تغييره. إنها انتفاضة على الزمن الحديث كزمن واعد بالتغير، انتماء للذاكرة أكثر منه للحاضر أو المستقبل. ذاكرة تحتفظ داخلها بالتسليم بقدرة المنظومة على قمع الحالمين، وبافتراض أن أي محاولة لتغييره مشروع كارثة محققة، إيمان بثبات بنيوي للمجتمع، غالبًا ما يتكون إثر هزيمة محاولة تغييرية كبرى.
«المحافظون» ليسوا بالضبط مؤمنين بالنظام أو متحمسين له. إنهم محافظون عليه بالتزامهم به، بضجرهم من نقده، بحكمتهم التي ترى أن مآل النقد لن يكون جميلًا، أن كل منتفض مهزوم، وكل منتقِد مشروع خاسر جديد.
المحافظون رغم ذلك، ليسوا متحجرين إلى الأبد. ففي حالة انتصار هذا الخاسر، غالبًا ما يتعاملون بإيجابية مع قدر الإصلاح الذي جرى إنجازه بالفعل. لكن مع ترديد حكمتهم في وجه كل من يريد قدرًا أكبر من التغيير، أن التغيير الذي حدث بالفعل، والذي أصبح الواقع الجديد، أقصى ما يمكن الطموح إليه، وأي زيادة فيه، كما كان كل تغيير من قبل، ستكون نهايتها مأساوية.
هذا الرفض المحافظ الجذري لـ«الرفض» ليس، في رأيي، مجرد تحليل سياسي قد يصيب أو يخطئ، لكنه نابع من فلسفة مجتمعية متكاملة: «أخلاقيات النجاة».
أخلاقيات النجاة
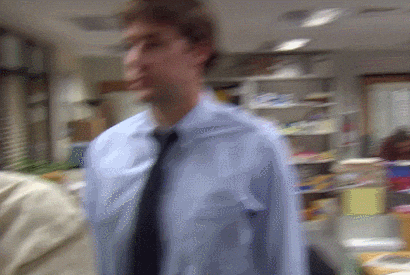
في مواجهة افتراض عالم أفضل ممكن من دون أخطار، تفترض المحافظة أن اليوتوبيا لن تتحقق بأي حال على الأرض.
تخيل أن الشوارع، منذ الغد، امتلأت بوحوش غرائبية تلتهم العابرين، وفخاخ يقع في شركها الناس، قناصة من الأسطح البعيدة يلتقطون حيوات البشر، وتخيل أنك مجبَر على النزول إلى هذه الشوارع، والمضي في سباق تحت ظل هذه الظروف، مع أناس لا تعرفهم، وضد أناس لا تعرفهم، ومن أجل شيء لا تفهمه تمامًا، وإلى مدى لا يمكنك توقعه أبدًا.
في هذا السباق الافتراضي، يمكنك أن تتخيل أن الناس ينصحون بعضهم بأن المطلوب في هذا الوضع الوحشي وغير المفهوم، بتجنُّب أي صدام مع كل هذه العوائق، تفاديها قدر الإمكان، ليس هناك وقت للتفكير في كيفية مجابهتها بشكل جماعي، إنها أكبر منك ومن قدرتك على الوقوف أمامها، وحتى من قدرتكم مجتمعين على تحدِّيها.
هذا السباق ليس بعيدًا جدًّا عن فهم كثير من الناس للعالم كمكان وحشي واسع وغريب، ليس من الحكمة تحديه، بل اللعب حسب قواعده والالتزام بأخلاقيات النجاة وتربية النفس والذات على الهروب من أي فخاخ ممكنة، للاستمرار في السباق أطول فترة.
في هذا السباق، لا وجود للصواب والخطأ. الصواب الوحيد أن تنجح في الصمود داخل السباق دون أن تصاب بالتشتت لأي سبب، كأن تقف لتساعد رجلًا عضه كلب، أو لتأخذ بيد امرأة غير قادرة على عبور عائق ما، أو لتحمل طفلًا يبكي. إن فعلت ذلك، قد ينتهي بك الأمر إلى أن تقع بدورك في أحد الفخاخ. وإذًا، تخسر السباق.
بالطبع، تقع فلسفة النجاة هذه في مواجهة فلسفة الزمن الحديث برمته. فالأولى ترى أن النجاة كل شيء، بينما ترى الأخيرة أنها تمتلك بالفعل حلًّا سحريًّا لهذا المأزق. هذا الحل، سواء كان شيوعيًّا أو ليبراليبًّا أو إسلاميًّا، هذا الحل يقوم على افتراض مخالف تمامًا، وهو أن النجاة الحقيقية تتمثل في أنه على كل هؤلاء الناس الذين وجدوا أنفسهم في مأزق، أن يحاولوا تطويع الظروف وتحديها لصنع عالم مثالي، لا يضطرون فيه كل لحظة إلى الهروب من أخطار لا تنتهي.
تنظر المحافظة إلى هذا الحلم بالعالم المثالي، نظرة الرجل الكهل إلى المراهق الذي لا يعلم ما يواجهه. في مواجهة افتراض عالم أفضل ممكن من دون أخطار، تفترض المحافظة أن اليوتوبيا لن تتحقق بأي حال على الأرض، وأن أي وضع جديد يخلق معه أخطاره الجديدة، وأن هذه هي الحياة، وعلينا التكيف.
الوضع الطبيعي: الحياة بهذه القسوة فعلًا

كأي نظام أخلاقي، لأخلاق النجاة مبادئ تأسيسية. من أهمها أن هناك «وضع طبيعي» للحياة: أغنياء وفقراء، قوي وضعيف، ذكي وبليد. فالناس ليسوا سواسية، وهذا أمر مسلم به في هذه الفلسفة. ومهمتك ليس أن «تغير نظام الكون»، بل أن تستفيد من كل العوامل المتاحة حولك للاستمرار أطول فترة ممكنة في السباق: تستعين بالأغنياء وتصاحب الأقوياء، وحين تأتيك فرصة ما للشعور بالقوة، استغلها لتنضم، ولو في أوهامك الذاتية، إلى نادي من بيدهم الأمر.
هذا «الوضع الطبيعي» ليس من الضرورة أن يكون جميًلا جدًّا. حتى أخلاق النجاة لن تدَّعي هذا أبدًا، بل ستقول إنه «وضع طبيعي» كرد على نقد مضمر بأن الحياة لا يجب أن تكون بهذه القسوة. فالحياة بهذه القسوة فعلًا، وهذا «وضع طبيعي»، بمعنى أنه سيظل موجودًا رغم كل محاولات تغييره. سيعيد خلق نفسه في كل مرة. إذًا، ما الذي سيجنيه الفرد من تحديه لهذا الوضع، التحدي الذي تفترض أخلاق النجاة هزيمته منذ البداية؟
تنظر «أخلاقيات النجاة» إلى معايير المثالية في الحكم على الواقع، مثلًا بأنه غير عادل أو قاسٍ أو قبيح، على أنها قيود تحجِّم من قدرة الفرد على الصمود في السباق، لأنها تعمي الفرد عن رؤية الحياة كما هي بكل قسوتها، لصالح التعلق بمثال لن يتحقق.
تقدس تلك الأخلاق الممكن لا المثال، وتطمح إلى الفعالية لا الصواب. وانطلاقًا من إيمانها بالفعالية، ترفض مجرد التفكير في قدرة المرء بمفرده على إحداث تغيير ما. صحيح أن المرء قد يدعو إلى فكرة ما مثالية، فيقتنع الناس بها مع الوقت، ثم تدريجيًّا، ولو بعد وفاته، تنتصر الفكرة. لكن النجاة، تهتم بنجاح الفرد نفسه لا الفكرة، ونجاحه الآن، لا بعد موته.
ربما تكون واحدة من أوضح صفات أخلاقيات النجاة، قدرتها على تقسيم العالم لسياقات، لكل سياق أخلاقيات نجاته الخاصة.
في نظر أخلاق النجاة، الفرد ضئيل جدًّا دائمًا، ووحيد وخائف وهش، في مواجهة عالم واسع ووحشي وسريع ومليء بالمفاجآت. حتى عندما يحتمي بجموع ما، يجب أن يكون احتماءً لمصلحته الخاصة، ولا ينبغي له أن ينسى في غمرة وجوده وسط الحشود، أنه يجب أن ينجو.
الأمر يشبه في هذه الفلسفة أن تكون وسط اندفاع عظيم للخروج من باب ضيق جدًّا. إذا توقفت تدهسك الأقدام، لا تفكر في أحد غير نفسك، أنت لن تغير العالم، العالم أكبر منك. هذا أمر جوهري جدًّا للنجاة. لتصير قويًّا، عليك أن تعتقد بشكل يقيني تمامًا، أنك عاجز تمامًا عن مساعدة أي أحد غيرك، زَاحِم بكل ما تستطيع من قوة، واصمم أذنيك عمن يمكن أن تدهسه الأقدام في طريقك.
هذا التشبث بـ«الوضع الطبيعي» يجد نفسه في مواجهة الأفكار المثالية الحديثة التي ترى أنه ليس هناك وضع طبيعي للحياة، وأن الحياة بالقسوة التي نعرفها نتاج أوضاع تاريخية وطبقية قابلة للتغيير، إما بتوزيع عادل للثروات في الاشتراكية، أو بمؤسسات قوية في الديمقراطية، أو بتحكيم الشريعة عند الإسلاميين. لكن في أخلاقيات النجاة كل محاولة للتغيير ستنتج الوضع نفسه، وإنْ في صورة مختلفة، فهو «الوضع الطبيعي».
فليبق كلٌّ في سياقه
ربما تكون واحدة من أوضح صفات أخلاقيات النجاة، قدرتها على تقسيم العالم لسياقات، لكل سياق أخلاقيات نجاته الخاصة، ويمكن للفرد الواحد أن يتنقل بين هذه السياقات، وتختلف طريقة حكمه على الأمور من سياق إلى آخر.
هذه نتيجة متوقَّعة بالطبع لاعتبار العالم غامضًا وموحشًا، والتكيف معه هو الهدف الرئيسي. المحافظ عادة شخص غير متحجر، يمكنه الإحساس بموازين القوى من حوله والتصرف على أساسها، ولا يتمثل ذلك فقط في قدرته على التنقل من عصر ذي اتجاه معين إلى عصر ذي اتجاه مختلف، بكل أريحية، بل أيضًا التنقل داخل نفس العصر، بين عوالم مختلفة والتكيف معها، وحصر أخلاقيات كل عالم داخل هذا العالم نفسه، وعدم الخروج بها إلى عالم آخر.
نفس الشخص الذي قد يرى الرقص في الأفراح فعلًا محببًا وجميلًا، سيرفض نفس الفعل في سياق مختلف عن الأفراح، سيغضب من قريباته إن رقصن خارج هذا السياق الذي قرر المجتمع فيه أن الرقص خيار متاح. الشخص الإسلامي في المقابل سيرى الرقص والاختلاط، في حد ذاتهما، وفي أي سياق، فعلين مرفوضين، والسماحَ بهما في أي سياق علامة واضحة على عدم الاتساق.
نفس الشخص المحافظ الذي قد يكون متدينًا في بيته، يمكنه أن يطلق النكات البذيئة ويشرب الحشيش وربما الخمر مع أصدقائه، سيحاول بكل الطرق أن يرتبط بفتاة ما، وربما سيسرق منها قبلة هنا أو هناك، لكنه سينفجر غضبًا إن فعلت أخته ذلك.
التوقف وطرح الأسئلة المتشككة حول قواعد السباق أو التدافع، أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه، لأنه الخطأ الذي يشتتك عن مهمتك الأساسية: «النجاة».
أخلاقيات النجاة تهتم بالسياق لا الاتساق. والسياق معياره هنا هو النجاة بالطبع. بهذا المعنى، سؤال مثل «أترضاه لأختك» هو في الأساس سؤال عن الاتساق. لكن الشخص الذي يتبع أخلاقيات النجاة، لن يتملص منه، سيستمر في أفعاله، ولن يتهرب من الإجابة، في الوقت نفسه، سيعلن بوضوح: «لا أرضاه أبدًا».
بالنسبة إلى هذا الشخص، فعلاقته بفتاة لا تشكل أي خطورة عليه، وسيتمتع بكل امتيازاتها، بينما لو فعلت أخته نفس الشيء، فهذا سيعرضه إلى خطر «القيل والقال»، ولأن ينظر إليه أصدقاؤه، حال إعلانه الموافقة على حرية أخته، نظرة لا يمكنه التعايش معها، هذه الأخطار لن يتعرض إليها في علاقاته هو.
بالنسبة إلى شخص مثل هذا، فأي فعل آمِن في أي سياق، يصبح عقلانيًّا ويمكن التسامح معه ما دام بعيدًا تمامًا عن أن يضره. يمكن حتى للمحافظ أن يتفهم الحياة الغربية المتحررة بالكامل في سياق أنها آمنة بالفعل في الغرب، لكنه سيرفض أي محاولة لاستعارتها لأن «كل بلد وله ظروفه»، وسيرى أن الملابس القصيرة على شواطئ الأغنياء مقنعة جدًّا لأن هذا «سِلْو حياتهم»، لكنه بالطبع سيرفضها في منطقة شعبية، يمثل هذا الملبس فيها مغامرة كبرى.
بشكل عام، تتميز أخلاقيات النجاة بقدرتها على معرفة مدى اتساع العالم واختلافاته وتنوعه، لكنها ترتبك جدًّا في حالات تداخُل العوالم، لأن هذا التداخل يعني أن تغييرًا ما يجري داخل هذين العالمين، وهذا التغيير يصحبه صخب ونقاشات عالية وربما بعض العنف. لهذا ترجو أن يبقى كل فرد في سياقه، كي لا يتعرض أي عالم من العوالم الكثيرة إلى اضطرابات التغيير.
مهارة لوم الطرف الأضعف
إلقاء اللوم على الطرف الأضعف يصبح في الفلسفة التي ترى الحياة سباقًا خطيرًا، ضرورة للاستمرار في السباق نفسه.
من المبادئ التأسيسية لأخلاق النجاة، أن التوقُّف وطرح الأسئلة المتشككة حول قواعد السباق أو التدافع، أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه، لأنه الخطأ الذي يشتتك عن مهمتك الأساسية: «النجاة». لذلك، يجب افتراض أن أي متضرر في هذا السباق، شخص ارتكب خطأ ما: «أكيد عمل حاجة»، كما قد يردُّ بسرعة أي «شخص محافظ» فور أن تخبره بأن أحدهم تعرَّض إلى الأذى من طرف معروف بقوته.
من هذا المنطلق، الفتاة التي تعرَّضت للتحرش دومًا مخطئة، ليس لأنها خالفت قانونًا أخلاقيًّا ما، كأن لم تلتزم بالزي الاجتماعي المفروض، بل لأنها تعرضت للتحرش. يفترض عقل «أخلاقيات النجاة» بشكل فوري أن الفتاة بالضرورة هي المخطئة، لأنها لو لم تكن كذلك، سيضطر إلى مواجهة ثقافة كاملة لا قِبَل له بها. الثقافة التي يفترض أن الوقوف في وجهها قد يؤذيه بشكل لا يمكن احتماله.
نفس الأمر، لو أن شابًّا عوقب لتعبيره عن فكرة ما معارضة، سيكون مخطئًا بالتأكيد. ليس لأن الفكرة نفسها خطأ، بل لأنه عوقب. العقاب دليل على الخطأ دائمًا، لأن تجنب التعرض للعقاب غاية هذه الفلسفة. في أخلاق النجاة، الخطأ أن تتضرر، وإذا أصابك الضرر، فأنت بالتأكيد أخطأت، أو سيفترض كثيرون ذلك كي لا يضطروا إلى التشكيك في القواعد، وتعريض وجودهم للخطر.
إلقاء اللوم على الطرف الأضعف يصبح، في الفلسفة التي ترى الحياة سباقًا خطيرًا، ضرورة للاستمرار في السباق نفسه. الطرف الأضعف هنا يُلام دائمًا، لكن هذا اللوم ليس موجهًا إليه في شكل نصيحة تحاول مساعدته على النهوض مرة أخرى.
هذا اللوم موجه إلى ذوات اللائمين عن طريق جعل الملوم عِبرة للذات من جهة، لتذكيرها بفداحة تحدي القواعد، ومن جهة ثانية لأن اللوم ينطلق من تماهٍ مضمرٍ مع قواعد السباق/الطرف الأقوى، يكون تطمينًا للذات بأنها ما زالت في الجانب المنتصر، حتى لو كان هذا الوجود في الجانب المنتصر، لم يحدث إلا في اللغة، وحتى لو كان اللائمون أنفسهم معرضين في أي لحظة لأن يتحولوا بدروهم إلى أطراف أضعف، تتعرض للعقاب من الأقوى واللوم من الآخرين.
ربما لأن هدف هذه الفلسفة الدائم هو تجنب العقاب، فغالبًا ما يسامَح الأقوياء على خرقهم القواعد الأخلاقية بما إنهم أقوياء بما يكفي للدفاع عن أنفسهم وعدم التعرض للعقاب. لهذا يكون التماهي مع هؤلاء فعلًا مطمْئنًا جدًّا للآخرين.
لكن طمأنينة التماهي اللغوي مع الأقوى بلوم الضعفاء، غالبًا ما تكون لحظية جدًّا، ومخادِعة بالضرورة، لأنها لم تغير بالفعل في موازين القوى، ولم تجعل قائلها يكتسب قوة ما. لكنها تفيد المخدوعين بالاستمرار في السباق لفترة ما، آملين أن تماهيهم السابق مع القواعد يحميهم بشكل أو بآخر.
يمكن مقارنة لوم الضعيف في هذه الفلسفة، بالترسيخ الصلب للاحتفاء بالثورة في الفلسفات الحديثة التي ترى الضعيف مظلومًا يجب نصرته، وستتخذ من مظلوميته مثالًا لتأكيد ضرورة الشروع في بناء العالم الأفضل، وسترى الخاسرين من طرفها قد أدوا مهتهم في محاولة التغيير هذه، ويجب البدء من حيث توقفوا، في الوقت الذي يكونون فيه، في نظر أخلاقيات النجاة، عبرة لمن يعتبر.
النجاة والإيمان

حسنٌ، هل يبدو الأمر سوداويًّا تمامًا؟ إنه ليس كذلك. ففي مواجهة أخلاق النجاة هذه، هناك أنظمة أخلاقية لتفادي ضرر التزاحم الوحشي. هذه الأنظمة في مجملها أشباح انتفاضات ضخمة على قواعد السباق: الأديان قد تكون أوضح هذه الانتفاضات.
على الأقل، في صياغتها النظرية، تكون الأديان أقرب إلى الفلسفات الحديثة، في معاداتها أخلاق النجاة لصالح طموحها لصناعة مجتمع مثالي من وجهة نظرها. أو بالأدق، مجتمع ملتزم بقواعد معينة، أو باعترافات محددة تجاه الأسئلة الكبرى. يجب على الإنسان المخاطرة بحياته كلها في سبيل تحقيقها.
تُبنَى أخلاق النجاة على ثنائية بسيطة: النجاة والعقاب. بينما تُبنَى الأديان، في صيغتها النظرية غالبًا على معايير الصواب والخطأ. لا تحتاج لتبرير نفعي، فالخطأ خطأ لأنه خطأ، والصواب صواب لأنه صواب. وإذا أضفت أن هذا الصواب والخطأ، معياره النهائي خالق هذا الكون، يصير الصواب والخطأ الدينيين، محصنَيْن ضد أي نقد دنيوي، ضد أي نقد قد يستند إلى ضعف فعالية هذه المعايير الدينية في تحقيق الهدف الأسمى: «النجاة».
لكن في مواجهة النجاة كهاجس لا يمكن مراوغته دنيويًّا، تَعِد الأديان بـ«نجاة» أخروية، نجاة أكثر جمالًا وخلودًا، نجاة مضمونة إلى حيث ينتهي السباق تمامًا.
هذا التحصن الديني بنجاة موعودة ومؤجلة، يحرر الإيمان تمامًا من الانهمام بالنجاة الدنيوية. فبعد أن أصبحت النجاة مضمونة، بالوعد الأخروي، يمكن إذًا الاستهتار الزاهد من هذه النجاة «المؤقتة» في الدنيا وأخلاقياتها.
بعد أن يتحول الدين إلى إيمان خالص، يتملص الناس من تعاليمه الأخلاقية العملية لأنها مضرة بفرص النجاة الدنيوية.
الدين، في صورته الأولية، يظل تمردًا على النجاة لأنه يستهين بالحياة، لصالح حياة أخرى موعودة. الدين ينصح الناس مثلًا بالوقوف ضد الظالمين أو المحاربة من أجل نشره أو الثبات على إيمانهم مهما تكن عواقب ذلك، أو يأمرهم بترك أفعال مبررَّة من وجهة نظر النجاة، مثل الكذب والغش والخداع والقتل والسرقة والانغماس في الأهواء الذاتية.
الدين يدفع الناس دفعًا إلى الانفلات من قواعد الحفاظ على حيواتهم، بتقديم وعد لحياة بديلة. هذا الدفع إلى الانفلات يظل مصدرًا للتوتر السلوكي في المجتمعات، لأن الأديان، كما أخلاق النجاة تمامًا، منتصرة ومهيمنة، ولا يمكن التشكيك في سلطتها. كيف إذًا تراوغ أخلاق النجاة: «الحس المنفلت من قواعد النجاة» لتعاليم الدين؟
بحيلة بسيطة، يتحول الدين إلى إيمان خالص. هذا الإيمان غير مقبول التشكيك فيه بأي درجة، لأن التشكيك فيه مثل التشكيك في قواعد السباق نفسها. يعني الحرمان من حياة ما، هي الحياة الآخرة، إضافةً إلى أن التشكيك فيه، خلال ذروة انتصاره، يعني مخالفة إحدى قواعد أخلاق النجاة نفسها، لأن الدين يظل منتصرًا في الدنيا، وإذًا، يكون الهجوم عليه خرقًا لقواعد النجاة الدنيوية نفسها. فمن قواعد النجاة أنه لا تتحدى منتصرًا لا يمكن هزيمته.
بعد أن يتحول هذا الدين إلى إيمان خالص، يتملص الناس من تعاليمه الأخلاقية العملية لأنها مضرة بفرص النجاة الدنيوية. فالشخص الذي يؤذي شخصًا آخر بطلب من سلطة أعلى، سيفعل ذلك، ولو كان يؤمن تمامًا بأن دينه يُحرِّم هذا الإيذاء، ليفوز برضا هذه السلطة. وإذًا، فإنه يحسن فرصه في الحياة، ولن يشكل له كونه لا ينفذ تعاليم دينه أي تأنيب ضمير، لأنه «مؤمن»، والإيمان هو ما يهم أخيرًا في الدين. وهو إيمان ينطلق أصلًا من ضرورة الحفاظ على فرصة النجاة في الحياة الآخرة أيضًا، لكن الحفاظ على الحياة الآخرة هذه، لا يجب، في عُرف أخلاق النجاة، أن يُعرِّض الحياة الأولى، والأكثر مضمونية ومادية، إلى أي خطر.
صحيح أن الدين يظل محصنًا ضد نقد أخلاقيات النجاة، بدعوته الناس إلى الحفاظ على فرصهم في «الحياة الحقيقية الآخرة». لكن في المقابل، حصنت أخلاق النجاة نفسها من النقد الأخلاقي الديني، بصناعة شكل من التدين يلتزم تمامًا بتعاليمها، مقابل الإيمان بـ«الحقيقة الدينية»، لضمان كلٍّ من الدنيا والدين، دون أي تعارض.
لهذا، فعادة ما تكون النسخ الشعبية للدين هي الأكثر محافظة، المبتعدة عن أي صراع، والمتمحورة حول «التسليم» بالدين، لا بضرورة العمل بتعاليمه، وكذلك التسليم بالدنيا وقواعدها، وهي تمقت خرق عهد «التسليم» هذا بالجرأة على التشكيك ومساءلة الدين، وأحيانًا الدنيا، أكثر بكثير من خرق التعاليم الدينية نفسها.
لكن هل يعني كل ذلك، أن أخلاق النجاة لا تطمح إلى أي تغيير، وترجو المحافظة على الواقع أيًّا ما يكون؟
السياسة كتغيير
الماضي كذكرى، سيكون دائمًا أكثر استقرارًا لأنه يمكن توقع قواعده. لكن الواقع، أي واقع، يظل أعقد في الممارسة، حتى لو كانت ممارسة النجاة نفسها. فهو منفلت ومتغير، لذلك ترتبط أخلاق النجاة دائمًا بحنين إلى عصور أخرى كانت الصورة فيها أوضح، وكانت الحياة أهدأ وأبطأ وأكثر روتينية.
هذا الحنين إلى الماضي، هو بالطبع حنين إلى ماضٍ متخيَّل. والسياسة المحافظة، عن طريق السعي نحو إعادة هذا الماضي، تكون، في التحليل الأخير، مشروع تغيير، وما يجعلها مختلفة عن بقية الأفكار التغييرية الكبرى أنها لا تَعِد بعالم جميل ومثالي في المستقبل.
تهتم المحافظة بأخلاقيات النجاة وتخضع لحقيقة السلطة، وليس لسلطة الحقيقة. لكنها في سعيها للخضوع تقاوم أنماط المقاومة نفسها، وتحمي نفسها بحماية السلطة التي تخضع لها.
هناك فكرة سحرية، غير بديهية بأي شكل، تمكَّنت من فرض نفسها في العصور الحديثة، هي أن بوسع الناس تغيير واقعهم للشكل الأكثر مثالية لهم.
الواقع لا يستمر بذاته، بل يحتاج معه مشروعًا يعمل على إدامته. المحافظة هي هذا المشروع في وجه مشروع طَموح آخر، أصبح يرى التغيير حتمية تاريخية لا يمكن الوقوف في وجهها بأي حال.
تجمع أخلاقيات النجاة بين أمرين قد يبدوان متناقضين للوهلة الأولى: النظر إلى أي تغيير على أنه أسوأ ما يمكن أن يحدث، وفي الوقت نفسه، التعامل مع الحاضر، المرتبك كثيرًا مقارنة بالصورة الرتيبة للماضي المتخيل، على أنه انحدار لا يمكن نكرانه عن هذا الماضي نفسه.
هناك فكرة سحرية، لكن غير بديهية بأي شكل، تمكَّنت من فرض نفسها في العصور الحديثة، هي أن بوسع الناس تغيير واقعهم إلى الشكل الأكثر مثالية لهم. هذه الفكرة تخالف كل أخلاقيات النجاة، بتوجهها نحو المثال، بهروبها إلى الأمام، ورفض الاختباء من العالم الموحش.
لكن أخلاقيات النجاة، أصلب وأكثر تجذرًا في العالم، إذ إن أي فلسفة لا يمكنها أن تغض النظر عن النجاة تمامًا، وربما لذلك أصبحت كل الجنان الدنيوية تروِّج ليس فقط لضرورتها الإنسانية، لكن أيضًا لحتميتها التاريخية. أنت يجب أن تصبح ليبراليًّا، ليس لأن ذلك الخيار صحيحًا فقط، لكن لأن ذلك هو مسار العالم الذي يتقدم إليه، ويجب عليك أن تساير التاريخ في سيره، لأن محاولة إيقافه لن تعود عليك إلا بالفشل. هنا بالتحديد تكمن مغامرة المحافظة.
مغامرة السكون
تنجح المحافظة في النجاة، في حال صحة رهانها على أن التشبث بالواقع أكثر أمانًا من محاولات تغييره. لكن هذا الرهان يفترض بجوار هذه الفرضية، فرضية أخرى أكثر أولوية، وهي أنه من الممكن فعلًا تثبيت الواقع كما هو. لكن ماذا لو كان الواقع يتغير بالفعل؟
جزء أساسي من دعاية الأفكار اليوتوبية الحديثة أن انتصارها حتمي، وليس فقط أن عالمها الموعود أكثر جمالًا.
في مواجهة التغيرات السريعة والجذرية لأي واقع، يجد بعض المحافظين أنفسهم في خضم رد فعل شديد الجذرية والمغامرة ضد هذه التغيرات بشكل لا يتسق مع أخلاقيات النجاة، بل يحمل إمكانيات تضحية كبيرة في حالة الخسارة.
فالأفعال الرتيبة التقليدية الآمنة في زمن ما، قد تصبح في الأوقات العامرة بالتغيرات، أفعالًا مغامِرة، لأنها تختار التشبث بواقع ينتهي بالفعل. وكلما أصبح فناء هذا الواقع أكثر احتمالًا، اشتدت مقاومة التغيير هذه إلى درجة المغامرة بخسارة أي مكان في العالم الجديد.
يجوز ذلك في الاقتصاد كما السياسة. فصاحب المهنة الذي يختار أن يستمر في نفس نمط عمله بدلًا من المغامرة بالتجديد، قد يجد نفسه بعد سنوات قلائل، وقد أصبح جزءًا من الماضي الذي كان يومًا ما واقعًا يتشبث به، ليفاجأ بأن فعل التغيير الذي رفضه كان أقرب إلى النجاة من استراتيجيته المحافظة.
هذا هو منطق كل الأفكار التغييرية في العصر الحديث. جزء أساسي من دعاية الأفكار اليوتوبية الحديثة أن انتصارها حتمي، وليس فقط أن عالمها الموعود أكثر جمالًا. الماركسية تزعم أن العلم يثبت أنها قادمة لا محالة، وانتصار الطبقة العاملة هو حركة التاريخ التي لا يمكن إيقافها. والليبرالية تزعم أنها نهاية التاريخ، ولا يمكن تطور أي شيء آخر غيرها، وللنجاة ينبغي الانضمام إليها بدلًا من مقاومتها دون جدوى. الإسلاميون يقولون إن انتصارهم وعد إلهي لا يمكن لبشري أن ينقضه. هكذا تُسوَّق الأفكار التغييرية التي تتطلب تضحيات كبرى، على أنها هي سبيل النجاة، وليس أي شيء آخر.
رهان المحافظة في النهاية قد يكون ذا فاعلية لو صحت فرضيته بإمكانية دوام الواقع إلى الأبد. في حالة خطأ ذلك، فأخلاقيات النجاة، مثل الأفكار التي تحاربها، تغامر بكل شيء.





