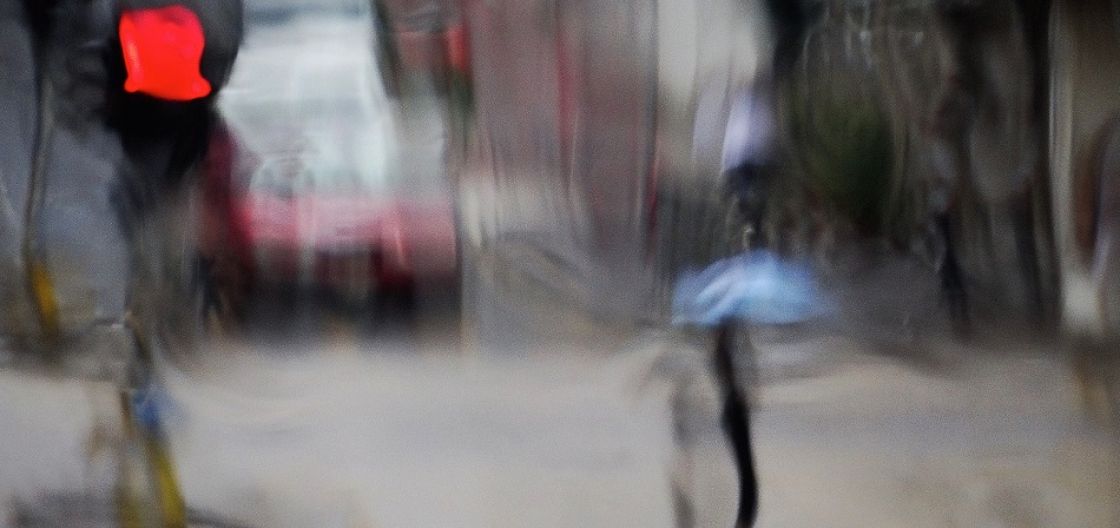حسنٌ، من أين أبدأ؟ أظن أن هذا سيكون من أصعب الموضوعات التي أكتبها مع «منشور». في كل موضوع كتبته هنا، كان لدي مجموعة أفكار واضحة أريد أن أطرحها. أما الآن، فلدي سحابة كثيفة لا بداية لها أو نهاية.
طوال الوقت، أشعر بأن هناك عددًا ضخمًا من العمال داخل خلايا دماغي. لا أدري لِمَ هم هنا تحديدًا، لكنهم في حالة مستمرة من الحركة. يبني أحدهم بيتًا هناك، يسب آخر زميله ويطرحه أرضًا، تسير مجموعة حاملة أكوامًا من الخردوات، يبصق أحدهم على الأرض في حنق، يبكي ثانٍ في إحدى الزوايا، بينما تسير وسط كل هذا عجوز تحمل مكنسة خشبية وتحاول التنظيف. دائمًا هناك من يحاول تنظيم تلك الفوضى العارمة، لكن دون أي جدوى.
التساؤل خطير لأنه سيقودك حتمًا إلى تساؤل أكبر. وبمجرد أن تسمح لنفسك بالانجراف وراء التساؤل الأول، ستنهال فوقك البقية دون توقف. التأمل يمنحنا عينًا ثاقبة لكثير من أوجه الحياة، يساعدنا على الفهم. لكن لكل شيء ثمنًا، وثمن التأمل الوقوع في حلقة دائمة من الأسئلة.
هناك من يعرف أنك ستنجرف وراء التساؤل الأول، وهو يقبع تحديدًا في داخلك: عقلك. إنه يعرف أن هذا العالم كبير جدًّا، وأن محاولتك فهمه ستكون عملية شديدة الإرهاق عليك. لذلك، فهو يحميك. طرقه الأمثل لذلك؟ تغييبك. منْحك المُعطيات التي تريحك فقط. إزاحة كل الأفكار المزعجة بالنسبة إليك. جعلك لا ترى إلا ما يتوافق معك، وفي نفس الوقت تظن أنك ترى كل شيء.
يحزنني إذًا إخبارك بأن كل ما تعرفه عن العالم مشكوك بأمره، أن كل حقيقة تؤمن بها ليست حقيقة في الأصل، وإنما مُعطى اختاره لك عقلك، وأن هناك دائمًا على الجانب الآخر من يؤمن بشيء مناقض لك تمامًا، لكنه يظن أنه الحقيقة، وله في ذلك أسبابه التي يظنها ثوابت.
كيف يحدث ذلك إذًا؟ كيف يغيِّبنا عقلنا بينما نشعر طوال الوقت بأننا واعون بشأن اختياراتنا؟ ما معنى أن يكون لكل شيء في العالم وجهان متناقضان تمامًا، لكنهما صحيحان؟ لنرَ.
الانحياز التأكيدي: مصفاة في عقلك تنتقي المعلومات

«الانحياز التأكيدي» (Confirmation Bias) أحد أنواع الانحيازات في علم نفس. يخبرنا هذا المبدأ بأنه في كل مرة يراودك سؤال وتحاول البحث عن إجابته، تختار المعلومات التي تتوافق مع ما تؤمن به مُسبقًا، أو ما تعتقد أنه الصواب. خلال هذه العملية، يعمد عقلك إلى تجاهل المعطيات التي لا تتوافق معه، أو التي يمكنها أن تسبب لك الإزعاج.
قد نضرب على ذلك مثالَ مواطن أمريكي عليه أن يُدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بين مُرشح أبيض وآخر أسود. هذا المواطن وُلِدَ في ولاية معروف عن غالبية سكانها العنصرية ضد السود، لذلك، فإنه نشأ منذ الصغر على أن البيض أذكى من السود، وأنهم صالحون أكثر لتولي المناصب.
هذا المواطن الآن مطالَب بالاستماع لخطَب المرشحَيْن وقراءة البرامج الانتخابية للاختيار بينهما. ماذا سيفعل عقله هنا؟
سيعمد إلى انتقاء عبارات من خطَب المرشح الأسود وتفسيرها بطريقة تدل على غبائه. سيقرأ خطط البرنامج الانتخابي بنفور داخلي يجعله يشكك في قابلية تنفيذها. سيصدق بسهولة شديدة أي شائعات تُطلَق عن المرشح الأسود. في المقابل، نفس المواطن سيستمع لخطَب المرشح الأبيض باحترام. سينتقي عبارات يتغنى بها كدليل على ذكاء مرشحه وحنكته. سيرفض بشراسة الشائعات التي تُطلق عنه، ويتمتم بغضب أنها مُغرضة أطلقها المنافسون لإسقاط الرجل.
في وسط كل ذلك، لن يرى مواطننا الأمريكي سوى أن لديه أسبابًا واضحة لآرائه. المرشح لا يصلح لأن خطبه، وفقًا لتفسيره، مليئة بالسقطات. البرنامج الانتخابي كاذب لأن خططه شديدة التفاؤل. لن يعترف لنفسه بالسبب الحقيقي لكل تلك التفسيرات، وهو ترسُّخ فكرة أفضلية البيض عن السود في رأسه.
كل شيء خاضع لنفس المصفاة في عقلك. تنتقي المعلومات دون وعي، ثم تظن أن رأيك مُدعَم بالأدلة والحقائق.
في تجربة عام 1979، جُلبت مجموعة من المعارضين لأحكام الإعدام ومجموعة أخرى من الداعمين للفكرة. عُرِضَ على المجموعتين بحثان اختلقهما منفذو التجربة. كان البحث الأول يعطي نتائج تؤيد فكرة أن أحكام الإعدام تقلل نسبة الجرائم، بينما الثاني نتائجه تُظهر العكس.
كما هو متوقع، الفريق المُعارض لأحكام الإعدام انتقد البحث المؤيد، وحاول إظهار نقاط ضعفه، بينما وصف البحث المُعارض بأنه «مُقنع». وحدث العكس تمامًا في الفريق الثاني.
بتلك الخطورة، وإلى هذا الحد، يسيطر علينا الانحياز التأكيدي. أنت، دون قصد، تحاول أن تجعل توقعاتك تتحقق. الإنسان مستعد دائمًا لتصديق ما يريد تصديقه، بل ربما يسعى دائمًا لتصديق ما يريد تصديقه.
قِس ذلك على الأفكار الأكبر في الحياة: الدين والسياسة والآراء العلمية. كل شيء خاضع لنفس المصفاة في عقلك. تنتقي المعلومات دون وعي، ثم تظن أن رأيك مُدعَم بالأدلة والحقائق. هل أنت متأكد؟
تأثير النتيجة العكسية: المكان كله مُحاصر.. بأفكارك

عندما تتعارض دلائل صريحة وواضحة مع عقائدك، فإنها لا تتغيَّر، وإنما تزداد قوة. هذا تحديدًا تعريف «تأثير النتيجة العكسية» (Backfire Effect).
في تلك الحالة، لن تنتقي معلوماتك وحسب، وإنما ستعمل المعلومات التي تعارض أفكارك هكذا: ستجعلها أقوى بدلًا من أن تدعوك إلى تغييرها. هناك تفسير يقول إن هذه محاولة من عقلك لحماية العقائد الرئيسية التي ترتكز إليها، قبل أن تطالها الأدلة المتعارضة.
في كتاب «التجربة الفكرية لروح أمه»، الذي يخوض في علم النفس وقصصه بشكل مبسَّط، يصور الكاتب كيرلس بهجت هذا المبدأ النفسي بطريقة لطيفة. هناك شخص يُدعى شريف، وقد اكتسب لتوِّه معلومة جديدة. ستدخل المعلومة إلى مخه لتستقر في مكانها المحدد. المفاجأة أن مخ شريف يحمل معلومة متعارضة تمامًا تستقر في نفس المكان. كيف تتصرف المعلومة الأقدم؟ التصرف الطبيعي: ستحارب من أجل بقائها. هكذا تزداد قوة داخل شريف.
تنصحنا بعض المصادر بتقليل الأدلة التي نعرضها على شخص إن كنا نريد بالفعل تغيير إيمانه بفكرة ما.
في تجربة أُجريَت على مصوِّتين في انتخابات مختلَقة، وجد الباحثون أن منْحَ أحدهم معلومات معارضة عن مرشحه يجعله أكثر تمسكًا واقتناعًا، وليس العكس. في تجربة أخرى، وجد الباحثون أنه حتى التقارير الرسمية التي تصحح معلومات نُشرت في الصحافة، لم تفلح في تغيير آراء المقتنعين بالمعلومات المغلوطة.
كان جميع المشاركين من المقتنعين بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل قبل الغزو الأمريكي. عرض الباحثون عليهم مقالات تروِّج لتلك الفكرة، ثم عرضوا عليهم مقالات وتقارير رسمية تصحح المعلومات التي في المقالات الأولى، وتؤكد أنهم لم يجدوا أسلحة دمار شامل في العراق قبل الغزو. وُزِّعت بعض الأسئلة على المشاركين لبيان رأيهم. النتيجة؟ بشكل غريب، وجد الباحثون أن المشاركين أصبحوا أكثر اقتناعًا بإيمانهم بوجود أسلحة في العراق من ذي قبل. هكذا يمكن لعقلك أن يُحدِث «نتيجة عكسية».
المفاجأة أنك كلما قدَّمت إلى أحدهم دلائل على أن إيمانه خطأ، ازداد تمسكه به. العلاقة هنا طردية بدلًا من أن تكون عكسية. لذلك، وبشكل عجيب، نجد بعض المصادر تنصحنا بأن نُقلل من الأدلة التي نعرضها على شخص إن كنا نريد بالفعل تغيير إيمانه بفكرة ما. بدلًا من أن تقدِّم له 10 أدلة تنفي فكرته، قدِّم له ثلاثة.
هل تتصور مدى الرعب هنا؟ عقلك يتخذ وسيلة دفاعية ضد ما يصحِّح أفكاره، بدلًا من أن يعطيك مساحةً للتفكير، بل تزداد دفاعاته شراسةً كلما أغرقته بمزيد من الأدلة.
فرضية العالم العادل: هكذا الحياة

ربما تابعتَ واقعة التحرش التي حدثت في مصر، حين طلب أحدهم من فتاة أن ترافقه لتناول القهوة في «أون ذا رن». لم يصدمني ما حدث بقدر ما صدمتني التعليقات التي جاءت بعده: «بالطبع كانت ترتدي ملابس مُلفتة، وإلا لِمَ سيحدث هذا؟»، «ربما طريقة وقفتها هي التي أظهرت له أنها تريد محادثته»، «بالتأكيد فعلتْ شيئًا جعله يتشجع لهذا الفعل»، هكذا انهالت التعليقات من كل مكان.
حسنٌ، قبل أن تسب أو تلعن، دعني فقط أخبرك بأن كثيرًا من أصحاب تلك التعليقات وقعوا ضحية فخ نفسي مفترس: «فرضية العالم العادل» (Just-world Hypothesis).
هذا المبدأ النفسي يقوم على إيمانك بأن العدل أساس هذه الحياة. يلجأ عقلك إلى ذلك التوهُّم لحمايتك من تبعات الأحداث الصادمة التي تقع في العالم كل لحظة. في هذا المبدأ، سيخبرك عقلك بأن ضحية هذا الحادث أو ذاك بالتأكيد ارتكب ذنبًا جعله يستحق التعرض للحادث. الضحية هو المُخطئ. الفتاة تحرشوا بها لأنها ترتدي ملابس مثيرة.
لِمَ يلجأ عقلك لذلك؟ ببساطة، لأنه إذا وقع ذلك الحادث القاسي لأحدهم دون أن يفعل شيئًا يسبِّب وقوعه، يعني أنك أنت أيضًا مُعرَّض للوقوع ضحية نفس الحادث في أي وقت دون أن ترتكب شيئًا. فكرة أن العالم عادل تعني أن أحدًا لا يطاله أذًى إلا لو كان يستحقه، ولذلك، فلديك على الأقل فرصة طوال الوقت حتى لا «تستحق» هذا الأذى.
ماذا لو أدرك عقلك أن الأذى يطول الأبرياء وأن الحياة غير عادلة؟ لن يبقى لديك فرصة للهروب. ستعيش جحيمًا من القلق والخوف أن يصيبك ما أصاب غيرك. لا ضامن هنا.
العجز إحساس شديد القسوة. إن كان بإمكاننا الاختباء منه، فسنفعل ذلك دون تردد.
من أهم التجارب التي أُجريَت عن هذا المبدأ، تجربة العالم «ميلفن ليرنر» عام 1966، وهي ما أدت بالأساس إلى ظهور مصطلح «فرضية العالم العادل».
في تلك التجربة، جمع الباحثون 72 طالبة وأخبروهن بأن الهدف هو رؤية تأثير الضغط على القدرة على التعلُّم. أخبروهن كذلك بأن التجربة ستُجرَى على طالبة مثلهن، وأنها ستتعرض لصدمة كهربائية في كل مرة تكون إجابتها على أسئلة الممتَحِن خطأ.
قُسِّمت الفتيات بعد ذلك إلى فريقين: واحد أُخبِرَ أن بإمكانه تغيير مصير الفتاة بالتعامل مع أخطائها بشكل أكثر إيجابية بدلًا من الصدمات، وآخر أُخبِرَ بأنه لا شيء بيديه لتغيير مصير الفتاة، ولا بد من استمرار التجربة. بعد ذلك، سأل الباحثون الفتيات عن آرائهن في الفتاة. ماذا تتوقع؟
الفريق الذي استطاع أن يغيِّر مصير الفتاة كانت آراؤه إيجابية بشأنها. استقرت معظم الآراء على أن الفتاة بريئة ولا تستحق العقاب، لذلك وافقوا على تغيير مصيرها. ماذا بشأن الفريق الآخر؟ المجموعة التي لم تستطع تغيير مصير الفتاة جاءت آراؤهم سلبية بشأنها: الفتاة تستحق ما حدث لها بطريقة أو بأخرى. الإجابة بشكل خاطئ لا بد لها من عقاب برغم كل شيء. هكذا جاءت الإجابات.
العجز إحساس شديد القسوة علينا. إن كان بإمكاننا الاختباء منه، فسنفعل ذلك دون تردد. الضحية هي المخطئة. العالم مكان عادل.
تحكي صديقتي أن والدها كان مرةً يشاهد التلفزيون، حين عرض المذيع نتائج استبيان تقول إن أكثر من 90% من نساء مصر تعرضن للتحرُّش بشكل أو بآخر. تقول صديقتي إن والدها انفعل: تلك النسبة بالتأكيد خطأ، مَن يتعرضن للتحرش هن فقط من يرتدين الملابس المثيرة، ويسِرن في الشوارع بعد منتصف الليل. كانت على وشك أن تصحِّح له الأمر، أن تحكي عما تتعرَّض له يوميًّا بملابسها الفضفاضة في وضَح النهار، لكنها تراجعت في اللحظة الأخيرة.
تذكَّرتْ صديقتي أن لديها من الأخوات ثلاثة، وأن إيمان والدها باستحقاق فتيات بعينهن للتحرُّش بسبب مظهرهن أو غيره، ربما يكون الشيء الوحيد الذي يحميه من إدراك عجزه عن حماية بناته مما قد يتعرَّضن إليه، دون ملابس مثيرة أو تأخُّر في الشارع بعد منتصف الليل، فقط لأن ذلك قد يحدث لأي فتاة.
هل نحن أقوى أم أضعف مما نعتقد؟
هناك أشياء لا حصر لها تؤثر في رؤيتك للخطأ والصواب. محاولاتك فهم العالم ستبوء بالفشل لأنك ستفهمه دائمًا بناءً على إطار بعينه. بينما يوجد طوال الوقت عدد لانهائي من الاحتمالات والطرق الأخرى.
لا تحتقر أحدهم لأنه لا يؤمن بما تراه أنت «بدهيًّا». كلنا هنا، عالقون في الوجود. وكلنا، بشكل أو بآخر، لا نفهم شيئًا.
في الإنجليزية لديهم مصطلح «Put yourself in his shoes»، ومعناه الحرفي أن تضع نفسك في حذاء الشخص الآخر كي ترى الموقف بعينه هو لا بعينك. في العربية نقول: «ضع نفسك مكاني». ربما يساعدك ما ذكرناه على تطبيق المثَالين في المستقبل، أن تدرك فقط أننا مختلفون، وأن كل واحد منا يرى الأشياء بعينيه، وكلٌّ منا يظن أنه على الحق.
كل ما تتعرض له من تجارب وخبرات يتراكم في النهاية ليصنعك. ما حدث لك في الماضي يشكِّل، بشكل ما، ما أنت عليه الآن، فيؤثر في نظرتك إلى الأمور، وفي الجانب الذي ستنحاز إليه وتظنه الصواب. تخيل عدد سكان الأرض والتجارب التي تعرَّض لها كل واحد منهم والطرق التي يتخذونها بناءً على ذلك. قد يقودك هذا وحده نحو الجنون.
ينصحنا الفيلسوف الفرنسي «ديكارت» بأن نُسقِطَ كل ما نؤمن به، نتخلص من كل إطاراتنا، ثم نبدأ البحث عن الحقائق كأننا وُلِدنا للتو.
تقول إن تصديق وجود مثلث برمودا أو الفضائيين أو التناسخ خرافة. لكن هل أنت متأكد؟ تقول إن إيمانك وأفكارك هي الحق لأنك توصلت إليها عن اقتناع، لكن هل أنت متأكد؟ تشفق على جارك الذي لا يشاركك القناعات لأنه مسكين لا يرى «الحقيقة»، لكن هل أنت متأكد من أنك تراها؟
قد يهمك أيضًا: هل نحن الخير أم الشر؟
هوِّن على نفسك. لا تتعصَّب لفكرتك كثيرًا. لا تقاطع شخصًا تحبه لأن رأيه السياسي يختلف عن رأيك. لا تتهم غيرك بالغباء وتظن نفسك أفضل منه. لا تحتقر أحدهم لأنه لا يؤمن بما تراه أنت «بدهيًّا». كلنا هنا، عالقون في الوجود. وكلنا، بشكل أو بآخر، لا نفهم شيئًا.