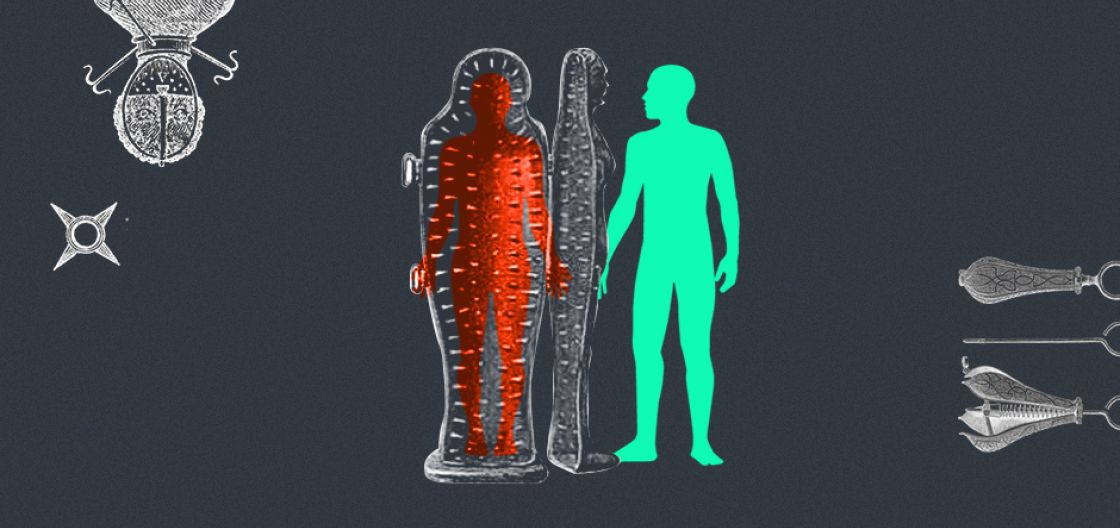تبدأ حكاية إدراك البشر للقسوة بدهشتهم من ممارسة الآخرين لها، لا أحد بالطبع ينظر للقسوة في نفسه، المشكلة دائمًا في الآخرين، إذ كيف يخرج الآخرون ولو بشكل مؤقت عن آدميتهم، فيصيروا وحوشًا ويمارسوا أنواع العنف المختلفة على غيرهم من البشر؟ ومن أين تأتيهم هذه القسوة؟ هذا ما تناقشه صحيفة النيويوركر في أحد تقاريرها الأخيرة.
بدأت المحاولات الجادة لدراسة القسوة أكاديميًا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وكانت موجهة بالأساس لفهم ممارسات الألمان المروّعة ضد كل من اعتبروه عدوًّا أو لا يستحق الحياة مثل اليهود والغجر.
تمحورت أغلب المحاولات التفسيرية حول فرضية تشييء المعتدي لضحاياه وتجريدهم من آدميتهم، أيْ افتراض أن القسوة لا يمكن حدوثها إذا كان المعتدي يرى ضحاياه بشرًا مثله، إنما يجب تحقق ظروف تجبره على تشييئهم أو النظر إليهم عمومًا ككائنات أدنى، حتى يتمكن من تنفيذ قسوته بغير عوائق داخلية. واستمرت هذه الفرضية بجمع مناصرين لها حتى بدأت مؤخرًا في التخلخل، كي تترك المجال أمام فرضية أخرى، أشد إرعابًا بكثير، لأن تظهر وتحتل الجزء الثاني من الحكاية.
الفصل الأول: هناك من يتحكم في دماغي رغمًا عني!

تبدأ إحدى حلقات المسلسل التليفزيوني الشهير «Black Mirror»، بجنديّ يقتل كائنات شبيهة بالبشر تسمى الصراصير. تيمة عادية للغاية عن البطل في مواجهة الوحوش. لكن تنطوي الحيلة الدرامية على اكتشافنا، المتزامن مع اكتشاف الجندي، لوجود رقاقة خاصة مزروعة في دماغه ودماغ باقي كتيبته، تجعله يرى أهدافه «أفراد مجموعة تحتقرها الدولة» بشكل مشوّه، وكأنهم وحوش، ويسمع أصواتهم كصرخات غير بشرية، منفّرة.
بعد أن شاهد الفيلسوف البريطاني ديفيد ليفينغستون سميث هذه الحلقة تساءل عما إذا كان مؤلفها قد قرأ كتابه: «أقل من إنسان: لماذا نذِلّ ونستعبد ونبيد غيرنا من البشر»، فالحلقة تتمحور حول فكرته الرئيسية: إن أفعال القسوة، كالإبادة مثلًا، تحدث عندما لا يستطيع القائمون بها إدراك الإنسانية المشتركة بينهم وبين الآخرين، أيْ أن الجندي ما كان ليقتل هؤلاء الناس لو أدرك إنسانيتهم منذ البداية. تكمن الأزمة إذن، والدراما بالطبع، في حدوث حالة تنزع عن الضحايا إنسانيتهم في عين المعتدي، كزرع رقاقة في الدماغ مثلًا!
يقول عالم النفس النمساوي هيربرت سي كيلمان مؤكدًا: «إن المثبطات الرادعة لقتل البشر قوية جدًا بشكل عام، ما يستلزم تجريد الضحايا من اعتبارهم الإنساني كي يمضي القتل الممنهج بطريقة سلسة ومنظمة». وقد استخدم النازيون تعبيراتٍ بيروقراطيةً كـ«النقل، والاختيار» لوصف أنواع القتل المختلفة وتحييدها، بهدف تسهيل تأدية الجنود والضباط لمهام يقاومها البشر عادة. فالجندي هنا إذن لا يقتل، بل يمارس عملية اختيار وتطهير، ولا يسوق الضحايا إلى أماكن يُقتلون فيها، بل «ينقلهم» لا أكثر.
نحن جميعًا قساة، الآن

لكن الأمر لم يتوقف عند الماضي، فقد لاحظ العلماء تفشي ظاهرة القسوة في عالمنا المعاصر.
بتطبيق ملاحظة العالم الأنثروبولوجي كلود ليفي شتراوس: «ينتهي مفهوم الإنسانية عند حدود القبيلة، أو المجموعة اللغوية، وأحيانًا حتى عند حدود القرية». اكتب في خانة البحث بغوغل اسم أكثر مجموعة بشرية تكرهها، اليهود، العرب، الزنوج، الشواذ، أو غيرهم، وستجد اقتراحات البحث تدعمك بألفاظ كـ«حشرات، صراصير، حيوانات»!
تُروى حكايات القسوة في التاريخ البشريّ عادة، وكأنها تحدث للآخرين، أو للدقة، يمارسها الآخرون. وكانت بدايات الدراسات النفسية عن القسوة تبحث في أسباب اختلاف النازيين عن غيرهم، لكن علماء النفس صاروا يتحدثون عن عمومية القسوة، وعن انتشار ظاهرة تجريد الآخرين من إنسانيتهم في كل مكان.
حيث يقدم نيك هاسلام وستيف لونان قائمة بأمثلة متكررة وعادية للغاية: «يصف الجمهور الغاضب المعتدين جنسيًا بأنهم حيوانات. يعامل السيكوباتيون ضحاياهم كمجرد وسائل لتحقيق أهدافهم الخبيثة. يُنظر للفقراء بسخرية على أنهم حمقى شهوانيون. تعبر نظرات المارة أجساد المتشردين وكأنهم كيانات شفافة. يُعرض كبار السن المصابين بالخرف على الشاشات كموتى أحياء متخبطين».
اقرأ أيضًا: العنف الأخلاقي: أعداؤنا بشر مثلنا.. ولهذا نقتلهم
الفصل الثاني: الإنسان ليس قردًا!

لو كان المتفرجون النازييون يعتبرون اليهود أقل من بشر، ولا تؤثر الإهانة فيهم، ما استمتعوا بإهانتهم في «حفلات التنظيف» المهينة.
بعد توسيع دائرة النظر في القسوة بإضافة الحاضر إليها وإضافة أنفسنا للآخرين في المعادلة المرعبة ذاتها، بدأ بعض الباحثين ينتبهون لكون التشييء والتجريد من الإنسانية يبطل المفعول المطلوب من القسوة في أحايين كثيرة.
في بعض مباريات كرة القدم الأوروبية، يقلّد المشجّعون الأوروبيون أصوات القرود ويلقون بالموز على اللاعبين الأفارقة. ربما يبدو هذا الوصف العنصري للأفارقة بالقرود كامتداد لفرضية التشييء، لكن من الواضح أن هؤلاء المشجعين لا يعتقدون فعلًا أن اللاعبين قرود، فالغرض من سلوكهم هو إهانتهم وتشتيتهم عن اللعب. وتنبني ثقة المشجعين بفعالية سلوكهم على افتراض شعور اللاعبين بالخجل والإهانة، ما يعني أنهم يعتبرونهم بشرًا لا حيوانات، فلو كانوا حيوانات ما تأثروا، ولفقدت القسوة جدواها.
ويصف تيموثي سنايدر ما حدث بعد احتلال هتلر للنمسا عام 1938 في كتابه: «أرض سوداء: الهولوكوست كتاريخ وتحذير»:«في الصباح التالي بدأت (حفلات تنظيف الأرضيات). جمع أعضاء كتيبة العاصفة اليهودَ عن طريق القوائم أو المعرفة الشخصية أو معرفة المارة، وأجبروهم على الركوع وتنظيف الشوارع بفراشي التنظيف. كانت هذه الإهانة وكأنها طقس شعائري. فجأة، ركع اليهود، وكانوا في الغالب أطباء ومحامين أو غيرهما من المهنيين، على ركبهم، لتأدية عمل مهين أمام حشود ساخرة.
ذكر إرنست بي مشهد (حفلات التنظيف) كـ(تسلية للشعب النمساوي). ووصفَ صحفيٌّ (الشقراوات الفيينيات الرقيقات يزاحمن بعضهن للاقتراب من المشهد الرائع للجراح اليهودي ذي الوجه الشاحب والراكع على يديه وركبتيه أمام مجموعة من الشباب الشرسين بصلبان معقوفة على أذرعهم وأسواط كلاب في أيديهم). وفي الوقت نفسه، تعرضت الفتيات اليهوديات للتحرش الجنسي، وأُجبر الرجال الأكبر سنًا على تأدية تمرينات رياضية أمام العامة».
لو كان المتفرجون يعتبرون اليهود أقل من بشر، ولا تؤثر الإهانة فيهم، ما استمتعوا بإهانتهم. فمنطق هذه القسوة كمنطق الاستعارة اللغوية: إقامة التشابه بين شيئين مختلفين يستمد قوته من اختلافهما ذاته. وهكذا تكمن متعة معاملة البشر كالحشرات في إدراك أنهم ليسوا كذلك بالأساس.
من أين جاءت القسوة؟

لكن بعد هدم نظرية التشييء، صار ضروريًا ظهور فرضيات جديدة تنسب هذه القسوة التي نُزعت من سياقها إلى مبررات أخرى.
يفسّر بعض علماء الاقتصاد وعلماء النفس التطوريون الاعتداء والاغتصاب والقتل كأفعال منطقية تفيد المعتدي أو جيناته في الأجيال القادمة، أيْ أنها تخدم غرضًا مفيدًا للمعتدي الذي سيخشاه الجميع فيما بعد وسيزيد من نسله ويحافظ عليه.
أمّا في علم الجريمة، فيُنظر لأغلب السلوكيات العنيفة على أنها نتيجة لفقدان التحكم، وأن أغلب الجرائم ترتكب تحت تأثير المخدرات والخمور، وأن لهؤلاء الجناة قدرة ضعيفة على التحكم في أنفسهم في باقي نواحي حياتهم أيضًا.
ثم عرض عالم الأنثروبولوجيا آلان فيسك وعالم النفس تاجي راي وجهة نظر أخرى في كتابهما: «العنف الفاضل: الإيذاء والقتل بقصد خلق واستدامة وإنهاء وتبجيل العلاقات الاجتماعية». ففي الكثير من الأمثلة، لا يكون العنف حلًا لمشكلة أو عجزًا عن التحكم في النفس، كما لا يستلزم تجاهلًا للاعتبارات الأخلاقية، بل على العكس، تكون الأخلاق في الغالب عاملًا محفّزًا: «يُدفع الناس للعنف حين يشعرون أنه لتنظيم علاقات اجتماعية معينة، يكون إيقاع المعاناة أو القتل ضروريًا وطبيعيًا وشرعيًا ومرغوبًا ومغفورًا ومبجلًا ومشبِعًا أخلاقيًا».
ويكون المعتدي في هذه الحالات مدفوعًا برغبة في فعل الصواب، أو الانتقام، أو تلقين الآخر درسًا. وهناك علاقة مباشرة بين هذا النوع من الأفعال، وعقاب المجرمين الذي يشرّعه النظام القانوني. فالعنف الأخلاقي، سواء في العقوبات القانونية أو قتل الأعداء في الحرب أو عقاب أحدهم لتجاوز أخلاقي، يحفزه إدراك أن الضحية كائن إنساني، مدرك لهذه الأخلاقيات هو الآخر، وبالتالي لن يكون العقاب عبثيًا، بل سيحقق التأثير المطلوب منه.
الفصل الثالث: لماذا نكره النساء؟ لأنهن بشر!

يمكن لتفسير العنف تجاه النساء أن يخدم حكايتنا كثيرًا. ففي دراسة أثارت جدلًا كبيرًا، تحاول الفيلسوفة كيت مين تغيير الأفكار السائدة عن العنف الجنسي، برفضها نظرية التشييء والتجريد من الإنسانية، حيث ترى أن وصف المغتصبين بالوحشية يقلل من حجم القضية، ويجعلنا نتغافل عن الاحتمالية المربكة لأن يكون المعتدون مدركين تمامًا أن هؤلاء الذين يعاملونهم بقسوة وامتهان هم بشر مثلهم، وأن تلك البشرية بالذات هي المشكلة. ففي الغالب، في حالات ممارسة معاداة النساء، لا ينقص المعتدي شعورٌ بإنسانية المرأة، بل على العكس، الأزمة هي إنسانيتها.
اقرأ ايضًا: لماذا تتقبل المرأة العربية عنف الرجال؟
إمّا الحب أو القتل
تقترح «مين» فرضية أن الرجال يتوقعون من النساء أشياءً معينة، الاهتمام والإعجاب والتعاطف والمواساة، وبالطبع، الجنس والحب. ومعاداة النساء هي العقلية التي تحكم وتراقب وتفرض تنفيذ هذه الأهداف، وينبغي بالطبع معاقبة النساء اللاتي يفشلن في منح الرجال ما هم في حاجة إليه أو، الأسوأ، يرفضن فعل هذا.
وفي دراسة حالة لمعاداة النساء، تطرح «مين» أمثلة كثيرة لأشكال العنف ضد المرأة، بدءًا من التي لا تترك أثرًا واضحًا كالخنق الذي يمارسه الأزواج على زوجاتهم لتعيين صاحب السلطة والتحكم في العلاقة، إلى العنف التعبيري الذي يقصد به ترك علامة واضحة، كإلقاء الأحماض الكاوية عليهن، مثلما يحدث مع النساء في بنجلاديش وغيرها.
يكون الدافع لهذه القسوة عادة رفض المرأة الزواج أو الجنس أو حب أحد الرجال. وقد يُقتل أطفالها وتُترك هي حية لتتحول إلى مُشاهِد، يكون رد فعله مهيّجًا لخيال وغريزة المعتدي عندما يقول لها بعتاب قاسٍ: انظري ما الذي دفعتني لفعله؟
تجريد البشر من إنسانيتهم لا يكون دومًا أمرًا سيئًا، كما في حالة الجراحين داخل غرفة العمليات، حيث يتعاملون مع المرضى كأجساد فقط ليتمكنوا من مواصلة عملهم.
وتعرض «مين» أيضًا قضية إليوت رودجر الذي أخذ يقتل الناس عشوائيًا بعد رفض طلبه بالانضمام لمنزل أخوية بجامعة كاليفورنيا، فذبح ستة أشخاص وجرح أربعة عشر آخرين ثم قتل نفسه. وقد برر ما فعله في شريط فيديو، قال فيه إن النساء: «يعطين الإعجاب والجنس والحب لرجال آخرين، ولا يقدمنه لي أبدًا». ثم قال مخاطبًا هؤلاء النساء: «سأعاقبكن جميعًا لأجل هذا.. وسأستمتع بذبحكن جميعًا».
توضح «مين» أن روجر لم يكن يشييء النساء، بل كان غاضبًا لأن حبهن لم يشمله. ما يؤكد ملاحظة ذكية للروائية الكندية مارجريت آتوود: «يخاف الرجال من أن تسخر النساء منهم، وتخاف النساء من أن يقتلهن الرجال».
تدعم «مين» فرضيتها بالإشارة إلى نظرية الفيلسوف البريطاني بيتر فريدريك ستراوسون عن السلوك التفاعلي، ومضمونها هو أننا عندما نتعامل مع الآخرين كبشر لا نستطيع تفادي الشعور بالإعجاب، أو الامتنان، أو الاحتقار، أو اللوم. لكننا لا نشعر بهذا بالطبع تجاه الصخور والحيوانات!
إدراك إنسانية الآخر إذن له مخاطره، فرؤية إنسانية الآخر قد تدفعك لحبه أو معاداته، لأنه بقدراته العقلية المنطقية واستقلاله عنك يستطيع التلاعب بك واستغلالك، أو التآمر ضدك، أو التقليل منك والحكم عليك بشكل سيئ، أو احتقارك واحتقار معتقداتك. ما يعني أن إنسانيته هي الخطر، ولوجودها يمكن معاقبته بقسوة واستمداد سعادة من هذا، سعادة انتقام مشبع ورائع.
لا تتوقف تحليلات «مين» عند تفسير معاداة النساء فقط، بل تواصل تطبيقها على ممارسة القسوة بشكل عام، في محاولة أخرى لإبطال فرضية التشييء كتفسير للقسوة. وفي هذا الصدد، تقول إن تجريد البشر من إنسانيتهم لا يكون دومًا أمرًا سيئًا، بل هو ضروري أحيانًا، كما في حالة الجراحين داخل غرفة العمليات، حيث يتعاملون مع المرضى كأجساد فقط ليتمكنوا من مواصلة عملهم. والأطباء عمومًا، من الأفضل لوظيفتهم التخلي عن جزء كبير من ردود الفعل البشرية الطبيعية كالغضب والاشمئزاز الأخلاقي والرغبة الجنسية أثناء فحص المرضى.
وقد ضربت الفيلسوفة مارثا نوسباوم مثالًا باستخدام بطن الشريك العاطفي كوسادة أثناء النوم وفي اللحظات الحميمة، أو التشييء الحادث أحيانًا خلال ممارسة الجنس برضا الطرفين واستمتاعهما.
بهذا لا يكون التشييء مرادفًا للقسوة أو موجبًا لها، ويمكن أن يحدث خارج نطاقها تمامًا، ما يضعف فرضية التشييء الضعيفة أصلًا، لكن لا بأس من التأكيد بحجة أخرى!
معسكرات الاعتقال، وكابوس دانتي المتحقق على الأرض

اهتمت «مين» بذكر أمثلة فردية لحالات القسوة، لكن أندريا بيتزر تعرض لمثال جماعي، حين يعاقب مجتمعٌ جزءًا كاملًا منه أو جزءًا من مجتمع آخر لجأ إليه، في كتابها: «ليل طويل: تاريخ عالمي لمعسكرات الاعتقال».
تتواجد معسكرات الاعتقال كلما قررت دولة التعامل مع مجموعة من الأفراد خارج الإطار القانوني الحاكم لها، وتدّعي الدول، تقريبًا أنشأت كل الأمم معسكرات اعتقال، أن هذه المعسكرات لغرض حماية المجتمع الأكبر من خطر المجموعة المحددة، أو أنها محاولة لتمدين هذه المجموعة، أو لمنعها من دعم قوات معادية.
وأحيانًا تبدأ هذه المعسكرات كمخيمات إيواء للاجئين من حروب مجاورة، لكنها تسوء مع الوقت، وتتحول لجحيم أرضي في وزن الكوميديا الإلهية لدانتي، كما في حالة مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بلبنان والمجازر المنهجية التي ارتكبت ضدهم، وكذلك البؤس المتفشي في مخيمات اللاجئين السوريين حاليًا. فهي تبدأ كمخيمات وتواصل حمل الاسم، مع تحولها لمعسكرات تجمع أشدّ الظروف وحشية على وجه الأرض.
وهكذا تخدم معسكرات الاعتقال أهدافًا تأديبية في الغالب، تُمارس فيها أشكال متعددة للعنف والقسوة بشكل ممنهج أو عشوائي لكنه لا يقل قسوة. وعلى العموم، من المستحيل النظر إليها كمجرد إخفاق في إدراك الدولة المعتدية لإنسانية ضحاياها. فبالضبط كما قال الباحث يوهانس لانج عن معسكرات الموت النازية: «ما قد يبدو وكأنه تجريد للآخر من إنسانيته هو بالأحرى طريقة لممارسة السلطة على إنسان آخر».
كانت فرضية تجريد المعتدي لضحاياه من إنسانيتهم مغرِقة في الأمل، فهي ترى أن أسوأ أفعالنا ينبع من الالتباس والفشل الإدراكي للآخر، أيْ أنه مجرد خطأ، وتقترح أنه بمقدورنا إنشاء عالم أفضل بمجرد تعطيل تلك الرقائق المزروعة داخل أدمغتنا مثل الجندي في المسلسل التليفزيوني، فنتمكن من رؤية إخوتنا في البشرية كبشر مثلنا يستحقون الرحمة والتعاطف. لكن على ما يبدو، قد تكون الحقيقة أصعب وأقسى: إن أفضل وأسوأ أفعالنا تنبع من اعتبارنا الآخرين بشرًا مثلنا. لكن هذا الإدراك، رغم كل قسوته، هو أول طريقة لفهم كيف يتفاعل البشر مع بعضهم البعض.