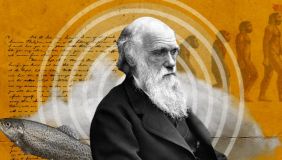ربما كنت وقتها لا أزال طفلًا على أعتاب المراهقة، لا أتذكر، لكني أذكر بوضوح ذلك المحل الصغير في نهاية شارعنا، الهابط أسفل مستوى أرض الشارع بدرجتَي سُلَّم، المختفي مدخله خلف كومة كبيرة من الحصى وبقايا البناء. إلى هناك قادني فضولٌ وقدمان طالما ساقتاني إلى الخير، وهناك لم يكن سوى خير؛ لم يكن سوى «نينتندو».
لكن «نينتندو» (Nintendo) لم يكن أولى محطات الألعاب الإلكترونية في حياتي وحياة جيلي، إذ سبقته وتلته أجهزة كان لها فضل وضع أحجار الأساس لعالم الترفيه بشكله الذي نعرفه اليوم، منها «أتاري» (Atari) وكمبيوتر «صخر» و«سيغا» (Sega) و«بلاي ستيشن» (PlayStation).
«أتاري»: يموت الجهاز ويخلُد اسمه
لعبة (Keystone Kapers)
أسس «أتاري» لعدد من الألعاب، قُدِّر لها أن تعيش في وعي جيلنا وأجيال سبقته وتلته، منها لعبة تنس الطاولة (Pong)، وسلسلة (Q*Bert) المستمرة حتى اليوم عبر منصات ألعاب مختلفة، وكذلك (Pacman) و(Pitfall)، ولعبة سباق السيارات (Pole Position)، وأخيرًا لعبتا الطائرات المقاتلة (River Raid) والعسكري والحرامي (Keystone Kapers)، اللتان لم أقابل شخصًا وُلد في سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي ولم يسمع ويستمتع بهما.
اكتسح «أتاري» بيوت الجميع، ومنح اسمه بعد ذلك لمنصات الألعاب جميعًا عند المصريين بالذات وبعض العرب، فصار كل جهاز ألعاب أتاري ولو لم يكن، بالضبط كما صارت كل المناديل الورقية «كلينكس» وكل السناكس «كاراتيه» في مصر، وكل سيارات البيك أب «وانيت» في الكويت، وكل الحفاظات «بامبرز» عند معظم العرب، ولم ينتهِ ذلك إلا عندما جاء «بلاي ستيشن».
ارتبط «أتاري» في ذاكرة معظمنا بالطفولة الخالية من الأعباء. كان موجودًا في المنزل في مرحلة ما قبل المدرسة، وكان اللعب عليه متاحًا في أي وقت من اليوم، عكس غيره من الأجهزة التي ارتبط السماح بالاستمتاع بها بالانتهاء من الواجبات المنزلية والمذاكرة. كان «أتاري» جهازًا طيبًا، ولا يزال كذلك في ذاكرة معظمنا.
«صخر»: حُلم التقنية العربي الذي سحقته «مايكروسوفت»
إعلان كمبيوتر «صخر» المنزلي
تربَّى كثير منا في منزل به كمبيوتر «صخر». بالنسبة إلى والدي، مجنون الأجهزة الإلكترونية الذي يهوى اقتناء الجديد، كانت أجهزة الترفيه احتياجًا أساسيًّا في البيت، شأنها شأن الثلاجة والموقد وأسرَّة النوم.
على خُطى «صخر» ظهر «الوركاء» العراقي، و«المثالي» السعودي، ثم «الفاتح» في ليبيا.
اقتنى أبي جهاز «صخر»، ذلك المشروع الكويتي الذي انطلق عام 1982 ابتغاء تقريب التكنولوجيا إلى الشرق الأوسط، بتعريب جهاز (AX) من إنتاج «ياماها» (Yamaha) اليابانية، الذي يعمل بنظام تشغيل (MSX) من «مايكروسوفت»، مما يسمح لأفراد الأسرة جميعًا بالتعامل مع جهاز بسيط يتكلم لغتهم، ويوفر أدوات للتقويم الهجري والميلادي والرسم والكتابة وبرامج تعليمية وترفيهية.
كان «صخر» محور الحياة في بيتي وعنده تلتقي أفكار الجميع؛ أبي مدمن التكنولوجيا الفخور، وأمي القلقة من اتجاهي إلى الإدمان أنا الآخر، ثم أنا، الطفل الذي بهرته الألوان والبرامج شديدة البساطة، والألعاب التي كان أبوه يبتاعها كلما سنحت الفرصة.
من بعد هؤلاء أتى أصدقاء الشارع والمدرسة، وصرنا نتحادث معًا عما تنتجه شركتا «العالمية» الكويتية و«كونامي» (Konami) اليابانية، ونتجادل حول من منا سيتجاوز مرحلة معينة في (King's Valley)، أو أدَّى مرورًا مستحيلًا في (Road Fighter)، أو ضحك على بطريق (Antarctic Adventure)، أو وصل إلى مكة أخيرًا عبر الإجابة الصحيحة عن الأسئلة، أو يلتفُّ الجميع حول اثنين يتبادلان اللكمات في (Yie Ar Kung-Fu).
على خُطى «صخر» ظهر «الوركاء» العراقي، و«المثالي» السعودي، ثم «الفاتح» في ليبيا (طبعًا)، لكن قرار «مايكروسوفت» وقف دعم نظام التشغيل (MSX) ضرب جذورًا وليدة لأجهزة أخرى في دول عربية عدة، ربما لم تكُن لتصنع طفرة رقمية عربية، لكنها كانت تصلح كبداية.
«سوبر نينتندو»: ماريو يطارد أحلامي
لعبة «سوبر ماريو»
لا يُذكر «نينتندو» إلا برفقة السبَّاك «ماريو» وأخيه الأصغر «لويجي»، الإيطاليَّين ذوَي الشوارب، اللذين يعيشان في عالم المشروم، ويحاولان بلا كلل العثور على الأميرة «خوخة» (Peach)، بعد أن اختطفها الشرير «باوزر» (Bowser) في قلعته، تحت حراسة جيشه من المخلوقات الشبيهة بالسلاحف.
أعادت «نينتندو» طرح «سوبر ماريو» على أجهزة آيفون، وحققت اللعبة نجاحًا غير متوقَّع.
في مرحلة ما من حياته، قرر والدي أن جهاز الكمبيوتر أفضل من منصات الألعاب؛ إنه مفيد ويحتمل أكثر من مجرد اللهو، ربما هكذا فكَّر، أما أجهزة اللعب فمنتهاها الترفيه، وعلى ذلك ابتاع جهاز كمبيوتر متوسط المستوى ونصَّبه في مكان بارز من شقتنا، وغيرت موجة اللعب في منزلي مسارها، لكني لم أفعل.
الكمبيوتر لطيف، إلا أن «نينتندو» ألطف، كما أنه في غير متناول اليد، لذا يغلفه سحر أكبر. غير ذلك، فإن المحل في نهاية الشارع يؤجِّر الساعة بثمن بخس. صارت التمشية إلى هناك عادتي، وأضحى المكان مستقَرِّي، وانضمَّ «ماريو» إلى عالمي، حتى كنتُ أتجاوز بعض المراحل الصعبة في أثناء النوم.
تعرَّفت كذلك إلى (Final Fantasy) و(The Legend of Zelda)، ولعبة اصطياد البط بالمسدس (Duck Hunt) التي كانت قمة التكنولوجيا وقتها، وأخيرًا ما سمَّيناه «كابتن ماجد» (Captain Tsubasa)، اللعبة ذات القوائم اليابانية، التي عرَّبها مبرمج مجهول تحت اسم «عدنان».
مؤخرًا، وفي مغامرة رآها كثيرون خطيرة، أعادت «نينتندو» طرح «سوبر ماريو» على أجهزة آيفون، لكن السبَّاك الإيطالي حطَّم التوقعات وحقق للشركة أرباحًا بملايين الدولارات.
«سيغا»: «سونيك» حيٌّ إلى الأبد
لعبة «سونيك»
توقف تصنيع «سيغا»، الذي صُمِّم أساسًا لينافس «نينتندو»، عام 2001، لكن الشركة لا تزال تعيد إنتاج دُررها القديمة بنجاح. عاد القنفذ «سونيك» إلى هواياته، يقفز عاليًا ويجري رشيقًا ويجمع حلقات الذهب، بطريقة 3D وغرافيك محسَّنة للغاية، لكن على منصات «بلاي ستيشن» و«آندرويد» والكمبيوتر.
«سونيك» لم يكن مجرد بطل إحدى لعبات المراهقة، بل جذبني منذ الوهلة الأولى بلون أزرق وسرعة خاطفة وقفزات تخترق السماوات، لكنه لم يكن الوحيد الذي جذبني. عبر «سيغا»، انطلقت ألعاب مثل سباق الدراجات النارية العنيف (Road Rash) و(My Hero)، وأيضًا (Rambo).
«بلاي ستيشن»: ومن لم يلعب «اليابانية»؟
مباراة بين منتخبي نجوم العالم ونجوم أوروبا في (Winning Eleven 3)
لن ينسى مَن مارَسَ (Winning Eleven 3) شفرة استدعاء فريقَي نجوم العالم وأوروبا.
ربما لم تنجح منصة ألعاب في التاريخ كما فعل «بلاي ستيشن»؛ كان حياةً لا مجرد لعبة، عالمًا زاهيًا غيَّر عيشتنا أحادية اللون، نافذةً في ركن قصيٍّ من الدنيا لم نلحظ وجودها هناك من قبل.
نجح «بلاي ستيشن» في أن يبتلعني وسواي لساعات طوال، ننسى فيها منازلنا ودراستنا وحياتنا، ونصير (Pepsiman) الراكض أبدًا، نتفادى السيارات وعلب القمامة وشغب الشوارع الخلفية للمدينة لنتجاوز مرحلة إلى التي تليها، أو نسابق الآخرين في (Crash) بأجزائها، كما كانت (Tekken) من العلامات المهمة في تاريخي وأقراني.
لكن درة التاج دون منازع هي (Winning Eleven 3)، التي اتفق العرب جميعًا على إطلاق اسم «اليابانية» عليها بلا خلاف، لأن مصمميها في شركة «كونامي» جعلوا أسماء كل لاعبيها وقوائمها باللغة اليابانية، حتى صرنا نعرف أشكال بعض حروفها، ووضعوا صورة لفريق اليابان على غلاف اللعبة.
لن ينسى مَن مارَسَ (Winning Eleven 3) أبدًا شفرة استدعاء فريقَي نجوم العالم ونجوم أوروبا، ولا تزال اللعبة تحقق نجاحًا في عدة دول، ويمارسها كثير من محبي الألعاب الإلكترونية.
في الوقت الحالي، قفزت الألعاب الإلكترونية قفزات لا يمكن وصفها بالنسبة إلى من عاصَر «أتاري» و«صخر». تعددت المنصات وازداد التنافس، تحسنت الغرافيكس حتى صارت تضاهي الحقيقة في دقتها، اختفت أسلاك أذرع اللعب، ثم تغير شكل الذراع المعتاد وفقد أزراره، وبعدها ضاق العالم الحقيقي على اللاعبين فانتقلوا إلى براح العوالم الافتراضية، وبعض الشركات يحاول الآن إعادتهم إلى أرض الواقع.
أما بالنسبة إلى جيلي، فلا شيء يمكن أن يمنحنا شعورًا بالحنين إلى سعادة الماضي البِكر أكثر من مقطع الفيديو هذا ذي الخمس عشرة ثانية.
فيديو البدء في جهاز «بلاي ستيشن 1»