معظم الأمهات مررن بحالة الضيق تلك التي تأتي عقب سيل من الأسئلة يطرحها طفلها الذي لم يتجاوز عامه الرابع: أمي، ما هذا؟ من أين أتيتِ به؟ بكم اشتريتِه؟ هل يَفسَد إذا استخدمناه هكذا؟ هل لي أن أجرب؟
لا تجد الأم مفرًا من الصمت إنقاذًا لما تبقى من طاقتها، فما سر كل هذا الفضول لدى الأطفال؟ وهل هو حقًّا فِطرة طبيعية في الإنسان؟
لو قلتُ لك إنك لن تجد في السطور القادمة أي شيء عن كيفية تحقيق أحلامك، ولا عن طريقة إعداد طعام يقضي على جوعك، وللأسف لن أخبرك عن طريقة تنقذ مستقبلك المهني، أو حتى تجعلك أكثر جاذبيةً للجنس الآخر، بل إن كل ما أعدك به هو أن أقدم لك فكرة قيِّمة عن الطفل الذي بداخلك، أظنك ستتابع القراء فقط بدافع من الفضول، أليس كذلك؟
هذا هو الموضوع الذي تناوله تقرير موقع هيئة الإذاعة البريطانية «BBC».
الإنسان طفل فضولي
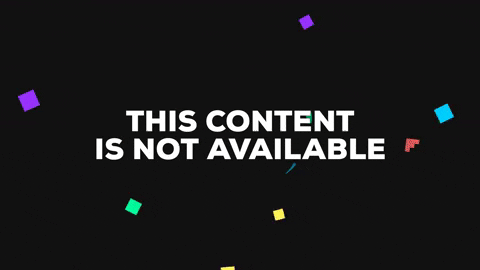
نحن البشر لدينا طبيعة الفضول مترسخة في أعماق شخصياتنا، تدفعنا إلى الإصرار على فعل أشياء ليس لها هدف أو معنى واضح، مثل متابعة أخبار شخصيات نعرف أننا لن نقابلهم طيلة حياتنا. نقرأ ونتعلم أشياء عن موضوعات لن نستخدمها ولن تؤثر في حياتنا، ونحاول معرفة المزيد عن أماكن سنحيا ونموت دون زيارتها، فنحن نحب معرفة إجابات أسئلة تدور في رؤوسنا حتى إن لم نعرف لها فائدة.
امتداد فترة الطفولة لدى البالغين ليس شيئًا سيئًا، فهو يعني أن البشر يمكنهم استيعاب مزيد من المعلومات عن بيئتهم، وتطوير التفكير وطرق العيش.
يرى علماء الأحياء أن صفة الفضول ظهرت لدى الإنسان مع صفات أخرى جاءت نتيجة التطور الطبيعي، ويربطها بعضهم بصفة بشرية تُدعى «استدامة المرحلة اليَرَقِية» (neoteny)، وهو مصطلح في علم التطور يعني احتفاظ البالغين بالصفات الموجودة لدى الأطفال حين يتباطأ التطور الفسيولوجي لدى الحيوانات، ومنهم البشر، ويدل وجود تلك الصفة لدينا على أننا أقرب إلى الأطفال بدرجة تزيد على غيرنا من الثدييات.
استدل العلماء على وجود صفة استدامة المرحلة اليرقية لدى البشر بعدة دلائل جسدية وسلوكية، منها أن أجسادنا تكاد تخلو من الشعر الكثيف بعكس معظم أنواع الثدييات، وكذلك كِبَر حجم أدمغتنا مقارنةً بالأنواع الأخرى، وأخيرًا الميل نحو اللعب والاستكشاف الموجود لدى أطفال الثدييات في الأساس.
تمثل صفة استدامة مرحلة اليرقية أحد مسارات عملية التطور الطبيعي، التي تحتوي على حزمة من التغييرات في آنٍ واحد، إذ أسفر تطور تلك الصفة لدينا عن جعلنا أحد أكثر الثدييات ضعفًا من الناحية الجسدية، بما أننا نقترب من صفات أطفالنا، لكنها في الوقت ذاته منحتنا قوة بشكل آخر، ففضول الأطفال له دور أساسي في قدرتنا وإقبالنا على التعلم والابتكار، وكذلك توطيد الروابط الاجتماعية بين بعضنا بعضًا.
امتداد فترة الطفولة لدى البالغين ليس بالأمر السيئ، فهو يعني أن البشر يمكنهم استيعاب مزيد من المعلومات عن بيئتهم، وتوارث الثقافات، بل إنه بفضل هذه الصفة نتمكن من تطوير تفكيرنا وطُرُقًا جديدة للعيش، وبالتالي التكيف مع الظروف والمستجدات من حولنا.
الفضول: وقود العقول
ربما ترى أنه من الأفضل لو نعرف ما يفيدنا فقط لنتعلمه، لكن عالمنا أكثر تعقيدًا من أن نتمكن من ذلك، فلا نعرف ماذا سيكون مفيدًا في المستقبل.
اكتشف علماء الذكاء الصناعي الأهمية الكبرى للفضول عند البشر، وكيف أن سلوك الاستكشاف يتطور فقط عندما يكون هناك محفز له، فعندما استخدموا أفضل خوارزميات التعلم، وجدوا أنها تتعطل دون تزويدها بما أطلقوا عليه «محفزات الاستكشاف»، التي تقابلها صفة الفضول في العقل البشري. بدون تلك المحفزات، راحت الخوارزميات تكرر نفس العملية دون الإتيان بنتائج جديدة.
ورغم أن محفزات الاستكشاف لم تظهر فوائدها فورًا، فإنها أفادت خوارزميات التعلم على المدى الطويل، إذ أضافت إليها المعرفة اللازمة للتطور.
ربما تكون الفكرة اتضحت لدينا بهذه الطريقة، فما أطلق عليه علماء الذكاء الصناعي محفزات الاستكشاف يُعرف لدينا باسم «الفضول»، تلك الصفة التي تضعنا على الطريق الصحيح، للتخلي عن تكرار نفس التجارب ونفس الطرق، ونذهب بعيدًا عن تركيزنا في ما أمامنا فقط.
قد يبدو لنا هذا إهدارًا للوقت، لكن خوارزمية التعلم الطبيعية في أدمغتنا تعرف بفطرتها أن ما نتعلمه الآن، حتى وإن بدا عديم الفائدة في اللحظة الحالية، سيفيدنا غدًا.
قد ترى أنه كان من الأفضل لو نعرف ما سيفيدنا فقط لنتعلمه، أو نستكشفه دون غيره، لكن لحسن الحظ، عالمنا أكثر تعقيدًا من أن نتمكن من ذلك، فلا نعرف ماذا سيكون مفيدًا في المستقبل. ولو كان هناك سبيل لمعرفة ذلك، سنضيِّع على أنفسنا عفوية التخبط وسط أشياء نحاول استكشاف أكبر قدر منها، لن نجرب أشياء كي نرى ما سيحدث عند تجربتها، ولصارت الحقيقة مأساة، بسبب طبيعة دورنا على هذا الكوكب التي تقتضي الإعمار والتطور الدائم.
شئنا أم أبينا، قانون التطور الطبيعي هو أحدث آلة تعلُّم عرفها التاريخ، وهي كغيرها من الآلات تحتاج إلى وقود، ولن نجد أفضل من الفضول ليحركها، ليضمن لنا استمرار تلك الضوضاء الصحية داخل أروقة أدمغتنا، التي تدفعنا نحو التطور والابتكار، بل وصيانة أنفسنا والحفاظ عليها.





