على غلاف «أولاد حارتنا: سيرة الرواية المحرمة»، يطل نجيب محفوظ بتكوين يتصدر المشهد، خلفه الحارة تطل منها سيدة من شباك صغير هامشي أعلى الصورة. يختار الفنان أحمد اللباد، مصمم الغلاف، نجيب بوجه أربعيني، منتصب القامة، تام الهيئة والنضج، لا شيخًا ولا شابًّا، مبتسمًا، مطمئنًا، كأنه يطل من فردوسه متقدمًا «حارته» الضيقة، المأزومة، بعد أن انتهى من مهمته، بقص حكاياتها، منتصرًا بأصالة موهبته ونبلها ضد أنصاف الأشياء.
في كتابة يمتزج فيها جهد الاستقصاء الصحفي بجاذبية أساليب السرد الروائية والتسجيلية، يوثق محمد شعير ما تعرضت له رواية «أولاد حارتنا»، منذ الأيام الأولى لنشرها مسلسلة في جريدة الأهرام، ثم ما تلاها من حرائق، حتى تحولت الرواية إلى لعنة طاردت نجيب محفوظ حتى باب قبره. وما زالت أصداء التحريم تحوم بسمومها، كلما جاءت سيرة صاحبها.
ربما لهذا يهدي شعير كتابه إلى طه حسين ونصر حامد أبو زيد، في إشارة إلى أن أزمة المفكر والفنان مع الحراس قديمة ومتجذرة ومستمرة. فقد تعرَّض صاحب «في الشعر الجاهلي» الذي عاصره نجيب كتلميذ ومريد إلى أزمة مماثلة. ولم تمر ثلاثة عقود على عاصفة «أولاد حارتنا» في ستينيات القرن العشرين، حتى واجه نصر أبو زيد اتهامات بالتكفير انتهت بلجوئه إلى منفى اختياري في أمستردام، في الوقت الذي تعرَّض فيه نجيب محفوظ، الشيخ وقتها، إلى محاولة اغتيال.
نحن أمام وثيقة حية لستينيات القرن العشرين، سياسيًّا وتاريخيًّا، بل ومرآة لواقعنا الراهن عبر اتخاد الرواية مركزًا للسرد، لا يقدم فيها شعير أحكامًا، وإنما يستعرض الوقائع دون تدخُّل، مستعيرًا في ذلك حيادية محفوظ وحيله الروائية التي «حمَّلت شخصياته عبء أفكارها، مكتفيًا بدوره كشاهد حكيم غير متورط»، و بحس درامي تتصاعد فيه الأحداث، فلا تفلت القارئ حتى ينتهي من آخر صفحات الكتاب.
أنبياء أم فتوات

السياسيون المقصودون في «أولاد حارتنا» فهموا وعرفوا مَن المعنِي بالفتوات، لذا ربما كانوا وراء تحويل الأمر إلى الناحية الدينية.
خارج التأويلات الدينية للرواية، يقدم نجيب محفوظ نفسه صيغة أكثر تحديدًا وبساطة، يوردها شعير على لسانه، عن حارة يتسلط على مصيرها فتوات، ونُظَّار فسدة، فيما يحمل أولاد حارتنا النادرون شعلة المقاومة والعدل والحرية والإيمان بالعلم، استخدام القوة لصالح المستضعفين. كان يخبر مجلس قيادة الثورة، أمامكم طريقان لا غير: أن تصيروا أنبياء أو فتوات.
لكن الاختيار كان واضحًا: صاروا فتوات
روايته التالية: «اللص والكلاب»، إعادة سرد لسيرة واحد من أولاد تلك الحارة، لكن تلك المرة ليس نبيًّا أو بطلًا، بل يحمل كل مقومات البطل الضد: حرفوش ولص ومجرم يحاول الحصول على العدل بنبوته في مواجهة الفتوات.
لهذا لم يصر محفوظ طيلة حياته على إعادة نشر «أولاد حارتنا» بالقاهرة، مختبرًا أسئلتها كلها بشكل أكثر تفصيلًا ومهارة في ما تلت من أعمال: «اللص والكلاب» و«قلب الليل» و«الشحاذ» و«الطريق»، ويصل سؤال العدل إلى ذروته في «الحرافيش». مجربًا أسئلته عن ما وراء الواقع: عن «الجبلاوي»، عن السقوط الإنساني والسعي للتحقق والحرية حتى لو كان المصير هو الفشل، منتصرًا بفكرته على كل أشكال الرقابة، بل وموسعًا من نطاقها وجرأتها.
يقول نجيب: «أولاد حارتنا» عمل سياسي، المقصودون به فهموا معناه، وعرفوا من المعنِي بالفتوات، لذا أرجح أنهم كانوا وراء تحويل الأمر إلى الناحية الدينية، لكي أقع في شر أعمالي.
الطريف في الأمر أن نجيب في حياة جمال عبد الناصر تحمَّل ضراوة التأويل الديني، ورأى أنه أقل خطرًا من تفسيرها السياسي، حتى مات الرئيس، فتحدث لأول مرة عن أن الغرض كان انتقاد السلطة وليس الدين.
ما الأدب؟
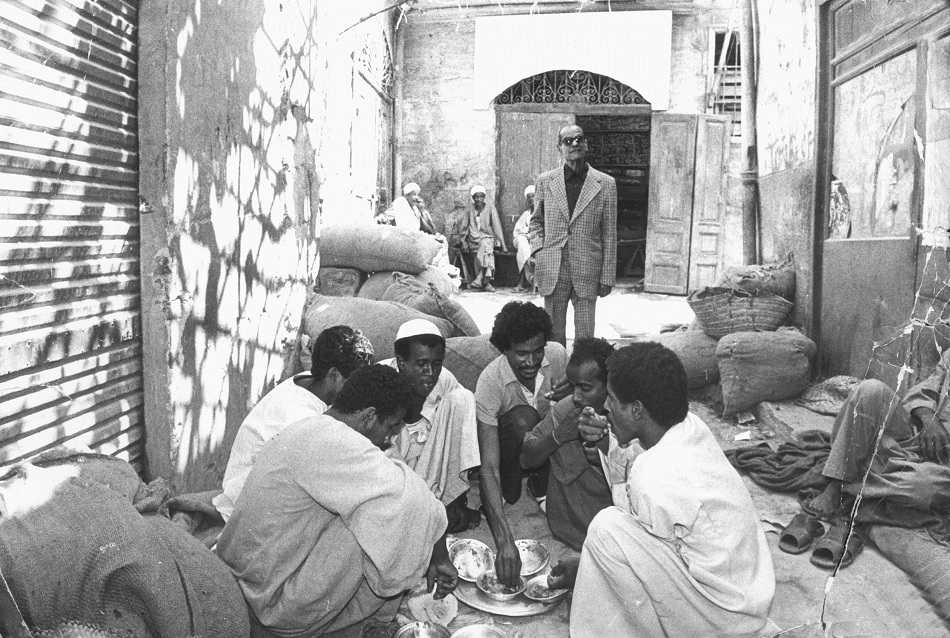
منذ المشاهد الأولى في الكتاب، وقبل نشر رواية «أولاد حارتنا» يرسم شعير جوًّا عامًّا مترصدًا بالأدب، ليس فقط من الجناح الديني، بل من جميع الأطياف، كلها تتصارع على حماية صورة غائمة من تصورها عن نفسها. ممارسة تسري في شرايين كل عقل، تجري معه محاولات الإبداع أو التفكير في «الحارة المأزومة» كعبء أو مراوغة أو جريمة.
بدأت الشرارة من مواطن «صالح»، يرى أن «أولاد حارتنا» ليست هي الأدب. فوفقًا للمواطن، ليس دور الأدب «تحدي معتقدات راسخة في مجتمع يُجِل الدين بطبيعته».
قبل نشر الرواية، كان الوسط الأدبي مشغولًا بتصريح وزير الثقافة والإرشاد القومي، صلاح البيطارعن أن «أدبنا لا يعبر تعبيرًا كافيًا عن آمال العرب القومية»، وهو ما اتفق معه عدد من الأدباء، كالشاعر أحمد عبد المعطي حجازي، أن الأدب عليه أن يعبر عن توجهات الدولة القومية، وهو ما رفضه نجيب محفوظ بدبلوماسيته المعهودة.
كان الصراع على أشده من أجل «تربية المواطن» و«هندسة المجتمع»، وأن تُدمَج فروع الأدب والفن، بل والمؤسسات الدينية، في «التعبئة القومية»، ما جعل «أولاد حارتنا» كنزًا للصراع بين القوى السياسية والدينية، بين اليسار واليمين المحافظ.
يكشف الكتاب محاولات المجتمع «العلماني» نفسه لتدجين محفوظ، أو جره إلى النسخة الغائمة من «نحن»، فمرة يُتهم عقب إنجازه للثلاثية بأنه كاتب برجوازي، وتارة يطالبه أدباء ونقاد وسياسيون بأن يُسخِّر فنه لصالح «حدود الأفكار التي رسمتها لنا الدولة»، وتعبيرًا عن نضالها. تتجاهل الدولة نفسها ترشيحه لجائزة نوبل مرات، وتقدم عليه أسماء أضعف مثل عبد الرحمن الشرقاوي. غالبية العرائض الموقعة لمنع نشر «أولاد حارتنا» كانت من الأدباء.
يواجه نجيب منذ عمله الأول نفور الشيوخ من اسم روايته «عبث الأقدار»، وترفض الرقابة روايته الثانية «رادوبيس» لأن الشعب يثور على الملك، ويُحال إلى التحقيق بعد صدور روايته «القاهرة الجديدة»، لأنه انتقد الحكومة، بل يضطر إلى الدفاع عن الرواية بنفس الإجابة التي قد يقولها كاتب مصري معاصر، عن ضرورة التفرقة بين الواقع والشخوص الخيالية في عمل فني.
يرفض مجمع اللغة العربية إعطاءه جائزة «السراب» لأسباب أخلاقية، يهدده شبح الاعتقال عقابًا على روايتيه «ميرامار» و«ثرثرة فوق النيل». يبتر الرقيب صفحات من «الحب تحت المطر» و«الكرنك»، يرفض الأزهر إجازة رواية أولاد حارتنا، ويصدر بيان الإخوان المسلمين يوم جنازته مدعيًا «تبرؤ نجيب من الرواية».
تختلف أسباب الفئات المتصارعة لمعاملة الرواية كخطيئة، لكن تشترك كلها في شيء واحد: محاولة سجن الأدب في واحد من تعريفاته الضيقة. كان صراخ الجميع: ليس هذا هو الأدب.
ربما نجا نجيب، لكن هل ينجو الأدب؟

إذًا، هي سيرة مطاردة عاشها الأديب الأهم في الوطن العربي، كانت ذورتها مع محاولة اغتياله. لذلك ليس غريبًا أن يفرد شعير فصلًا كاملًا لرواية «اللص والكلاب» التي جاءت تالية لعاصفة «أولاد حارتنا». في حوار له مع «باريس ريفيو»، يقول نجيب: أنا سعيد مهران.
سعيد هو النسخة التي استلهمها نجيب من قصة السفاح محمود أمين سليمان، مبتعدًا بها عن أصلها الواقعي، بعد أن وجد فيه ضالته ليعبر عن «الإحساس الضاغط والمستمر بأنه مطارد» محمِّلا إياها حيرته وهواجسه.
لم يسلم محفوظ من المطاردة حتى بعد أن جاءته جائزة نوبل كإقرار عالمي، فقد فوجئ بعد إعلان الخبر بزيارة مسؤول من «منظمة التحرير الفلسطينية»، ومعه حقيبة سوداء بها ثلاثة أضعاف قيمة نوبل، طالبًا منه الاعتذار عن الجائزة. يرفض نجيب الذي لم يَسلم من اتهامات بأنه نال الجائزة، لا لإبداعه، بل لموقفه من «معاهدة كامب ديفيد».
تصل الرواية إلى المحكمة. ويفتي عمر عبد الرحمن بعد فوزه بالجائزة، وعقب فتوى «الخميني» بإهدار دم سلمان رشدي"، بأن لو الحكم بالقتل قد نُفِّذ في نجيب محفوظ حين كتب «أولاد حارتنا، لكان ذلك بمثابة درس بليغ لسلمان رشدي»، وهي الإشارة التي تلقفها محمد ناجي الذي نفذ محاولة اغتيال نجيب محفوظ، والذي لم يقرأ الرواية، لكن كانت فتوى مشايخه كافية.
بعد عام من الحادث، تستبعد وزارة التعليم روايته «كفاح طيبة» من مقررات التدريس، لتضع بدلًا منها عملًا محافظًا: «الصقر الجريء» لعبد السلام زيدان. ثم يكافح ضد محاولات نشر «أولاد حارتنا» ضد رغبته، عندما قررت الدولة إعادة استغلال الرواية في حربها ضد الإرهاب. فحاولت «دار الهلال» و«جريدة المساء» نشرها متجاهلة حقوقه الأدبية والمادية.
بعد انتهاء جنازته، تُصدِر جماعة «أنصار الشورى والسلام» بيانًا ترفض فيه الصلاة على جثمانه، وتلوم من دعوا له بالمغفرة والرحمة. أما الجنازة نفسها، فتحولت إلى لعبة جديدة، إذ حُمِل نعشه فارغًا إلى مسجد الحسين، في جنازته الشعبية. أما جثمانه، فنُقل إلى مسجد «آل رشدان»، حيث ينتظر الرئيس مبارك الذي لم يتحمل أكثر من ثلاث دقائق، أمام الكاميرات.
هل نجا نجيب في النهاية من المطاردة؟ ربما، لكن هل نجا فعل الفن الذاته، هل استوعبه المجتمع كفعل أصيل وحر، لا كشيء هامشي معرض للتهديد والمطاردة؟ كل الأسئلة التي طرحها المجتمع على نفسه بخصوص أي أزمة في أي مجال أو عقيدة أو سلوك أو قضية، لم تُطرح إلا بمنطق المذعور من مغادرة حصنه الآمن. لذلك لا إجابات، فقط مسخ غاضب يدور حول نفسه، ملتهمًا كل من يشير إلى جوهر الأزمة: من يحرس العمى؟




